 رد: شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام --- متجدد فى رمضان
رد: شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام --- متجدد فى رمضان
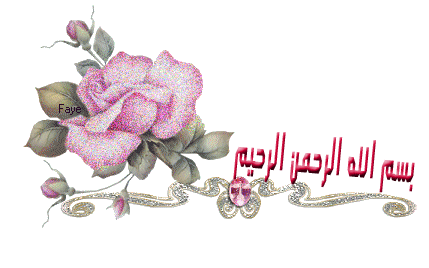
شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية
من صــ 616الى صــ 625
(38)
المجلد الثانى
كتاب الصيام
(8)

وأما قوله: «ولا تعودا»؛ فهي رواية مرسلة, ثم معناها - والله أعلم - لا تعودا إلى فطر تريدان قضاؤه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاء, وهذا لما رأى حزنهما على ما فوتاه من الصوم؛ قال: فلا تفعلاه شيئاً تحزنا عليه.
وثالثهما: أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحيس: أنه قال: «إني آكل وأصوم يوماً مكانه» , ولولا أن الخروج جائز والقضاء مستحب؛ لما أفطر.
ورابعهما: أن في حديث المدعو إلى طعام أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر وصم يوماً مكانه». وفي رواية: «إن أحببت» , ولو كان القضاء واجباً؛ لما قيل هذا.
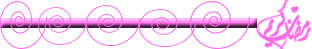
وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أمرا بالقضاء, وصح عنهما جواز الإِفطار لغير عذر, فعلم أن ذلك أمر استحباب.
697 - فروى يوسف بن ماهك؛ قال: «وطئ ابن عباس جارية له وهو صائم, فقال: إنما هو تطوع وهي جارية اشتهيتها».
698 - وفي رواية عن سعيد بن جبير؛ قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار فوجدناه صائماً, ثم دخلنا فوجدناه مفطراً, فقلنا: ألم تك صائماً؟ قال: بلى, ولكن جارية لي أتت عليَّ, فأعجبتني, فأصبتها, وإنما هو تطوع, وسأقضي يوماً مكانه, وسأزيدكم: إنها كانت بغيّاً فحصنتها, وإنه قد عزل عنها». قال سعيد بن جبير: «فعلمنا أربعة أشياء في حديث واحد». رواهما سعيد.
وأما حديث شداد بن أوس إن صح؛ فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذلك فيمن يعتاد أبداً الصوم ثم تركه لشهوته؛ فإن هذا مكروه.
ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة مدرجاً في الحديث.
يدل على ذلك ثلاثة أشياء.
أحدها: أن الشهوة الخفية قد فسرها أبو داوود وغيره بأنها حب الرئاسة, ولو كان تفسيرها مرفوعا؛ لما أقدموا على ذلك.
الثاني: أن تفسيرها بحب الرئاسة أشبه؛ لأن حب الرئاسة يكون في الإِنسان, ويظهر الأعمال الصالحة ولا نعلم أن مقصوده درك الرئاسة.
الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة؛ فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة؛ لم يكن لها شهوة ظاهرة.
الرابع: أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هو من جنسه, والذي هو من جنسه هو حب الشرف لا أكل الطعام. والله تعالى أعلم.
* فصل:
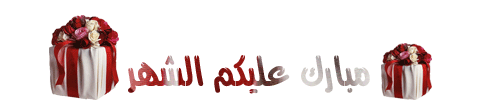
في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]
قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر. . . .
وقال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال:
699 - يروى عن الحسن: أنه يفطر, وله أجر البر وأجر الصوم إذا افطر.
وقال في رواية عبد الله: إذا نهاه أبوه عن الصوم؛ ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه, ولا أحب لأبيه أن ينهاه؛ يعني: في التطوع.
وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره [أبواه]؛ لا يصلي إلا المكتوبة. قال: يداريهما ويصلي.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟
700 - قال: قد روى ابن المنكدر؛ قال: «إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة؛ فأجبها, وإذا دعاك أبوك؛ فلا تجبه».
وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوع؛ فليجبها».
* فصل:
ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه, ولم يكن له الخروج منه؛ إلا عن عذر؛ بخلاف المتلبس بالصوم في السفر؛ فإن العذر المبيح للفطر قائم. . . .
مسألة:
وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما.
فيه مسألتان:
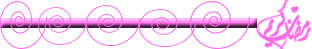
أحدهما: أن سائر التطوعات من الصلاة والطواف والاعتكاف والهدي والأضحية والصدقة والعتق: إذا شرع فيه؛ [فالأولى] أن يتمه, وإن قطعه؛جاز ولا قضاء عليه, وإن قضاه بعد قطعه؛ فهو أحسن.
هذا الذي عليه أصحابنا, وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر إذا دعته أمه وهو في الصلاة إن كان في التطوع؛ فليجبها.
وقال أحمد في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يصبح صائماً متطوعاً: أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة: أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد لا يقطعها, فإن قطعها وقضاها؛ فليس فيه اختلاف.
قال القاضي: ظاهر هذا أنه لم يوجب القضاء, وإنما استحبه؛ لأنه يخرج من الخلاف.
وقال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرق بين الصلاة والصيام, وأن الصلاة تلزم بالشروع.
وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق والجوزجاني.
لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال, فلزمت بالشروع كالحج.
701 - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم».
وهذا يعم جميع الصلوات, ويقتضي أنه ليس له أن يتحلل منها إلا بالتسليم؛ كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطهور, ولا أن تحرم بها إلا بالتكبير.
ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحد أبويه بالفطر في صومه التطوع؛ أجابه, ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوع؛ أجاب الأم ولم يجب الأب. . . .
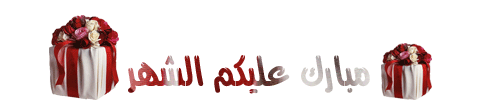
المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة؛ لزمه المضي فيها, ولا يجوز له أن يقصد الخروج منها, ولو نوى الخروج منها ورفضها؛ لم يخرج بذلك.
[ولو أفسدها؛ لزمه المضي فيها, وإتمام ما أفسده, وعليه قضاؤها من العام المقبل إن كانت] حجة, وعل الفور إن كانت. . . , حتى لو دخل فيها يعتقدها واجبة عليه بنذر أو قضاء ونحو ذلك, ثم تبين أنها ليست عليه؛ لزمه المضي فيها, ومتى أفسدها؛ كان عليه القضاء. . . .
والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
702 - وفي حرف عبد الله: «إلى البيت».
وقد أجمع أهل التفسير إلى أنها نزلت عام الحديبية, لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة, وساقوا الهدي, فصده المشركون, فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة, ويذكر شأن الإِحصار.
وهذا أمر بالإِتمام لمن دخل متطوعاً؛ لأن الحج لم يكن قد فرض بعد؛ فإن الآية نزلت سنة ست, والحج إنما فرض بعد فتح مكة.
ثم إن الله تعالى أمر بالإِتمام مطلقاً, فدخل فيه كل منشئ للحج والعمرة, بخلاف الآية التي فيها إتمام الصيام؛ فإنها تفارق هذه من وجهين:
أحدهما: أنه قال في أولها: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. . .} , واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدم ذكره, وهو صيام رمضان, ثم قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} , فعاد الكلام إلى الصيام المتقدم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظوراً بعد النوم, ثم أبيح, وهذا صفة صيام الواجب.
نعم؛ سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإِلحاق.
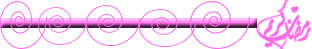
الثاني: أن قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}: أمر بأن يكون إتمام الصيام إلى الليل, وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإِمساك إلى الليل, فتفيد الآية أن من أفطر قبل الليل؛ لم يتم الصيام, وهذا حكم شامل [يجمع] أنواع الصوم, ثم ما كان واجباً كان الإِتمام فيه إلى الليل واجباً, وما كان مستحبّاً كان مستحبّاً, وما كان مكروهاً كان مكروهاً, وما كان محرماً كان محرماً؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] , وهو أمر بأن يكون حكمه بما أنزل اتلله لا أمر بنفس الحكم؛ بخلاف آية الحج والعمرة؛ فإنه أمر بإتمامهما, فيكون نفس الإِتمام مأموراً به, وهنا الإِتمام إلى الليل هو المأمور به, وفرق بأن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في الفعل؛ فإنه لو قال: [صل] بوضوء, أو: صلِّ مستقبل القبلة, ونحو ذلك؛ كان أمراً بفعل هذا الشرط في الصلاة لا أمراً بنفس الصلاة.
والفرق بين الحج والعمرة من وجوه:أحدها: أن الحج والعمرة يمضي في فاسدها ولا يخرج منهما بالإِفساد ولا بقطع النية, وغيرهما ليس كذلك.
فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها.
قيل: الصوم المتعيِّن مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فاسده, وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحاً, فلم يكن حاجة إلى المضي في فاسده.
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقداً. . .
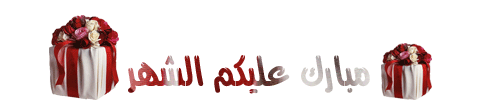
مسألة:
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى.
703 - وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر». متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين».
وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
704 - وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه.
705 - 706 - وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم.
707 - وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب؛ فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام هذين العيدين».
وفي رواية: «اليومين الفطر والأضحى: أما أحدهما؛ فيوم فطركم من صيامكم, وأما الآخر؛ فيوم تأكلون فيه من نسككم». رواه الجماعة.
708 - وعنه أيضاُ؛ قال: شهدت عليّاً وعثمان رضي الله عنهما في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي.
ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفارة ولا قضاء ولا نذر في الذمة.
فإن نذر صوم يوم أحد العيدين قصداً؛ انعقد نذره موجباً لكفارة يمين في إحدى الروايات. نص عليه في رواية حنبل بناء على أنه نذر معصية, وموجب نذر المعصية كفارة يمين.
وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نص عليه في رواية أبي طالب, وهو. . .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|