|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
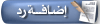 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#21
|
||||
|
||||
|
(18) تتمة الحديث عن محاولة عبد القاهر الجرجاني بيان أوجه بلاغة القرآن قال أبو فهر محمود بن محمد شاكر الحسيني (ت: 1418هـ): (18)لما نشر الأستاذ (عبد الله محمد الصديق الغماري) كتاب (بيان إعجاز القرآن) للإمام أبي سليمان الخطابي، وذلك في سنة (1372 من الهجرة 1953م) كان أمرًا غريبًا جدًا عندي تنبه هذا الإمام الجليل (لتعذر معرفة وجه إعجاز القرآن، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته). [انظر ما سلف ص: 92: 93] وهذه كلمة لا يقولها، بهذا الوضوح، إلا عالم متمكن قد فحص أقوال من سبق فحصًا دقيقًا، فلم يجد في شيء منها مقنعًا ولا رضى. ولكن كان أغرب منه عندي أنه حين ذكر إسنادهم وجه الإعجاز إلى (البلاغة)، = وهو الوجه الذي اعتمد عليه أكثر علماء أهل النظر في زمانه وبعد زمانه إلى اليوم = صرح تصريحًا لا غموض فيه بحيرته في مفهوم لفظ (البلاغة) فقال: (وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال، ويصعب عليهم منه الانفصال)، فدل بهذا أيضًا على أن أمر (البلاغة) عنده، قد نال قسطًا وافرًا من التأمل، فلم ينته فيه إلى رأي يجلب الطمأنينة إليه، بل وجده أمرًا مشكلا يصعب إزالة إشكاله. ثم زاد الأمر بيانًا، ودلنا على أنه كان يسائل أصحاب هذا القول في (البلاغة) فقال هذه المقالة الصريحة الواضحة الغريبة: [مداخل إعجاز القرآن: 97] (ووجدت عامة أهل هذه المقالة (أي القائلين بإعجاز القرآن من جهة البلاغة)، قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد، وضرب من غلبة الظن، دون التحقيق له وإحاطة العلم به. ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن الكريم، الفائقة وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا: إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربًا من المعرفة لا يمكن تحديده، وأحالوا على سائر أجناب الكلام التي يقع فيها التفاضل، فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه). [انظر ما سلف 83] فبين بهذه الكلمات عن أن مفهوم (البلاغة) لعهده كان غامضًا كل الغموض، مبهمًا كل الإبهام، وأن سحر لفظ (البلاغة) بهذا الإبهام، كان يطغى عليهم طغيانًا مستفيضًا، وسبب ذلك كما قلت آنفًا [ص: 81]، وهو (حضور التذوق في الأنفس حضورًا واحدًا حيًا في تذوق نظم القرآن وتأليفه، وفي تذوق نظم الشعر = وكان لهذا الإبهام سحر يربط هذا التذوق، بلفظ له في نفسه دلالة مغرية، توهم المرء بأن معناه بين، والحقيقة أن معناه ليس بين ولا محدود. وإذن فالأمر كله مردود إلى (التذوق) [مداخل إعجاز القرآن: 98] لا غير، وقد كشف الخطابي هذا المعنى كشفًا كاملاً في تمام كلامه حيث قال: (قالوا: وقد يخفى سببه عند البحث، ويظهر أثره في النفس، حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. قالوا: وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع، وهشاشة في النفس، لا يوجد مثلها لغيره منه، والكلامان معًا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة. قال أبو سليمان الخطابي، قلت: وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم، ولا يشفى من داء الجهل، وإنما هو إشكال أحيل إلى إبهام). وهذا واضح جدًا، ودال على أن الأمر كله مفوض إلى (التذوق) لا غير، وأن نسبة الأمر في الإعجاز إلى (البلاغة) إشكال أحيل إلى إبهام. ومعنى ذلك أن كل ما كان يقال على عهده في شأن الإعجاز، وأن مرده إلى (البلاغة) المبهمة الغامضة = شيء لا يستقيم، وهو غير مقنع، وأنه لا يستطيع هو ولا غيره من أهل زمانه أن يطمئن إلى هذا الوجه من الإعجاز اطمئنانًا يعين على الاقتناع، ويشفي من داء الجهل، بالوجه الذي كان به القرآن العظيم (معجزًا) على مذهب المتكلمين الذين وضعوا لفظ (الإعجاز) ولفظ (المعجز) و(المعجزة) في نطاق لفظ (التحدي)، وما زعموه من أن المشركين من العرب قد (عجزوا) عن مثل القرآن العظيم. [انظر ما سلف من القول في >الإعجاز<، و>التحدي<]. [مداخل إعجاز القرآن: 99] وإذا كنت أنا بعد عشرة قرون (توفى الخطابي سنة 388هـ). قد وقفت عند كلام أبي سليمان موقف المستغرب المتأمل، فلا أشك أن عبد القاهر (المتوفى سنة 471هـ) حين قرأ هذا الكلام الواضح الدال على إبهام لفظ (البلاغة). وإسناد إعجاز القرآن إليها، كان يومئذ أشد استغرابًا وتأملاً، وأن هذه المقالة التي قالها أبو سليمان الخطابي كانت تمشي معه إذا مشى، وتبيت معه إذا نام، وأنه كان صادقًا كل الصدق حين قال: (ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة، والبيان والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات، وفي تفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبئ ليطلب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج ... ووجدت المعول على أن ههنا نظمًا وترتيبًا، وتأليفًا، وتركيبًا، وصياغة، وتصويرًا، ونسجًا، وتحبيرًا) . [انظر ما سلف: ص94]. فهذه الألفاظ الثمانية التي ذكرها، وتحكي قصة عبد القاهر كلها، وهو يراوغ هذا الإبهام المحيط بلفظ (البلاغة) وما ذكره من تقدمه من وجوه البلاغة التي يعهدونها، كالذي مر آنفًا من أقسام البلاغة العشرة عند الرماني [انظر ص: 86] وهي: (الإيجاز، [مداخل إعجاز القرآن: 100] والاستعارة، والتشبيه، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان) = وما كان من استقصار الباقلاني هذه الغاية]، وأن من قدر البلاغة في هذه الأوجه العشرة (لا يعرف في البلاغة إلا القليل، ولا يفطن منها إلا لليسير)، ثم ما جاء في كتابه (إعجاز القرآن) من وجوه البلاغة التي سماها (البديع) [إعجاز القرآن 170 – 170]، ثم ختمها بقوله: (وقد قدر مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب التي نقلناها، وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه. وليس ذلك كذلك عندنا، لأن هذه الوجوه، إذا وقع التنبيه عليها، أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لها، وذلك كالشعر الذي إذا عرف الإنسان طريقه، صح منه التعمل له وأمكنه نظمه. والوجوه التي تقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها، فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال [إعجاز القرآن: 162]، ولكنه لم يخرج من جميع نقده لأقوال من تقدمه ولا من محاولته كشف الإبهام عن معنى (البلاغة)، إلا بأقوال محصلها هي أيضًا أنها (إشكال أحيل إلى إبهام) كما قال الخطابي. فأنه لما فرغ من ذكر وجوه (البلاغة) كما هي عندهم يومئذ قال: (وإنما ننكر أن يقول قائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيها [مداخل إعجاز القرآن: 101] الإعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به من الكلام ويفضي إليه، مثل ما يقول: إن ما أقسم به وحده معجز، وإن التشبيه معجز، وإن التجنيس معجز. أما الآية التي فيها ذكر التشبيه، فإن ادعى إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها، فإني لا أدفع ذلك بل أصححه، ولكن لا أدعي إعجازها لموضع التشبيه). [إعجاز القرآن: 418]، ثم قال بعقب ذلك، [إعجاز القرآن: 418 – 402]: (ومن تلك الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلق به كالبيان. فالقرآن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه مما جمع وجوه الحسن وأسبابه، وطرقه وأبوابه: من تعديل النظم وسلامته، وحسنه وبهجته، وحسن موقعه في السمع، وسهولته على اللسان، ووقوعه في النفس موقع القبول، وتصوره تصور المشاهد، وتشكله على جهته حتى يحل محل البرهان ودلالة التأليف، مما لا ينحصر حسنًا وبهجة، وسناء ورفعة. وإذا علا الكلام في نفسه، كان له من الوقع في القلوب، والتمكن في النفوس، ما يهذل ويبهج، ويقلق ويؤنس، ويطمع ويؤيس، ويضحك ويبكي، ويحزن ويفرح، ويسكن ويزعج، ويشجى ويطرب، ويهز الأعطاف، ويستميل نحوه الأسماع، ويورث الأريحية والعزة، وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودًا، ويرمى السامع من وراء رأيه مرمى [مداخل إعجاز القرآن: 102] بعيدًا، وله مسالك في النفوس لطيفة، ومداخل إلى القلوب دقيقة. وبحسب ما يترتب في نظمه، ويتنزل في موقعه، ويجري على سمت مطلعه ومقطعه، يكون عجيب تأثيراته، وبديع مقتضياته. وكذلك على حسب مصادره، يتصور وجوه موارده. وقد ينبئ الكلام عن محل صاحبه، ويدل على مكان متكلمه، وينبه على عظيم شأن أهله، وعلى علو محله). وهذا الذي نقلته لك، هو الذي أشرت إليه آنفًا من أن القاضي كان متكلمًا ولكنه كان ذواقة، وبصنعة الكلام كان يمارس إزالة الإبهام أو يحاولها، ولكنه كان يفضي إلى سد منيع، فيفر إلى التذوق، وإلى نعت ما يجده في نفسه من تذوق القرآن العظيم، متبعًا سنة الشيخ أبي عثمان الجاحظ التي أشرت إليها مرارًا. فالذي لا ريب فيه عندي أن عبد القاهر قد أحس بهذا كله واضحًا جليًا، فضمن أربعة ألفاظ من هذه الثمانية التي ذكرتها آنفًا (في الفقرة الأولى من كلامه)، وهذه الألفاظ هي: (الصياغة، والتصوير، والنسج والتحبير) = ضمنها تاريخ تأمله لهذا الخليط من الألفاظ، كالاستعارة والتشبيه والتلاؤم، إلى آخر وجوه البلاغة التي سماها الباقلاني (البديع)، فحاول محاولته الأولى في كشف الإبهام عن هذه الأربعة، الدالة على الأبواب التي تناولها في كتابه، [مداخل إعجاز القرآن: 103] وهي التشبيه والتمثيل والاستعارة والحقيقة والمجاز، وهي أبواب (علم البيان) كما سماه البلاغيون من بعده، والتي جاء ذكرها في كتب من تقدمه من أهل العلم. ومدار هذه الفصول جميعًا على (الألفاظ) التي هي عنده (خدم المعاني، والمتصرفة في حكمها)، [وانظر دلائل الإعجاز ص: 309)]. ولستُ هنا بصدد شرح ما أراده عبد القاهر أو ذكر أقواله، ولكني أردتُ الدلالة على أن هذا (الإبهام) الذي كان يحيط بأبواب (البلاغة) عند من تقدمه، قد ألقى عليه عبد القاهر ضوءًا كاشفًا لأكثر مبهماته، وجعل الأمر في هذه الأشياء المعتمدة على (اللفظ) مصروفًا كله إلى المعاني التي تحكمها في باب التشبيه أو الاستعارة أو المجاز. وقد كشف عن ذلك بعض الكشف في أول كتابه [أسرار البلاغة: 20] حيث يقول: (وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع، فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام بهما إلا من جهة المعاني خاصة، من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب، أو يكون لها في التحسين، أو خلاف التحسين، تصعيد وتصويب). وقد كان عمل عبد القاهر في هذا الكتاب، (أسرار البلاغة)، هو تحليل الألفاظ المتصرفة بأمر المعاني التي تحكمها، والبيان عن وجه حسنها وقبحها، أو خطئها وصوابها، ومراتبها من العلو والنزول، غير [مداخل إعجاز القرآن: 104] مقطوعة عن أصلها الذي تنتمي إليه، وهو أنها واقعة في خلال كلام ذي نظم وتأليف وتركيب. وبذلك وضع لهذه الأمة العربية أول كتاب في (تحليل اللغة)، لم يكن له شبيه من قبل في لسان من الألسنة، وكل من جاء من بعده فهو عالة عليه فيه. والحديث عن كتاب (أسرار البلاغة) يحتاج إلى فصل قائم بذاته، لا محل له هنا، وإنما هي الإشارة إليه لا غير. وأما الألفاظ الأربعة الأخرى، وهي: (النظم، والترتيب، والتأليف، والتركيب) فهي كلها متعلقة بالجمل، ومعنى (الجمل) أنها الكلام المركب من الأسماء والأفعال والحروف، للدلالة على المعاني التي يريدها المتكلم. ولا بد لهذا التركيب أن يكون بعض أجزائه متعلقًا ببعض. وقد تكفل بدراسة وجوه هذا التركيب ما نسميه (علم النحو)، والغرض منه هو ضبط صحة تعلق الكلم بعضها ببعض. بيد أن (علم النحو) يقف عند حصر هذا التعلق للدلالة على معاني التركيب، من حيث هو فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو خبر أو حال أو نعت أو عطف أو تمييز أو استثناء، ثم النفي والاستفهام والجزاء والشرط، وما يوجبه ذلك التعلق من الأحكام. وكان (علم النحو) على عهد عبد القاهر، قد بلغ غاية من الدقة والوضوح والاستيعاب، منذ كان الخليل وسيبويه، إلى أن [مداخل إعجاز القرآن: 105] احتفل به الأئمة من علمائه في عهده وقبيل عهده، كأبي علي الفارسي، وأبي الفتح بن جني. كان عبد القاهر نفسه ممن أعطى (النحو) نصيبه من التمحيص والتأمل، حين ألف كتابه الكبير (المغني) الذي شرح به (كتاب الإيضاح) لأبي علي الفارسي، في ثلاثين مجلدًا، فاكتسب بفنون تركيب الجمل خبرة مرهفة، ولكنها لا تزيد على أن تكون دقة في الحصر، ومهارة فائقة في التناظر والتشابه، ومعاودة لصقل (النحو) صقلاً يزيل عنه الصدأ حتى يتلألأ. وهذا أمر شاركه فيه غيره من أئمة هذا العلم الجليل الذي لا نظير له في جميع ألسنة البشر منذ كانوا إلى يوم الناس هذا، وإن شارك كل لسان في بعض معناه، لأن لكل لسان من الألسنة (نحوًا) من جنسه، ولكن أين الثرى من الثريا؟ كما يقولون، وإن جهل هذا أدعياء أهل زماننا جهلاً يكتب به عليهم التقصير في الفهم، لا البصر بالحقائق، وإن ادعوا ذلك بألسنتهم، فإنها دعوى كاذبة، لا أكثر ولا أقل. كانت هذه الدقة المذهلة في الحصر والاستيعاب والتقسيم والتبويب، والتي قام بعبئها الأكبر إماما (النحو): الخليل بن أحمد، وسيبويه، ثم ما جاء على آثارهما من تفصيل واستدراك وتمحيص إلى عهد عبد القاهر = كان ذلك كله يحمل في ثناياه خبئًا مستورًا [مداخل إعجاز القرآن: 106] دفنيًا لمن يبحث عنه ويخرجه، كما أشار إلى ذلك عبد القاهر نفسه، إلا أن الذي حرك عبد القاهر لم يكن هذا الخبء الدفين نفسه، بل كان شيئًا آخر جعله ينكشف له بغتة أن ههنا خبئًا دفينًا، وجوهرًا نفيسًا مغمورًا، ولكنه يلمع لمعانًا خاطفًا من وراء حجب (النحو) التي أسدلتها عليه طرائقه ومصطلحاته ومناهجه. كان عبد القاهر، كما قلت، فقيهًا شافعيًا، ثم متكلمًا أشعريًا مغموسًا في قضايا (الكلام)، ولكنه كان قبل ذلك كله نفسًا ملهوفة بالبيان وبتذوق البيان، جبلة فطر عليها، واكتسابًا صقلته صحبة فحول الشعر والأدب والنقد في زمانه، ومشاركته في الصراع الدائر بين أهل الأدب في تفضيل شعر على شعر، وبيان على بيان. وكان جهده الذي بذله في كشط غاشية (الإبهام) عن وجه البلاغة، كما عرفها من قبله، في الاستعارة والتشبيه وما إليهما مما يتعلق باللفظ، كما أشرت إليه آنفًا = كان هذا الجهد غير مقنع ولا كاف في أمر (إعجاز القرآن). وأدرك ذلك عبد القاهر إدراكًا واضحًا لا ريبة فيه، وبقى إبهام آخر، هو الذي أشار إليه أبو سليمان الخطابي أيضًا في كلامه = قائمًا، حيث يقول: (قالوا وقد يخفى سببه عند البحث، ويظهر أثره في النفس، حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. قالوا: وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع، وهشاشة في النفس لا يوجد مثلها لغيره [مداخل إعجاز القرآن: 107] منه، والكلامان معًا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة). فلما استحرَّ جدال المتكلمين، جاء المعتزلي قاضي القضاة عبد الجبار، يحاول كشف الإبهام عن البلاغة من وجه آخر غير الذي قال فيه الناس من قبله، فقال: [المغني: 16: 199]، وما بعدها]: (اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم = وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه = وقد تكون بالموقع، لأنه ليس لهذه الأقسام الثلاثة رابعٌ ... فإن قال: فقد قلتم في أن جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى، فهلا اعتبرتموه؟ قيل له: إن المعاني، وإن كان لا بد منها، فلا تظهر فيها المزية، وإن كانت تظهر في الكلام لأجلها ... على أنا نعلم أن المعاني لا يقع فيها تزايد، فإذن يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عند الألفاظ التي يعبر بها عنها، على ما ذكرناه. فإذا صحت هذه الجملة، فالذي به تظهر المزية، ليس إلا الإبدال الذي تختص به الكلمات، أو التقدم أو التأخر الذي يختص الموقع، أو الحركات التي تختص الإعراب، فبذلك تقع المباينة). وكان في أكثر كلام [مداخل إعجاز القرآن: 108] القاضي المعتزلي بعد ذلك غثاثة وصدأ وتيبس، مردها جميعًا إلى طبيعة (التكلم) نفسه، أولاً وأخيرًا. وقد أتى القاضي المعتزلي على جميع الوجوه التي تؤدي إلى ما يريده من محاولته كشف الإبهام عن (البلاغة)، ولكن الذي أطال فيه، لا يكاد يغني شيئًا، بل جاء فيه بآفات كثيرة البلايا، لأنه كان يتحرك في ميدان (علم الكلام) المحدود بحدود مذهب الاعتزال الذي ينتمي إليه، ومع ذلك، فأنا أظن أن عبد القاهر قد استفاد من تخليط قاضي القضاة فائدة لا تقدر، لأنه بتذوقه للبيان، وبتمكنه من (النحو) الذي وقف على خفاياه، قد استطاع أن يكتشف زيف أكثر كلام قاضي القضاة. وفي خلال ذلك انتبه بغتة إلى ما افتتحه أبو عثمان الجاحظ من نعت تذوق القرآن العظيم في مواضع كثيرة من كتبه، ولا سيما كتاب (الاحتجاج لنظم القرآن) وإلى ما تبعه فيه القاضي الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) كما بينت ذلك آنفًا، وذلك نحو قول أبي عثمان: (لأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، لتبين له في نظامها ومخرجها، وفي لفظها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها ... ولو أراد أنطقُ الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة، طويلة أو قصيرة. على نظم القرآن، [مداخل إعجاز القرآن: 109] وطبعه وتألفه، مخرجه، لما قدر عليه)، ثم تسميته كتابه (الاحتجاج لنظم القرآن، وغريب تأليفه، وبديع تركيبه) = ثم ما أنمه القاضي الباقلاني فيما سلف. وهذا التنبه المفاجئ للألفاظ التي نعت بها تذوق القرآن العظيم، أوقف عبد القاهر على أربعة ألفاظ منها، وهي: (النظم، والترتيب، والتأليف، والتركيب)، فرآها جميعًا تدل على إحساس المتذوق ببناء الجمل في القرآن العظيم وتركيبها [انظر ما سلف ص: 94]، أي بوجوه (النحو) فسأل نفسه هذا السؤال الحاسم الواضح المفصل الذي أثبته في مدخل كتابه (دلائل الإعجاز)، (ص: 6)، قال: (ما جوابنا لخصم يقول لنا: إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق (يعني التركيب النحوي للغة) = التي هي محصول النظم = موجودة على حقائقها وعلى الصحة، وكما ينبغي، في منثور كلام العرب ومنظومه ... فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، وباهر الفضل، والعجيب من الرصف، حتى أعجز الخلق قاطبة؟ ... أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله، ونرده عن ضلاله، وأن نطلب لدائه...؟ فإن كان ذلك يلزمنا، فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه (يعني كتاب دلائل الإعجاز)، ويستقصى التأمل لما أودعناه). [مداخل إعجاز القرآن: 110] ثم ختم كتابه بقوله (دلائل الإعجاز 377، 378): (ما أظن بك = أيها القارئ لكتابنا، إن كنت وفيته حقه من النظر، وتدبرته حق التدبر = إلا أنك قد علمت علمًا أبى أن يكون للشك فيه نصيب، وللتوقف عنه مذهب، أن ليس النظم شيئًا إلا توخى معاني النحو وأحكامه ووجوهه، وفروقه فيما بين معاني الكلم ... فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئًا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن، إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه ولم يعلم أنها معدنه ومعانه (أي مباءته وموطنه)، وموضعه ومكانه وأنه لا مستنبط له سواها، وأن لا وجه لطلبه فيما عداها = غار نفسه بالكاذب من الطمع، ومسلم لها إلى الخدع = وإنه إن أبى أن يكون فيها، كان قد أبى أن يكون القرآن معجزًا بنظمه، ولزمه أن يثبت شيئًا آخر يكون معجزًا به، وأن يلحق بأصحاب الصرفة، فيدفع الإعجاز من أصله). وقد بلغ عبد القاهر أعلى الذرى في القدرة على كشف إبهام (البلاغة) من هذا الوجه الذي كان أول من تنبه إلى حقيقته، بفضل طول تأمله في كلمات أبي سليمان الخطابي الذي أحسن في [مداخل إعجاز القرآن: 111] المصارحة بأن أمر (البلاغة) أمر مبهم، ثم بطول تأنيه في استكناه نعوت تذوق القرآن العظيم، التي نعت بها أبو عثمان الجاحظ خاصة، والباقلاني من بعده، ما وجدا من هذا التذوق. وكانت كلمات الجاحظ أشدهن تأثيرًا، وأوقعهن على حقيقة التذوق، وأروعهن استثارة وإيحاء. والذي فعله عبد القاهر في كتابه (دلائل الإعجاز) هو أول تحلية للغة، من حيث هي تركيب يحتمل ألوفا من وجوه الأوضاع، ودلالة هذه الأوضاع على المعاني المستورة التي يحملها كل تركيب، ومزية كل تركيب في اشتماله على وجوه (البيان) القائمة في نفس المبين عنها. وبهذا الكتاب، وصنوه (كتاب أسرار البلاغة)، أسس عبد القاهر (علم تحليل البيان الإنساني كله)، لا في اللسان العربي وحده، بل في جميع ألسنة البشر. وضع عبد القاهر هذا الأساس، فلم يسبقه إليه سابق، ولا لحقه من بعده لاحق في لسان العرب، ولا غير لسان العرب. وإذا كان عبد القاهر، في تدفقه وفي تدافع المعاني في صدره، قد اطمأن اطمئنانًا ظاهرًا إلى أنه قد كشف الإبهام كشفًا عن معنى (البلاغة)، ثم عن وجه إعجاز القرآن، بما وضع من هذا العلم الجليل = فإني أراه قد نصب لنا إبهامًا آخر، سأحدثك عنه بعد قليل. ذكر عبد القاهر في صدر كتابه [ص: 28، 29] ما حمله على [مداخل إعجاز القرآن: 112] إدامة النظر في معنى (الفصاحة والبلاغة، والبيان والبراعة)، فنزع إلى بيان إشكال ما أشكل، وإلى حل ما انعقد، وإلى الكشف عما خفى من صفاتها، ورام أن يضع القاعدة التي يبنى عليها هاذ العلم، فقال: (ص29): (وجدت المعول على أن ههنا نظمًا وترتيبًا وتأليفًا وتركيبًا، وصياغة وتصويرًا، ونسجا وتحبيرًا = وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه، سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها = وأنه كما يفضل هناك النظم النظم، والتأليفُ التأليفَ، والنسجُ النسجَ، والصياغةُ الصياغةَ، ثم يعظم الفضل، وتكثر المزية، حتى يفوق الشيء نظيره المجانس له درجات كثيرة، وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد = كذلك يفضل بعض الكلام بعضًا، ويتقدم منه الشيء الشيء، ثم يزداد من فضله ذلك، ويترقى منزلة فوق منزلة، ويعلو مرقبًا بعد مرقب، ويستأنف له غاية بعد غاية، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز). وكل ما قاله عبد القاهر هنا حق، قد أجاد التدليل عليه في كتابيه، بتحليل بالغ الروعة والقوة والصدق، معرق في القدرة على تذوق البيان، وعلى البيان عن هذا التذوق، إلا أنه ختم هذه المقالة بدعوى، لا هو استطاع البرهان عليها، ولا أحد غيره ممن جاء [مداخل إعجاز القرآن: 113] بعده، وذلك قوله: (حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز؟ وهو بهذا يشير إلى (إعجاز القرآن). لم يحد لنا عبد القاهر هذا الحد، ولا من أين يبدأ هذا الافتراق بين الكلام المتفاوت درجة بعد درجة = وبين الكلام الذي تنقطع دونه الأطماع وتحسر الظنون، وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز؟ فإنما هذه صفات ونعوت لما في نفسه من التذوق لهذا القرآن العظيم، لا تبعد كثيرًا عن نعوت تذوق الإمامين الجليلين أبي عثمان الجاحظ، وأبي بكر الباقلاني، في حالة إبهام معنى (البلاغة)، قبل أن يبدأ هو في إماطة اللثام عن هذا الإبهام بكتابيه الجليلين: (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز). وظني أن إمامنا عبد القاهر، كان يحس إحساسًا غامضًا = بعد الجهد المضني الذي بذله في كشف إبهام (البلاغة) من جميع أطرافها = بأنه قد بقى شيء غامض مبهم هو عليه مشرف بتذوقه لهذا القرآن العظيم لم يجد عبد القاهر عندئذ مناصًا من اللجوء إلى ما لجأ إليه أبو عثمان الجاحظ في تذوقه لهذا القرآن، حين لم يجد (الصرفة) مغنية غناء مقنعًا، وأن نظم القرآن، وبيانه وطبعه ومخرجه أجل من أن يتردد متردد في شأنه، فنعت أبو عثمان تذوقه نعتًا مثيرًا موحيًا بألفاظ تعب في استخراجها من أعماق [مداخل إعجاز القرآن: 114] اللغة. فكذلك فعل عبد القاهر حين خامره هذا الإحساس الغامض المبهم، بعد أن استقصى جهده في كشف إبهام البلاغة، فاستحدث هو أيضًا هذه النعوت الموحية المثيرة. (حيث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز)، فهي أيضًا نعوت متذوق لشيء مبهم لم يبلغ الغاية في تفسير ما يحيط به من الإبهام. وأنا أتوهم أيضًا أن هذا الأفق القصيّ المغلف بالإبهام، كان يلوح لعبد القاهر من وراء نعوت الجاحظ المثيرة الموحية التي يقرؤها في كتابه (الاحتجاج لنظم القرآن، وغريب تأليفه، وبديع تركيبه، وسلامته من الزيادة والنقصان)، ثم في غيره من كتب أبي عثمان، وذلك أني لاحظت آنفًا أن إمامنا عبد القاهر حين وضع كتابه (دلائل الإعجاز) كان قد فرغ من تأمل ألفاظ كثيرة مثيرة موحية في نعت القرآن العظيم، نعت بها أبو عثمان تذوقه لهذا القرآن، فاستخرج منها أربعة ألفاظ أدار عليها قوله في (دلائل الإعجاز). وهذه الألفاظ هي: (النظم، والتأليف، والتركيب، والترتيب)، ولكنه أغفل من ألفاظ أبي عثمان لفظين شديدي الغموض الداعي إلى الاستثارة، ولكنهما حافلان بالإيحاء أيضًا، وهما: (نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجه)، ولذلك لا نجد في [مداخل إعجاز القرآن: 115] كتاب عبد القاهر ذكرًا أو تفسيرًا (لطبع القرآن ومخرجه)، ولا نجده مسَّ ما يثيرانه أو يوحيان به من قريب أو بعيد، وبقيا في تأمله لفظين مبهمين حائرين في غمرة النور الساطع الذي انبثق عنه فكره فكشف الإبهام المحيط بالألفاظ الثمانية (النظم، والتأليف، والتركيب، والصياغة، والتصوير، والنسج، والتحبير)، كما أسلفت بيانه [ص: 94 وما بعدها] وأنا أحس إحساسًا غامرًا، وأنا أقرأ كتب عبد القاهر، أن هذين اللفظين: (الطبع، والمخرج)، كانا يجولان في أقصى حسه، وهو منطلق بأقصى جهده، لا يتوقف ولا يتلفت، يفسر ألفاظ أبي عثمان الثمانية في كتابيه: (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز)، ويعد ما تثيره وتوحى به إعدادًا بالغ الروعة لاستخراج هذا العلم الجديد، الذي استهدف به تحليل اللغة وتحليل البيان تحليلاً أفرده في تاريخ اللغات كلها بالسبق والتفوق. وبقى هذان اللفظان حائرين مبهمين غامضين يترددان في بهرة النور الساطع، وهو دائب يتذوق القرآن، شاخصًا بجميع نفسه إلى الأفق الأعلى الذي عنده القرآن العظيم. فلما عجز عن أن يستخرج منهما شيئًا يعول عليه، لم يملك حيال هذا الإبهام، إلا أن يلجأ إلى ما لجأ إليه أبو عثمان، فقال ينعت ما يحسه من التذوق المتعلق (بطبع القرآن ومخرجه ومخرج آياته) (تنقطع دونه [مداخل إعجاز القرآن: 116] الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز). فهذه هي المرتبة المنقطعة وحدها بعد (البلاغة التي كشف إبهامها بكتابيه. مرتبة مسترة بالإبهام، لعلها كانت قائمة في نفسه، ولكنه لم يطق الإبانة عنها، كما قال الشافعي رحمه الله، حين سُئِلَ عن مسألة فقال: (أجد بيانها في قلبي، ولكن لا ينطلق به لساني)! ولكن حسب عبد القاهر ما أدرك من كشف غمة الإبهام عن (البلاغة) بكتابيه الجليلين الفائقين. وحسبي أنا، فيما أظن، ما قلته آنفًا! فإن الأمر أوسع سعة، وأعمق عمقًا، وأبعد منالاً، من قدرة هذا الجهد الذي بذلته. وهو محتاج إلى تفصيل لا يتحمله مثل هذا (المدخل) الذي اردت به تاريخ بعض ما وجدته، وأنا مغموس في قضية (الشعر الجاهلي) وفي شأن (إعجاز القرآن) وقد جاءت الأئمة بعد عبد القاهر، وبلغوا غاية البراعة والحذق في البيان عن (البلاغة)، وفي الزيادة على ما قاله شيخ البلاغة من وجوه مختلفات، ولكن لم يكن لأحد منهم مثل سجايا عبد القاهر في تذوق البيان، ولا في الإبانة عن وجه هذا التذوق. ولجميعهم فضل باهر، ولكنه بان منهم بفضل لا يدانيه فيه أحد، وبمزية لم يؤت مثلها منهم أحد. [مداخل إعجاز القرآن: 117] ونفثة مصدور، أختم بها هذا التاريخ: أن طائفة من متهوري أهل زماننا، وهو زمن التهور والثرثرة، قد أوغلوا إيغالا شنيعًا يلحق بالعبث، في التهوين من شأن (النحو) الذي بنى عليه عبد القاهر نظره في الكشف عن إبهام (البلاغة) فوضع أساس (علم تحليل التركيب اللغوي)، تحليلاً يبين عن درجات (البيان) الإنساني في جميع لغات البشر. وعن سر تأثير الكلام المركب من الألفاظ، في نفس الإنسان المتذوق لهذا الكلام، فيهتز لبعضه اهتزاز الأريحية، ويجد له من العذوبة والبشاشة ما يحمله على حفظه وترديده، وتأمل جماله وروعته. وجهلة الدعاة إلى (تبسيط النحو): المهونين من شأنه، إنما يريدونه علمًا فارغًا لا يزيد على أن يكون مجرد عاصم من الخطأ في ضبط أواخر الكلمات رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، لا غير! وطائفة أخرى من الأدباء والشعراء الذين هبطوا إلى أرض الأدب والشعر وهي خواء مقفرة، همه أشد إيغالاً في الطعن على (علم البلاغة) بفرعيه: (علم المعاني) و(علم البيان)، وتابعهما (علم البديع)، وهم أيضًا أشد وتهوينًا لشأن البلاغة، وأبلغ فسقًا وخروجًا عن منازلها ومراتعها ورياضها. ثم لا يدري هؤلاء الطاعنون من جهلة زمننا، أنهم بجهلهم يقتلون (البيان) في أنفسهم وفي أنفس البشر من بني جلدتهم. و(البيان) هو النعمة التي مَنَّ الله بها على الإنسان، [مداخل إعجاز القرآن: 118] ليخرجه من حيز البهائم والعجماوات، فهم أحرى أن يدركوا أنهم بجهلهم وتهورهم يقتلون لغة، يسر الله نزول القرآن بلسان أهلها، وهم نحن العرب، والله سبحانه يقول لنا في كتابه العزيز: {لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون} [الأنبياء: 10] وأسأل الله أن لا يتم علينا وعليهم قوله سبحانه: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون} [المؤمنون: 71]، وذلك برجوع هؤلاء الطاعنين، إن شاء الله، عما هم اليوم في شأنه مسرفون، فإذا فعلوا، فعسى أن يأتي يوم يأذن الله فيه بأن ينشأ مِنَّا أو من أعقابنا من يتمم عمل عبد القاهر، ويكشف ما عجز عن بيانه وتفسيره، في شأن (طبع القرآن ومخرجه ومخرج آياته) ويومئذ يتغير القول في مسألة (إعجاز القرآن) تغيرًا يخرجنا من هذه البلبلة التي استمر إبهامها قرونًا طويلة كما سترى).[مداخل إعجاز القرآن: 97-118]
__________________
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
كتاب مداخل إعجاز القرآن للأستاذ محمود محمد شاكر صفية الشقيفي (19) أسباب عطن عبد القاهر الجرجاني، وبيان المؤلف لمعنى الآية قال أبو فهر محمود بن محمد شاكر الحسيني (ت: 1418هـ): (19) كان عبد القاهر، كما علمت، متكلمًا محكم الأداة جيد النظر في (علم الكلام) وكان، كما دلت عليه أعماله الباقية عندنا، أديبًا ذواقة فائق التذوق، مشرق البيان عن أسرار تذوق الكلام النبيل الشريف الباهر. وكان أيضًا مقتدرًا كل الاقتدار على تحليل [مداخل إعجاز القرآن: 119] الكلام المركب من الألفاظ تحليلاً يكشف الستر عن خباياه الملثمة = وعلى توسم آثار (العلائق) الظاهرة والخفية، كالأدوات والحروف، في ربطها بين هذه الألفاظ المنصوبة للدلالة على المعاني = وعلى استخراج نبيثة ما يلحق معاني هذه (العلائق) من التغير اللطيف الدقيق، بتغير مواقعها من الكلم = وعلى استنباط الدفين المستور من المعاني المتحجبة، التي تكمن من وراء أوضاع هذه (العلائق) المتقلبة المعاني، التي هي بطبيعتها عماد الكلام المركب من الألفاظ. وكان قبل ذلك كله لغويًا خبيرًا بجواهر ألفاظ اللغة ومعانيها، بصيرًا بمذاق ألفاظها مفردة ومركبة، سميعًا لخفى جرس حروفها فذة وملتئمة. مرهف الحس بتمكنها، مذاقًا وجرسًا ودلالة على المعاني، في مواقعها ومنازلها من الكلام المركب، أو بِنُبُوَِ مذاقها وجرسها ودلالتها على المعنى حيث وقعت في سياق التركيب. ولكن كان في إمامنا عبد القاهر عيب عائق له عن بلوغ الغايات في بيان ما يجده في نفسه وفي عقله وفي قلبه. وقد أدرك بعض القدماء من علمائنا هذا العيب في سنخ غريزته وطباعه، فقد ذكر القفطي (568 – 646هـ) هذا العيب في ترجمة عبد القاهر، في كتابه (إنباه الرواة)، فقال: (كان، رحمه الله، ضيق العطن، (أي قريب الملل)، يضيق صدره فجأة، فكيف عما هو [مداخل إعجاز القرآن: 120] مغرق في تأمله وبيانه)، لا يستوفي الكلام على ما يذكره، مع قدرته على ذلك). وصدق القفطي، فهذا عيب بين تلوح آثاره في مواضع كثيرة مما كتب وخاصة في كتابه (دلائل الإعجاز). وهذا العيب الناشب في طبيعته، أمسك به إمساكًا مثبطًا، حين اندفع داخلاً مدخله الرائع، متأهبًا للكشف عن إبهام (البلاغة)، متجمعًا لصراع هؤلاء المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، الواغلين المتهجمين على رياض (البلاغة) بغثاثة (علم الكلام) الذي اتخذوه صناعة وعملاً، حتى ظنوا أنهم قادرون على التحكم في كل شيء بمجرد الدعوى، ثم اللجاجة في الدعوى بأنهم أصحاب (العقل) الملتزمون بأحكامه، القادرون وحدهم على الفصل في كل مبهم بقضائه الذي لا يرد! فبضيق العطن، نسى عبد القاهر جملة الأسباب التي دفعته إلى هذا المدخل، فأعرض إعراضًا عن تفحص هذه الأسباب قبل أن يدخل إلى ما دخل إليه. وقد أسلفت، في خلال حديثي، بيان بعض تلك الأسباب، وكلها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم الكلام الذي كان من قبل منغمسًا فيه زمنًا طويلاً أو قصيرًا، من حياته. كانت مسألة (إعجاز القرآن) حديثًا محتدمًا بين المتكلمين، فأغفله لغطهم عن تمحيص أصل (المسألة) وكشف إبهامها، قبل أن يبدأ في تمحيص القول في [مداخل إعجاز القرآن: 121] (البلاغة) وكشف إبهامها، وذلك لضيق عطنه ولعجلته أيضًا، مع قدرته على أن يفعل. ولو فعل، لتغير الأمر كل التغير، ولأتى بأكبر وأعمق وأروع مما أتى به في كتابيه الجليلين: (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز)، والله أعلم، ولا أفتات على الغيب. أما الآن، فقد آن لي أن أروض نفسي على ترك مخاوفها، وعلى أن أكبح جماحها أيضًا، مستعينًا بالله ربي على أن يوفقني إلى إيجاز القول في (مسألة إعجاز القرآن)، منذ تنزيل القرآن العظيم إلى أن استحدث لفظ (إعجاز القرآن)، ثم امتدادها إلى زمان عبد القاهر. وعندئذ يظهر السبب الذي حال بين عبد القاهر وبين تخطي الحواجز التي كان يحسها بوجدانه وبصيرته، ولكن لا يستطيع أن يتبينها بالعقل والنظر = وتتجلى العلة التي من أجلها وقف عبد القاهر حائرًا شاخص النفس إلى هذا الذي كان يلوح له في تذوق القرآن، ثم لم يستطع الدلالة عليه إلا بالنعت المجرد، غير قادر على الإبانة عنه، وغير مطيق لمحاولة تفسيره وإزالة إبهامه، كما فسر (البلاغة) وأزال إبهامها = ويتكشف لنا أن (علم الكلام) ولغطه، ودويه بالألفاظ المبهمة التي لا يحصل لها معنى، هو الذي قاده، من حيث لا يدري إلى طريق مسدود لم يجد وراءه منفذًا للإبانة والتفسير، مع قدرته، عَلِم الله، على ذلك. [مداخل إعجاز القرآن: 122] لا بد من الحذر من أمرين عظيمي الخطر على العقل والفهم والنظر، فكلاهما مطية الضلال عن الحق: لا بد من ترك الاستهانة بالفروق البينة والخفية بين الألفاظ التي نتوهم بطول الإلف أنها تقع على معنى واحد وقوعًا واحدًا، وهو ما نسميه في اللغة (المترادف) = ولا بد أيضًا من الإقلاع عن إهمال تاريخ بعض هذه الألفاظ المترادفة في أوهامنا، ثم التمسك بالحرص على متابعة البحث عن نشأتها: متى نشأت؟ ولم نشأت؟ وكيف نشأت؟ ثم كيف وقع الترادف بين كل لفظين منهما حتى استويا في معنى واحد، فاصطحبا فاعتدلا في الاستعمال، أو تزاحما فغلب أحداهما الآخر على الألسنة. وقد دلني طول التتبع لهذه (المترادفات)، في الشعر وفي الأدب وفي الكتاب، وفي أبحاث العلماء في فنون مختلفة، على أن الاستهانة بالفروق وإهمال التاريخ، يؤديان أحيانًا إلى تفاسد المعاني تفاسدًا مبيرًا، ويفضيان أحيانًا أخرى إلى تخبط منهك مغبته كد وعرق، وإلى تخليط جامح عقباه ظلام مطبق وغبار. فبالإهمال والاستهانة، يخرج طالب الحق، بعد العناء والكدح الشديد، ومعه حق ملطخ الوجه، يطمس نوره ما لَبَّدَه عليه عرق التخبط من غبار التخليط. وأبين ما وقفت عليه من ذلك بيانًا، هو في مباحث طلاب الحق من (المتكلمين)، كأبي [مداخل إعجاز القرآن: 123] الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني ومن جاء معهما أو بعدهما من علماء الأمة، غفر الله لهم وأنابهم بحسن نياتهم، وبصدقهم في الذب عن دينهم وبإخلاصهم بذل المجهود، في طلب الحق المنشود. ومن أبين ذلك وأدله على خطر الاستهانة والإهمال في تحرير الفروق بين (المترادفات)، وفي تتبع تاريخ نشأتها، ما كان في كتب (علم الكلام) وكتب (البلاغة) وكتب (إعجاز القرآن). فبين أيدينا في كتب علماء الأمة على اختلافهم واختلاف مباحثهم، وعلى ألسنتنا جميعًا إلى يوم الناس هذا، لفظان جاريان، هما: لفظ (الآية)، ولفظ (المعجزة)، كان لهما شأن عظيم العواقب في (باب آيات الأنبياء) الدالة على صدقهم = وفي فهمهما حيث وقعا من كتابة الكاتبين، وأقوال الناطقين = وفي استعمالهما أيضًا في أبواب مختلفة من القول والحديث والكتابة. وقد استخدم الناس قديمًا وحديثًا هذين اللفظين على أنهما (مترادفان) بلا غضاضة، وهذا (الترادف) قد أفضى إلى خلط يصعب معه تبين وجه الحق، بل أفضى إلى ما هو أكبر من ذلك: إلى تصورنا أننا فهمنا فهمًا يبلغ بنا غاية اليقين، والحقيقة أن هذا الفهم تلبيس على العقل وتدليس يستوجب الشك ويمنع من اليقين. وقد مضت علي سنون وأنا غارق في (قضية الشعر الجاهلي) أطلب [مداخل إعجاز القرآن: 124] نفسًا أو نفسين حتى لا أهلك، فما نجوت من الهلاك حتى فصلت فصلاً حاسمًا بين هذين اللفظين (المترادفين)، فتنفست أنفاسًا ردت علي حياتي، بحمد الله وحده، فهو الذي أغاثني حيث لا مغيث من خلقه. وهذا شيء قد كان، مضت عليه أربعون سنة على الأقل، كنت قبلها لا أتبين أيا من أي، إنما هو القلق والحيرة والتردد في الظلمات، لا غير. أما لفظ (المعجزة) فقد سلف القول فيه وفي اشتقاقه، وبعض معناه، ثم في تاريخ نشأته في أواخر القرن الثالث من الهجرة، وأنه لفظ محدث مولد، رجحت أنا أبا عبد الله الواسطي صاحب كتاب (إعجاز القرآن)، هو أول من ولده. وبينت أيضًا لم جاء؟ وكيف جاء؟ ومتى بدأ يزاحم لفظ (الآية) في كتب العلماء وعلى ألسنتهم وأقلامهم؟ = وأن أكثر أهل العلم كانوا يقولون (آيات الأنبياء)، في معنى البراهين الدالة على نبوتهم، حتى إذا ما جاء القرن الرابع الهجري بدأوا يقولون (معجزات الأنبياء) و(آيات الأنبياء) معًا، ثم تزاحم اللفظان على أقلام الكتاب والعلماء، حتى غلب لفظ (المعجزة) لفظ (الآية) في ظله حتى قل قلة ظاهرة حتى كاد يخفى، بل لعله قد غاب غيابًا مشهودًا عن [مداخل إعجاز القرآن: 125] كل بحث في (معجزات الأنبياء) وفي (إعجاز القرآن) خاصة، وسوف أعود إلى تمام القول في هذا اللفظ، (المعجزة)، بعد الفراغ من الكلام عن لفظ (الآية). ولفظ (الآية) في كلام أهل الجاهلية الذين نُزِّل عليهم القرآن، كان له في شعرهم وكلامهم معانٍ آخذٌ بعضها برقاب بعض. 1- فالأصل الأول الذي خرجت منه هذه المعاني هو أن (الآية) العلامة، وقد اقتصر أكثر شراح الشعر على تفسيرها حيث وقعت في شعر الشعراء، بهذا المعنى وحده، دون تفصيل، فلذلك أردت أن أفصلها هنا، ليكون ذلك أبين وأوضح وأهدى. و(الآية)، بمعنى (العلامة)، هي العلامة التي ترى أو تسمع، فتصبح دليلاً يهتدي به إلى خفى أو غرض أو وجهة. فآية الطريق مثلاً، هي العلامة التي يراها المسافر في طريقه، فيتحرى شطرها ويعمد إليها، مهتديًا بها. 2- ثم قالوا لآثار الديار ورسومها، أيام مقام أهلها بها، أو عقب رحيلهم عنها، وقبل أن تغيرها وتطمس بعض معالمها الرياح والأمطار: (آيات الديار)، فمنه قول النابغة الذبياني [جاهلي]: توهمت آيات لها فعرفتهــــــــــــــــــــــــا ..... لستة اعوام وذا العام سابـــــــــــــــــــــــــــــع رماد ككحل العين مــــــــا إن تبينه .....ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشـــــــــــــــع [مداخل إعجاز القرآن: 126] منازل توهمها النابغة كما عهدها منذ ستة أعوام، فتغير الرماد على السنين، فصار كآثار كحل العين، وتغير النؤي الذي كان يحجز الماء عن خباء صاحبته، فصار كبقية حوض تهدم، فهو متكسر لاطئ بالأرض بعد شخوصه وبروزه. 3- ثم قالوا للبناء العالي الذي بنى ليستدل به: (آية). وقد نعى هود عليه السلام على قومه عاد، أنهم كانوا يعتمدون إلى كل ربوة مشرفة بارزة، فيبنون عليها (آية) عالية، لا لغرض الهداية، بل سفها وإسرافًا وتخليدًا لقوتهم وبطشهم، بهذا المعنى جاءت في آية واحدة من القرآن، وهي قوله تعالى فيما اقتصه من أقوال هود لقومه: {أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون} [الشعراء: 128 – 129]. 4- ثم قالوا لشخص الرجل وجثمانه الذي يرى من بعيد، أو في ظلمة، غير بين الملامح، وذلك لارتفاع شخصه وظهوره الدال على أنه إنسان: (آية)، فمن ذلك قول عروة بن الورد العبسي [جاهلي]، يقول لصاحبته أم حسان، بعد أن جشمته [مداخل إعجاز القرآن: 127] ما جشمته من كيدها بمكان يقال له (غضور): عفت بعدنا من أم حسان غضور ..... وفي الرحل منها آية لا تغير والذي على الرحل هو شخصه. يعني نفسه، وقد لوحته الرحل والأسفار. 5- ثم قالوا لكل شيء تسمعه أو تراه، فيذكرك بشيء نسيته أو غفلت عنه، وهو (العبرة) من العبر المذكرة (آية)، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني [جاهلي]: أراني إذا ما شئت لاقيت آية ..... تذكرني بعض الذي كنت ناسيا أي لقيت عبرة من العبرات تذكرني ما نسيت، ومنه قوله تعالى: {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} [يوسف:7]. 6- ثم قالوا لكل شيء يستدل به على أمر قد كان وحدث، ولا شك عند سامعه في حدوثه، وأن المتحدث به صادق: (أية)، وأكثر ما تأتي بهذا المعنى مقترنة بباء الجر، فمنه قول الحصين بن الحمام المري [جاهلي]: ولكن خذوني أي يوم قدرتم ..... علي، وجزوا الرأس أن أتكلمـــــا بآية أني قد فجعت بفــــــارس .....إذا عرد الأقوام أقدم معلمـــــــــــــــــا [مداخل إعجاز القرآن: 128] وهي هُنا بمعنى (الأمارة) التي تكون بين اثنين أو أكثر، تدل بمجرد رؤيتها أو سماعها، على شيء يعرفونه تمام المعرفة، اتفقوا عليه، أو كأنهم اتفقوا عليه. و(الأمارة) هي التي يقول فيها الشاعر الجاهلي المحسن الرقيق، يقول لصاحبته: إذا طلعت الشمس النهار، فإنها ..... أمارة تسليمي عليك، فسلمي جعل طلوع كل شمس، في كل صبح، أمارة بينه وبينها على تسليمه عليها. وهي بهذا المعنى باقية إلى اليوم في عاميتنا. 7- ثم قالوا الجماعة القوم إذا رحلوا جميعًا، لحرب أو في سفرة (آية) لأنهم عندئذ بارزون في بساط الأرض ظاهرون، يقولون (خرج القوم بآيتهم)، أي خرجوا جميعًا، ومنه قول البرج بن مسهر الطائي [جاهلي]: خرجنا من النقبين، لا حي مثلنا ..... بآيتنا، نزجي اللقاح المطافلا هذه أيضًا أكثر ما تأتي مقترنة بباء الجر، كالتي قبلها. 8- ثم سموا (الرسالة) التي يحملها رسول، فيبلغها إلى من يراد تبليغها إليه، وهي رسالة ملفوظة على الأكثر، أو مكتوبة أحيانًا: (آية)، لأنها تدل على صاحبها، وعلى ما في نفسه. هو معنى عزيز أغفلته كتب اللغة، مع استفاضته في شعر عرب الجاهلية، قد نص عليه أبو جعفر الطبري في أول تفسيره، ومنه قول [مداخل إعجاز القرآن: 129] النابغة الذبياني [جاهلي]: من مبلغ عمرو بن هند آية؟ ..... ومن النصيحة كثرة الإعذار أي: من يبلغه رسالة مني؟ في شعر كثير مثله. ويفسر قدماء شراح الشعر (الآية) في مثل هذا الشعر بأنها (العلامة)، وهو تفسير لا يليق، وصواب تفسيرها هو ما قاله أبو جعفر: (الرسالة). 9- (وقد قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: إن (الآية) أيضًا القصة: فيكون معنى (آيات القرآن): (القصص، قصة تتلو قصة، بفصول ووصول). ولم أجد في شعر الجاهلية ولا غيرهم، ما يجوز معه أن يحمل معنى (الآية) على أنه (القصة)، فمن أجل ذلك أجد هذا الوجه ضعيفًا عندي، وهو تعبير غير مفيد في معنى (الآية)، ولا أدري كيف قاله أبو جعفر رحمه الله؟ فهذا المعنى التاسع، لا أحب أن أعتد به، حتى تثبت عندي صحته. وبين أن هذه المجاري الثمانية التي يجري فيها لفظ (الآية)، تنبع كلها من معنى العلامة الظاهرة البينة الدالة، التي تراها العين، أو تسمعها الأذن، أو يتوهمها القلب، أو يثقفها العقل، هادية على الطريق أحيانًا، وتكون دليلاً على معنى يتطلب الدليل أحيانًا أخرى = وتكون شاهدًا على صدق الحدث والحديث تارة، [مداخل إعجاز القرآن: 130] وبيانًا صادقًا أو أمارة مصدقة تارة أخرى. فهي، إذن، في جميع مجاريها متعانقة المعاني، مسترسلة، سهلة التنقل من مجرى إلى مجرى بلا كد تلقاه على مجازها، وبلا توقف يحبس سامعها عن سهولة التنقل معها من معنى إلى أخيه، وبلا غضاضة في تبين ملامح الشبه بين هؤلاء الإخوة. بيد أني لم أجد عند أهل الجاهلية في كثير شعرهم الذي وقع إلينا، ولا في قليل كلامهم الذي أثر عنهم، ما يدل على أنهم قالوا: (آيات الأنبياء)، وهم يعنون (الآية) الشاهدة على صدق نبوة النبي، والأمارة المعروفة على أن مدعي ذلك رسول من الله إلى عباده من البشر. ولكني لا أظن أن فقدان هذا التعبير في شعرهم وكلامهم الذي وصل إلينا، يقوم دليلاً على أنهم لم يعرفوا قط معنى (آيات الأنبياء) في جاهليتهم. بل أنا أقطع بأنهم كانوا يعرفون معنى (آيات الأنبياء) مركبة معرفة صحيحة واضحة، ويعرفون معنى (الآية) ومعنى (النبي) غير مركبين، بأوضح وأسلم مما يعرفه أهل الكتابين جميعًا، أصحاب التوراة والإنجيل، كما سترى الحجة في الفصل التالي (20). وبديهة هذه المجاري الثمانية للفظ (الآية)، تقطع قطعًا مفضيًا إلى اليقين، أن أهل الجاهلية، لو هم كانوا قد سمعوا برجل يفعل فعلاً، تكفي رؤيته ومعاينته في الدلالة على أنه فعل داخل [مداخل إعجاز القرآن: 131] دخولاً مبينًا في قدرة الله وحده سبحانه، وأنه ممتنع أصلاً امتناعًا مبينًا عن قدرة البشر = لقالوا من فورهم، على سليقة مجازهم في لغتهم: (هذه آية!) أو (هذه أمارة!)، أي أنها دليل صادق وشاهد مبين، على أن الرجل قد صدق في دعواه أن الله أرسله نبيًا أيده بهذا الفعل الدالة معاينته على أنه داخل في أفعال الله التي استأثر بها دون خلائقه كافة. فهذا، إذن، معنى ظاهر كل الظهور، جار على مجاز لغة العرب في الجاهلية جريانًا سريحًا، أي سهلاً سريعًا لا يعوقه شيء وغير مستبعد عندي أن يكون كان في بعض كلامهم، ثم سقط من ألسنة رواة شعر أهل الجاهلية وكلامهم وأخبارهم، فيما سقط من الشعر والأخبار التي تؤثر. ولذلك، فلا بد من التوقف قليلاً، ومن التأني في الكشف عن لفظ (الآية)، وعن معناه عند أهل الجاهلية الذين نزل عليهم القرآن، فإن هذا الكشف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بموقفهم من القرآن في الحالين جميعًا: في حال جحدهم إياه وكفر من كفر به منهم، وفي حال تقبلهم نبوة تاليه عليهم، وإيمان من آمن منهم به. ومعرفة هذا المعنى معرفة واضحة، تسقط الحجاب الكثيف الذي أسدله لفظ (المعجزة) ولفظ (إعجاز القرآن)، على حقيقة الوجه الذي آمن عليه من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي كفر عليه [مداخل إعجاز القرآن: 132] من كفر من أهل الجاهلية الذين نزل عليهم القرآن العظيم، (آية) لرسول من أنفسهم جاءهم على فترةٍ من الرسل). [مداخل إعجاز القرآن: 119-133] (20) بيان المؤلف لأصل منهجه في البحث (تصحيح المبادئ خطوة خطوة بتتبع ما كُتب في القديم والحديث) قال أبو فهر محمود بن محمد شاكر الحسيني (ت: 1418هـ): (20) بل ههنا أصل من أصول منهجي، أعلم أن هذا الموضع من حديثي ليس مكان تفصيله والاحتجاج له، ولكني لا أملك التفلت منه وإغفاله، لأني أعد ترك التنبيه عليه هنا خيانة لأمانة العقل، وإغفال الإشارة إليه يجعل تتمة بحثي عن لفظ (الآية) عرضة للتوقف والتشكك والتساؤل، ممن لم يعرف المذهب الذي أبني عليه أكثر كلامي. وإذا أنا رضيت بذلك لما أكتبه، فقد رضيت له بأمر كريه مستشنع. فمن أجل ذلك رأيت أن أقتصر على ما لا بد منه، حتى يستبين الأمر للموافق والمخالف جميعًا، ورب شعاع نجى حائرًا في ظلمة وهداه. وأنا في خلال حيرتي الطويلة في قضية (الشعر الجاهلي)، ألتمس المخرج من التيه الذي وقعت فيه، لم أجد عاصمًا يعصمني من الغرق في المتناقضات المضللة، إلا تصحيح المبادئ خطوة خطوة، ودرجة درجة، لأن البناء على مبادئ غير محررة من الخطأ والإدعاء، وغير منقاة من الشوائب والأوهام، تنتهي بنا إلى نتائج مختلطة مبعثرة متضاربة، يعسر الجمع بينها في [مداخل إعجاز القرآن: 133] سياق واحد مفهوم أو مقبول وعلى هذا الأصل كانت سيرتي في دراسة ما بلغه علمي بقديم كتب علماء هذه الأمة، ثم في قراءة الحديث الذي كتب بلغة العرب أو بغير لغة العرب، أما القديم، على ما لقيت فيه من العنت والمشقة، فتحرير المبادئ وتنقيتها، كان أمرًا قريبًا من الميسور، لأن المتناقضات التي وقعت فيه، كان أكثرها نابعًا من أصل واحد واضح متفق عليه، فما زاغ عن هذا الأصل تناقض. وكشف مواطن الزيغ عن الأصل الواضح ممكن بالأناة والتوقف وتحرير المبادئ أما الحديث فالأمر فيه مختلف جدًا لأنه مبني على أصل مباين كل المباينة للأصل الذي بنى عليه القديم من كتب علماء هذه الأمة. فليس ما يلقاه المرء عندئذ عنتًا ومشقة، بل بلاءً ماحقًا مهلكًا لمن غفل عن منبع هذا الأصل، وعن الأثر الذي أحدثه في جمهرة المثقفين من أهل زماننا، في فهم كل ما يتعلق بالعرب ولغتهم وتاريخهم وآدابهم وعلومهم، بلا استثناء، وعلى اختلاف مناهج البحث فيها وفي كل فرع من فروعها الكثيرة المتشعبة المختلفة المقاصد والغايات. وقد كان مما كان أن حضارة العرب والمسلمين في القرن الحادي عشر الهجري، كانت تعاني ما تعانيه كل حضارة طال عليها الأمد فاسترخت قواها، ونجمت يومئذ حضارة جديدة كان من [مداخل إعجاز القرآن: 134] همها أن تصارعها، لأسباب تاريخية متنوعة. وكان منشأ هذه الحضارة الجديدة على أصلين متمكنين: أولهما، كتب العقيدة المتوارثة التي ينشأ عليها ناشئهم، وثانيهما، ما اتخذوه نسبًا ينتمون إليه، وهو قديم حضارة اليونان بتاريخها وعقائدها وآدابها، وهذا الأصلان مباينان، بلا ريب، كل المباينة لأصول حضارة العرب والمسلمين التي ننتمي نحن إليها هاهٍ ... وأفٍ لهذا القلم! لقد ساقني مساقًا بعيدًا! ولكن لا مناص، لأن هذا المدخل هو كما وصفته: (تاريخ حيرني، ثم اهتديت)، وهذا الكتاب نفسه هو كما قلت: (يقص قصة طويلة عريضة في صفحات قلائل، وبمنهجي في تحليل الكلام وتحليل التاريخ، لأنه المنهج الذي التزمته، فنجوت من شر مستطير، ومن بلاءٍ ماحق)، فلو أسقطت هذا الفصل، لأسقطت معه الصفة التي وصفت بها هذا الكتاب، ولباحث القصة التي أقصها. كان مما أجاءتني إليه محنتي بالشعر الجاهلي: أن أقرأ كل ما كان يتاح لي يومئذ أن أقرأه بالعربية وغير العربية عن هذا الإنسان الذي نحن بنوه، وعن أوليته، وعن انتشاره في الأرض، وعن عقائده، وعن حضارته المعرقة في القدم، وأكثر هذا شيء لم يكن لنا به كثير علم، والذي في كتبنا القديمة، أقوال وروايات [مداخل إعجاز القرآن: 135] مختلطة لا تغني. وقد فتح للأعاجم المحدثين فيه فتح جليل فكان لهم الفضل كل الفضل في التنقيب في الأرض، وفي كشف الغطاء عن كثير من الحضارات البائدة المطمورة تحت أطباق الزمن وفي جدف الثرى. كنت أرى أن متابعة هذه القراءة لا غنى لها عنها، حتى أستطيع أن أفسر لنفسي الحائرة هذا الإنسان الغامض الذي سكن جزيرة العرب قرونًا لا يعلمها إلا الله. وانحدر عن صلب إلى صلب، حتى جاء هذا (العربي الجاهلي) الذي أورثنا شعرًا فريدًا غريبًا متنوع النغم تنوعًا لا شبيه له في لغات الأرض، ولا ينقضي العجب من جريه النفاذ الأخاذ، في ستة عشر بحرًا، تنبثق من جميعها ضروب وأعاريض متباينة النغم، متداخلة اللحون = بل هذا الغنى الفياض والثراء الوافر من ألفاظ اللغة التي تجري على لسانه ممتدة الجذور شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا، كان لكل من الأمم التي نشأت حوله بحضارتها نصيبًا في لسانه، بلا كتاب مكتوب، ولا سجل ضابط، حتى قال الشافعي: (ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي)! = بل هذا الإحكام المذهل في بناء لغته وتراكيبها وتصاريفها وأساليبها المتشعبة ذات الحظ الباذخ من الدلالات المعبرة عن أخفى نبض القلوب والنفوس والعقول = بل هذه [مداخل إعجاز القرآن: 136] اليقظة العجيبة التي تميز بها هؤلاء الجاهليون، لكل ما يحيط بهم، فأودعوها شعرهم وبيانهم = بل في حدوث ذلك كله في بحر من الرمال والجبال والفيافي والأودية، قليلة قراه، متناثرة في غمرته مساكن الأحياء!! ثم لا نجد لهذا شبيهًا يقاربه أو يدانيه في بوادي هذه الأرض التي نسكنها! كيف تم لهم كل هذا الذي انفردوا به؟ وكم من القرون بعد القرون يمكن أن تكون قد تصرمت حتى يملك هذا الجاهلي الذي نعرفه، هذا القدر الذي بقى في أيدينا أقله، وتسقط مع أكثره من ذاكرة لا تكتب ولا تحب ولا تقيد، ومع ذلك فهو يفوق ما عند الكاتبين الحاسبين! أممكن أن يكون هذا كله قديم على هذا الوجه في مئة سنة؟ في مئتي سنة؟ في خمسمئة سنة؟ في ألف سنة؟! لا أظن، فمن أجل هذا حاولت أن ألتمس لنفسي تفسيرًا أقنع به وأستريح إليه. ولكن إدمان القراءة لم يزدني إلا حيرة، وسقطت في المسالك الوعرة، والأشواك المتشابكة، والظلمات المحيرة، ومزقتني الشكوك بأنيابها، واستحال علي أن أفهم تاريخ هذا الإنسان الذي أنا منه بنيته، وأن أقتنع بأنه كان في أوليته كما صورته لي هذه القراءة في الحديث المتجدد المستفيض، وكان ما كان! تصرفت بي الأيام والليالي طويلاً، وأنا ممزق بين ما تعلمته في مدارسنا [مداخل إعجاز القرآن: 137] صغيرًا. والذي قرأته أيضًا شابًا، وبين هذه الحقائق التي مثلها لي الشعر الجاهلي، والتي أخرجتني إلى طلب التفسير. وبعد لأي ما تبين لي الطريق والمنهج، وعندئذ سقطت الأقنعة عن الوجوه! فإذا كل قرأته عن أولية الإنسان في الأرض، وعن تاريخ الحضارات البائدة التي كان للأعاجم فضل الكشف عن آثارها، وعن حقيقة عقائد الأمم الخالية، وكثير غير ذلك = كان كله خاضعًا خضوعًا مستبينًا للأصلين الذي بنيت عليهما الحضارة الحديثة وعقلها وتفكيرها وأخلاقها، وتكشفت لي أيضًا حقيقة أخرى: أن للأهداف السياسية أثرًا عميقًا جدًا في جذور هذه الحضارة يتغلغل موجها لكل ما يكتب، عن عمد أو عن غير عمد. ولكي يكون الأمر واضحًا ينبغي أن أحدد موضع الفصل الذي جعلني أرفض أن أسير في الطريق الذي ألزمتنا بالسير فيه غلبة السلطان الثقافي والسياسي لهذه الحضارة، وسيطرتها على كل الميادين بلا استثناء وهي قصة طويلة، ولكني سأوجز القول فيها ما استطعت. ومن العجز أن نتوهم، كما هو شائع بيننا اليوم، إن الأمر كله جاء عفوا بلا قصد ولا تدبير، وإنه مستمر إلى هذا اليوم بلا قصد ولا تدبير، وإن هذه هي (طبيعة الأشياء): مجرد التقاء حضارتين في زمن واحد، إحداهما حديثة رائعة متحركة، قد [مداخل إعجاز القرآن: 138] أحكمت سيطرتها على مفاتيح العلم والمعرفة، حتى بلغت ما بلغت، والأخرى قديمة كانت ذات تراث رائع، ثم طال عليها الأمد فاستبقت قواها وهمدت وغفت، فلما التقتا هب الغافل الهامد من غفوته، ورأى ما بلغه هذا اليقظ المتحرك، فلم يجد بدا من أن يأخذ مأخذه، ويتعلم منه ما فاته وجهله في زمان غفوته، ولم يجده عيبا يعاب أن يسند إلى أخيه أمر تعليمه وتيقنه حتى يلحق به ويدركه، وحتى يحكم هو أيضًا سيطرته على مفاتيح العلم والمعرفة فيبلغ ما بلغ، وتستوي الأقدام في حضارة واحدة رائعة!! وهذا السياق ليس عجزًا فحسب، بل هو عبثُ عابثٍ لا يدري ما يفعل ولا ما يقول، ويكفي أن ننظر نظرة واحدة، فقط مضى قرنان كاملان، سيطرت فيهما هذه الحضارة الحديثة عليها، وعلى أكبر جزء من آسيا وعلى أفريقيا كاملة، وبقيت هذه الأمم جميعًا في قبضتها تعلمها وتثقفها!! ومع ذلك فقد بقي الفرق بيننا جميعًا وبينهم هو نفس الفرق الذي كان منذ أول يوم تم فيه اللقاء بيننا وبينهم نسبة محفوظة وستظل محفوظة، فإذا لم يكن هذا عن تدبير وقصد، يعني أي شيء غيرها يكون؟ ما لم نفق إفاقة صحيحة مدركة لهذا التناقض الصريح بين مواريثنا التي ينبغي أن نبي عليها ثقافتنا وعلمنا، وبين مواريثهم التي بنوا عليها علمهم وثقافتهم. فإذا فعلنا وتبينت جماهير الأمم موضع الفصل الذي [مداخل إعجاز القرآن: 139] يفصل بيننا وبين ما تروجه فينا بقصد وتدبير، تحت بهرج لا يناظر بالضعف به وأن حضارتهم (الحضارة العالمية) وأن ثقافتهم (الثقافة الإنسانية). ثم نصدق ذلك نحن كأنه حقيقة لا تقبل النقض ولا الجدال(1)). [مداخل إعجاز القرآن: 133-140] قال أبو فهر محمود بن محمد شاكر الحسيني (ت: 1418هـ): (المدخل الثاني تذوق راعني حتى تذوقت). [مداخل إعجاز القرآن: 141] ___________________________________________ (1) إلى هنا انتهى ما وصل إلينا من أصول المدخل الأول كما كتبها الأستاذ شاكر رحمه الله بخطه ولم يكمله.
__________________
|
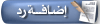 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |