|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
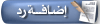 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
مقدمة تحقيق كتاب الشريعة للآجري بقلم العلامة الشيخ العلامة / محمد حامد الفقي الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وَصَّى به نوحًا، والذي أَوحَى إلى عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين، وما وصَّي به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه، وأقام هذه الشريعة السمحة على أساس توحيد العبادة وتوحيد الطاعة: أن نكفر ونبرأ من كلِّ مألوهٍ سوى الله، ونخلص عبادتنا، ونجرد ديننا علمًا واعتقادًا وعملًا وحكمًا لله وحده، وأن نبرأ وننزه أنفسنا من كل عبادة بالأهواء والآراء والوراثة عن الشيوخ والآباء، وأن نجعل السلطان النافذ على قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا لما جاءنا به عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، وخيرته من عباده محمد إمام المهتدين وخاتم الأنبياء والمرسلين، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأعلمَنا ربنا الكريم سبحانه: أنه يكبر على المشركين انقطاعنا عنهم وعن دين آبائهم وشيوخهم بتوثيق صلات قلوبنا بهذه الشريعة المحكمة، والملة القيمة، واختيارنا لها دينًا قيمًا، لأنها ملة إبراهيم حنيفًا. ويكبر على المشركين دعوتنا لهم إليها، ومحاربتنا لهم عليها، فهم لا بد محاولون بكل ما أوتوا من قوة وبكل ما مكَّن الشيطان من نفوسهم وقلوبهم، وبكل ما ملك من زمامهم، وامتطى من أقفيتهم - محاولون بكل ذلك - أن يصرفوا المؤمنين عنها، وجاهدون بما يوحي إليهم شياطين الجن والإنس من زخرف القول، وما يعلمهم من ألوان الكيد والمكر: أن يبذروا بذور الجاهلية الخبيثة في حقل القلوب، وينفثوا سمومهم القتالة في النفوس التي تصغي إليهم بغفلتها عن آيات الله الكونية، وإعراضها عن هدي الكتاب المبين ونوره المشرق أبدًا، والتهاون في تحري اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وبأصحابه المهتدين. فإذا ما غفلوا هذه الغفلة، وأعرضوا هذا الإعراض، واستهانوا هذه الاستهانة فتحوا لأولئك الشياطين أبوابًا في نفوسهم. فتسربوا إليها مسرعين، وأخذوا يقتلون فيها جند الإيمان، و يمزقون عنها دروع التقوى، و يحتلون حصون القلوب حصنًا حصنًا، فإذا تمَّ لهم هذا أصبحوا هم المستعمرين للنفوس والقلوب فملئوها بسموم البدع الوثنية، والخرافات الجاهلية، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقالوا في الله وفي أسمائه وصفاته، وفي شرائعه ودينه بغير علم، وجادلوا في الله بغير هدى ولا كتاب منير، وفرقوا دينهم شيعًا وأحزابًا كل حزب بما لديهم فرحون، ولبَّس عليهم شياطين الإنس والجن حتى ظنوا أنفسهم - بهذه الخرافات والبدع والتفرق والجاهلية - مسلمين. وما لهم من الإسلام إلا الاسم والدعوي، وأما حقيقته: فعقائدهم وأعمالهم وحكمهم وتعبداتهم وأخلاقهم ومجتمعهم ينادي بأنهم ألد عداوة للإسلام الذي أكمله الله، وأتم به النعمة وارتضاه لعباده دينًا. وعادوا مهطعين وراء الشياطين. كما كان شأن الأولين، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلًا. ومازال ذلك يتطاول بهم حتى زين لهم شياطين الإنس والجن ضلال وإفساد الوثنيين واليهود والنصارى باسم القوانين والنظم السياسية، فاتخذوها لهم دينا جديدًا وحكموها في الفروج والأموال والدماء، وكان ذلك هو حبل المشنقة للأمم المنتسبة للإسلام، فقبضت الفرنجة به على أعناقهم، وأعملت فيهم مخالبها وأنيابها تمزيقًا حتى عادوا أشلاء تتغدى بهذه وتتعشي بتلك. حتى أصبحوا كالقصعة تكالبت عليها الجياع، وأضحوا أمرهم فرطًا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اللهم اهد قومي، وردهم يا رب إلى صراطك المستقيم، وأرجعهم إلى سبيل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قلت له: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108] وأمرته أن يقول: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 153]. ويكشف لنا عن حال المجتمع الإسلامي فيما وصل إليه، وما بلغ به عدوه، ويصور ما به من التدهور والبعد عن صراطه المستقيم: ما كتبه الإمام الحافظ محمد بن عثمان الذهبي (المتوفي سنة 748ه) فيما كتب في ذيل الطبقات السادسة والثامنة والتاسعة من كتابه الجليل «طبقات الحفاظ»؛ قال - رحمه الله - في ذيل الطبقة السادسة: «فلما قُتل الأمين، واستخلف المأمون على رأس المائتين: نجم التشيع وأبدى صفحته، وبزغ فجر الكلام، وغلبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان، وعمل رصد الكواكب، ونشأ للناس علم جديد مُردٍ مُهلك، لا يلائم علم النبوة، ولا يوافق توحيد المؤمنين، قد كانت الأمة منه في عافية، وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة. وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن، ودعاهم إليه، وامتحن العلماء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. من البلاء: أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وأن تُقدَّم عقول الفلاسفة، ويعزل منقول اتباع الرسل، ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة. فالفرار الفرار قبل حلول الدمار. وإياك ومضلات الأهواء، ومَحاراة العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم». وقال في ذيل الطبقة الثامنة المنتهية بموت الحافظ أبي التقى هشام بن عبدالملك اليزني سنة إحدى وخمسين ومائتين: «فقد تقالَّ أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبذل الناس بطلبته: يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم. وصار علماء العصر - في الغالب - عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل، وآراء المتكلمين، من غير أن يعقلوا أكثرها. فعم البلاء، واستفحلت الأهواء، ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضة من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه، وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكي على زمانه، وأدمن النظر في الصحيح، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم». وقال في ذيل الطبقة التاسعة المنتهية بوفاة الإمام الحافظ أبي محمد الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي المتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين: «كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة، وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول، وأعرضوا عما سلف من التمسك بالآثار النبوية. وظهر في الفقهاء التقليد، وتناقص الاجتهاد. فسبحان من له الخلق والأمر. فبالله عليك يا شيخ، ارفق بنفسك، والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء - يعنى الحفاظ - النظر الشزر، ولا ترمقهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا. فما فيمن سميت أحد - ولله الحمد - إلا وهو بصير بالدين، عالم بسبيل النجاة. وليس الحجة في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة. فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال، إن أعوزك المقال: من أحمد؟ ومن ابن المديني؟ وأي شيء أبو زرعة، وأبو داود؟ هؤلاء محدثون، ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان. والمنطق، ولا يعرفون الله تعالى بالدليل، ولا هم من فقهاء الملة. فاسكت بحلمٍ، أو انطق بعلم. فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث. فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. فمن اتقي الله راقب الله واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه وبالجهل، أو بالشر فأعرض عنه، وذره في غيه، فعقباه وبال. نسأل الله العفو والعافية والسلامة». اهـ أما بعد: فهذا كتاب «الشريعة في السَّنَّةِ» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، من أعيان القرن الرابع الهجري، ألفه حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة، والآراء الفاسدة، وتقديمها في العقيدة والعبادة على الوحيين، لأنهم دانوا بالتقليد الأعمى، وعطلوا عقولهم وأفهامهم، وحرموا عليها أن تتفقه في كتاب الله، ومنعوها أن تستضيء بمشكاة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فراجت سوق الفلسفة الفارسية واليونانية. وأصبح نفوذها غالبًا على كل من أراد الظهور والبروز في المجتمع، وقابلها من الناحية الأخرى صوفية الهند والفرس واليونان، يتبارى، بها كذلك من يريد الظهور بالعبادة والصلاح والتقوى، وضمن جانب الحق والهدي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور، فقل أنصاره، وكاد الزمام يفلت من أيديهم. وكان كل من الطائفتين حريصًا أن يجذب إليه نصوص الوحيين كارهةً، بألوان من التحريف والتبدیل، ليستميل إليه العامة، ويتقي طعنات أنصار الوحيين من العلماء السلفيين، حتى اختلط الأمر على الجمهور أيما اختلاط، والتبس الحق بالباطل على الجمهرة، بل وعلى بعض من يتزعمون حركة الإصلاح، ويجاهدون لإرجاع الوحيين إلى سلطانهما على القلوب، كما كان في القرون الفاضلة، قبل أن تغزو الفلسفة والصوفية المجتمع الإسلامي وعقائده القرآنية الصحيحة، وقبل أن تسلط شكوكها وريبها وزيغها وإلحادها في أثواب مزخرفة من القول، على ألسنة شياطين الإنس والجن من أعداء الأنبياء، ومكن لذلك غفلة الحكام، والتواء عقولهم وانحرافها عن الجادة، بغلبة شهوات البطون والفروج عليهم، وانهماكهم في الملاذ واللهو واللعب، واشتعال نيران العداوة بينهم، مما ولد التنافس على الملك. والحرص على متع الحياة وملاذها البهيمية، كل ذلك وغيره مما أبعد الناس عن الصراط السوي الذي يسألون ربهم الهداية إليه في صلاتهم، ويكررون السؤال في كل ركعة حين يقرءون فاتحة الكتاب، ولا يستجيب الله العليم الحكيم سؤالهم، لأنهم يسألونه في غفلة وتقليد أعمى وغرور، إذ يزعمون أنهم المسلمون الذين ينالون ما يريدون مجرد الدعاء في الصلاة، وإن كانوا يعملون بكل قواهم جاهدين الهدم هذا الدعاء وإن كانوا يصرون في عناد على أن يكونوا بهذا التقليد الأعمى من الضالين الشاقين لله ورسوله، والمتبعين لغير سبيل المؤمنين وهم يحسبون أنفسهم من المحسنين. أحزن ذلك الإمام أبا بكر الآجري وغيره من أئمة العصر، فقام يدعو الناس في كتابه « الشريعة » إلى الرجوع إلى السبيل القويم، والاهتداء بهدي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبهدي عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء، و إمام المهتدين صلى الله عليه وسلم، الذي ضمن الله الفلاح وعزة الدنيا والآخرة لمن اهتدى بهداه. وتوعد - وهو الذي لا يخلف الميعاد - من اتبع غير سبيله، وخالف عن أمره إصابة الفتنة والعذاب الأليم. فلذلك قام بناء كتاب « الشريعة » على ثلاث أسس: أولها: التحذير من التفرق في الدين، والحرص على الجماعة، لأن المجتمع لا يهنأ بالعيش الرغد، والحياة الطيبة إلا بتعاون أفراده على البر والتقوى، ولن يكون ذلك إلا بحسن الفهم والتقدير لنعم الله وآلائه عليهم، وآياته الكونية في أنفسهم وفي الآفاق، وشكرها حق شكرها، بوضعها موضعها، والانتفاع بها، والاستفادة منها، إيمانًا بأنها من الرب الرحيم العليم الحكيم، يعطيهم إياها بعدله وحكمته ورحمته، ليربيهم وينميهم بها، فيرتفعوا على درجات شكرها إلى منازل السمو والكرامة والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة، فاذا هم عرفوا ذلك وقدروه قدره لم يكن ثم خلاف يمزق وحدتهم، ويباعد الشقة بينهم، بل يردون خلافهم إلى الله ورسوله وكتابه، فتعود القلوب صافية، وترجع النفوس زاكية، وتؤوب الأخوة الصادقة، والتعاون على البر والتقوى، والنصيحة الرحيمة، و يأخذون سبيلهم في الحياة هداة مهتدين. ثانيها: معرفة الله معرفة تثمر في القلب إجلال الله وإكباره، ليعطيه حقه من إخلاص العبادة بمنتهى الذل ومنتهي الحب، رغبة ورهبة، وذلك لن يكون إلا بمعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه سبحانه بها ووصفه بها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن على هذه المعرفة تتوقف حياة القلب وعافيته، إذ هي غذاؤه الذي لا غذاء غيرها ينفعه ويحييه. فيعتمد على الله وحده، ويثق به ويصدق قوله، وينفذ حكمه، ويستسلم وينقاد لشرائعه. والله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، ولا ينهى إلا عن الفحشاء والمنكر. ويحب المتقين والمحسنين. ولا يرضى لعباده الكفر.. فإذا ما تحقق هذا بمعناه الذي أحبه الله وارتضاه لعباده كانوا موحدين في عقيدتهم وعبادتهم وأعمالهم وشئونهم. وكان هذا التوحيد هو الذي يوحد بين قلوبهم ومصالحهم، وسبيلهم واتجاههم لأن الكل يرجو وجه الله ويبتغي مرضاته، ويؤمن أن الخير كله بيده، وأنه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فيحفزهم هذا إلى التعاون على البر والتقوى، ويجعل بينهم وبين الإثم والعدوان حاجزًا من خشية الله والحرص على مرضاته في أنفسهم فيؤتيهم الله بكل ذلك الحكمة والرشد. وهي أقوى وازعًا وأنفذ سلطانًا من أي سلطان خارج عن روح الإنسان وقلبه. ثالثها: معرفة الرسول معرفة تثمر في القلب حبه وتعظيمه على كل الخلق، وتقديم طاعته وهديه على طاعة كل أحد وهديه من الناس، وهذه المعرفة لن تكون على وجهها، فتؤتي ثمرتها إلا إذا كانت مستقاة من منابع العلم الصحيح الصافية: من كتاب الله، الذي تقول عائشة رضي الله عنها - حين سألها سعد بن هشام رضي الله عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقالت: «كان خلقه القرآن» تعني كل شأنه وسيرته وهديه وأخلاقه القرآن. والمنبع الثاني لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح الأحاديث من البخاري ومسلم وأشباههما ممن يعتني بالصحيح ويتحراه، ويتجنب الواهي، ولا يروجه ولا يرضاه. وبهذه المعرفة الصحيحة ينصبغ القلب بحب الرسول وتعظيمه وتوقيره، فيتحرى في سلوكه إلى ربه سبيل هذا الرسول، ويأتسي به، ويكون من المؤمنين الذين ﴿ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51] فيسعد في حياته بالعيش الطيب، ويسعد به مجتمعه. ويحقق الله لهم وعده، الذي يقول فيه: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: 55]. هذا - وقد كان ينبغي للشيخ الإمام أبي بكر الآجري، غفر الله لنا وله - حيث قد سمى كتابه «الشريعة » - أن يتحرى في ذلك الأحاديث الصحيحة ليتجنب ما كرهه هو وحذره على الأمة من البدع والخرافات، التي ما راجت إلا بالآثار الواهية والقصص الإسرائيلية والأحاديث الضعيفة، لكنه – عفا الله عنا وعنه - قد ساق في الكتاب، وبالأخص في باب بدء نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث واهيات، وساق عن كعب الأحبار وأشباهه ما كان داء الأمة ووهنها من أمثاله، لكنه يغمر في بحر على هذا الإمام الجليل، رحمنا الله، وغفر لنا وله. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حرصت جهدي أن أبين ما في سند الأحاديث من جرح وتعديل. وإن كنت أعتقد أني لست من رجال هذا الميدان، فالله وحده المستعان. ونسخة أصل كتاب « الشريعة » اشتريته من الصديق القديم، الذي جمعتني و إياه السلفية من سنين طويلة، وطالما نفعني الله بمجالسه ومعارفه. هو الأخ المحقق الفاضل الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة المدرس بالمسجد الحرام، والعضو والمدرس بدار الحديث بمكة المكرمة، ولقد كان به ضنينًا، فلم تسمح نفسه ببيعه إلا بعد أخذ الشرط عليَّ بطبعه ونشره ليعم نفع الناس به. وإنِّى لم آخذه وأحرص على شرائه إلا رغبة في نشر آثار السلف، لأني بذلك كلِفٌ، وأود لو أطال الله عمري ووفقني ربي لنشرها جميعها، لأن المتأخرين لم تَعُج بهم الطريق، إلا لجهلهم بآثار سلفهم. فحرموا القدوة الحسنة وذهبوا يتخذون من نصارى الفرنجة ويهودهم وملحديهم وزنادقتهم وفساقهم قدوة لهم خابوا وخسروا. ونسخة الأصل بها خروم نبهنا عليها في مواضعها، وبها نقص في آخرها ذهب معه تاريخ كتابتها، وهي تقع في (564) صفحة من قطع الربع في كل صفحة ۱۷ سطرًا بخط يغلب على الظن أنه في القرن الثاني عشر الهجري، لكنها على الإهمال تعتبر نسخة جيدة في بابها، لأنها كانت في ملك أخي وصديقي الشيخ عبد الرحمن الجلاجل من أفاضل طلبة العلم النجديين ببريدة من بلاد القصيم. وكان هذا الشيخ - رحمه الله - كثير الاشتغال بطلب العلم، وبالأخص الكتب الخطية، وكان كذلك يشتغل بالنسخ والتصحيح، ويقدم لإخوانه هدايا من منقولاته رغبة منه في نشر الكتب السلفية، وحرصًا منه على حفظها فلذلك كانت نسخة الشريعة هذه جيدة، إن شاء الله وعليها تعليقات لغوية وتصحيحات يغلب على ظني أنها بخط الشيخ عبد الرحمن الجلاجل رحمه الله. ولقد حرصت على العثور على نسخة أخرى، فبحثت في مكاتب مصر، وسألت طلبة العلم النجديين وإخواننا الشوام. فما وجدت عند أحد منهم نسخة أخرى. وها أنا أقدم هذه الطبعة - على ما بها - لطلبة العلم، معتذرًا بهذه الظروف عما فيها من النقص، وعسى أن تكون سبيلا إلى الحصول على نسخة أخرى يتم بها النقص، ويدقق عليها التصحيح، ونتدارك ذلك في الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصدر: مقدمة تحقيق كتاب «الشريعة» للآجري، بقلم الشيخ محمد حامد الفقي، 1950م
__________________
|
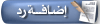 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |