|
|||||||
| ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم |
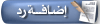 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
تفسير سورة التوبة (الحلقة التاسعة) مصارع المنافقين في قلوبهم وألسنتهم وأيديهم الشيخ عبدالكريم مطيع الحمداوي بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ * وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ * لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ * يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ * الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: 55 - 68]. بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمره في أمة يغلب على أرضها الجفاف وندرة الخصب، لا تكاد مكاسب أهلها تتجاوز الرعي والتجارة، فنشأت فيهم أسر تجارية موسرة غنية على رأسها عتاة متجبرون مثل أبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف، وأسر متوسطة أو فقيرة مستضعفة نصرت دعوة الإسلام وأوذيت في سبيله، وأمرت بالصبر على الأذى وكف الأيدي بقوله تعالى: ﴿ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النساء: 77]، فلما هاجروا إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم جردتهم قريش من أموالهم فآزرهم الأنصار بما استطاعوه، ثم عندما اشتدت وطأة الكفار عليهم وحشدت قريش لحربهم أذن لهم الحق تعالى بالدفاع عن أنفسهم بقوله عز وجل: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: 39، 40]، إلا أن للقتال حاجاته تمويلًا وتسليحًا وأدوات وإعدادًا، وهم أضعف من أن يوفروها، وليس لديهم إلا أسلحتهم الفردية وقليل من الطعام هو قوت أهلهم وذريتهم؛ لذلك مَنَّ الله عليهم بإباحة غنائم الحرب، وقال عز وجل: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: 69]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري))، وقال في حديث طويل: ((وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي))، وكانت بذلك الغنائم من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والرسل، بعدما كانت من قبل لدى من سبقه من الأنبياء تُجمَع فتحرقها النار. وبدأ العمل بهذا التشريع الجديد في سَرِيَّة عبدالله بن جحش إلى نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة؛ إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخميس غنيمته، ثم نزل تشريعها مفصلًا وقرآنيًّا في سورة الأنفال عقب غزوة بدر بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: 41]، ومع توالي الغزوات والسرايا تغيَّر الوضع الاقتصادي لدى المسلمين، نَمَّـى بعضهم مكاسبه ولم يتخلَّف عن الجهاد، فاغتنى وأدَّى الحقوق زكاةً وصدقةً وبرًّا، مثل عبدالرحمن بن عوف الذي قسمت تركته من الذهب بالفؤوس، وأنفق غيره مكاسبه في أوجه البر محتفظًا منها بضرورات حاجته متفرغًا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو ذرٍّ؛ إذ لم تجد زوجته كفنًا له عند وفاته، وعلي بن أبي طالب؛ إذ لم يترك عند استشهاده إلا أرضًا في ينبع وقفها للفقراء عامة وفيهم فقراء بني هاشم، وفُتِن آخرون بالجمع والادخار فتضاعفت أموالهم وتفرغوا لتنميتها، وتكاثر أبناؤهم فتعلقوا بهم، وامتنعوا عن أداء حقوق الأموال زكاة وصدقة وإنفاقًا على الجهاد أو مشاركة فيه، وكونوا مع بعض مسلمة الفتح من العتقاء والطلقاء تكتلًا غايته إضعاف الصف وفتنته، لا سيما وفي الصف سماعون لهم من الأقارب والسذج وبسطاء الإدراك والفهم، من الذين يمثلون في كل عصر وكل مجتمع بَشريٍّ أشدَّ نقاط ضعفه، وأشار إليهم الحق تعالى بقوله: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: 47]، وقوله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: 41]، ثم تترسوا بالنفاق كذبًا وتمويهًا ومراوغةً وتلبيسًا يدارون به عن أنفسهم، وأصبح حالهم بكثرة أموالهم وأبنائهم وفتنة المعجبين بهم من قصار النظر ضعاف الفكر والإيمان كحال قوم قارون إذ خرج عليهم في زينته فانبهروا بها وقال الذين يريدون الحياة الدنيا منهم: ﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [القصص: 79]. لذلك شنت سورة التوبة على هذه الظواهر السلبية من الضعف في المجتمع المسلم حملات كشف لها وترشيد لأهلها، فقال تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: 55]، والآية بما تضمنه معناها امتداد وزيادة توضيح وشرح لما قبلها من قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: 53، 54]؛ إذ بين الحق تعالى في هذه الآيات الكريمة أن النفاق مفسد للدين والدنيا وجالب لآفاتهما، وأنه يحبط أعمال البر كلها، زكوات وصدقات وغيرها، وأن ليس للمنافقين فيها من أجر في الآخرة، وأن مكاسب المنافقين من المال والبنين في حقيقتها مجرد أسباب لشقائهم، فقال عز وجل: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: 55]. وأشار تعالى في هذه الآية إلى نماذج من المنافقين سألوا الغنى وشَقُوا به وفعل الإعجاب في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ [التوبة: 55] من العين والجيم والباء، أصلان في اللغة أولهما العَجْب بفتح العين وسكون الجيم، وهو ما ينضم عليه الوركان من أصل الذيل في الدابة وفي آخر فقرة أسفل العمود الفقري للإنسان وقال عنه صلى الله عليه وسلم: ((كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْب الذنب، منه خلق ومنه يركب)، والثاني العَجَب والعُجْب وهو شعور المرء إِذا ورد عليه ما يستحسنه أو رأَى مَا يندر اعتياده أو يعظم فعله فيستحمده أو ينكره، يقال: عَجِبَ مِنْهُ يَعْجَبُ عَجَبًا، وتَعَجَّبَ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ...إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: 4، 5] يقال أُعْجِبَ بالشيء وعَجَّبَه تَعْجِيبًا: حمله على التَّعَجُّبِ مِنْهُ. وَشَيْءٌ مُعْجِبٌ إِذا كَانَ حَسَنًا جِدًّا أو نادرًا جدًّا، والتَّعَجُّبُ: أَن تَرَى الشيءَ يُعْجِبُكَ وتُسَرُّ به، أو تَظُنُّ أَنك لَمْ تَرَ مِثلَه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ [التوبة: 55]؛ أي: لا تستعظم كثرة أموال المنافقين وأولادهم، فتعجبك أفعالهم ومكاسبهم، وتفتن بهم عن دينك، وتظن أنْ قد صفت لهم مكاسب الدنيا ويغفر الله لهم إثمها في الآخرة، فيستدرجك الشيطان لتقليدهم وفعل فعلهم، والخطاب في الآية موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لتبليغه إلى الأمة، يراد به تعليمُها ببيان حال المنافقين ومآلهم ظاهرًا وباطنًا، كما في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 26]، وحمايتُها من الإعجاب والاغترار بما يبدو من ظاهر المنافقين كثرةَ أموال وبنين ونسيانًا للآخرة والعمل لها، لا سيما والعادة السارية بين العوام والبسطاء أن كثرة الأموال والأولاد تكسب المرء من الجاه والمكانة والسعادة ما يجعل محدودي النظر يغارون منه أو يحسدونه أو ينافسونه أو يقلدونه ويتمنون مكانته فيختل إيمانهم. لذلك تدارك الله تعالى برحمته وهدايته من قد يفتن بثروة المنافقين وكثرة ذريتهم، فبين لهم أن المال والذرية ليسا أداة للسعادة في الدنيا أو في الآخرة، بل قد يكونان مجلبة للشقاء والضنك وسوء المصير، فقال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [التوبة: 55]، وزهوق النفس في هذه الآية يعني ميتة السوء، من "زهَقَ" الشيءُ يَزْهَقُ زُهوقًا، فَهُوَ زاهِقٌ وزَهوقٌ؛ أي: بطَل وهلَك واضْمَحَلَّ، يقال: زهَقَ الباطلُ إِذَا غَلَبَه الْحَقُّ، وَقَدْ زاهَقَ الحقُّ الباطلَ؛ أي: غالبه وقضى عليه، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: 18]، أي: فإذا هو باطل أو هالك، وقد عبر الوحي الكريم عن ميتة السوء المقدرة للمنافقين بالزهوق، وهو خروج الروح بشدة وضيق، لما فيه من عذاب وشقاء عند خروجها من الجسد؛ أي: إنما يريد الله بما يمده للكفار والمنافقين من المال والبنين أن يعذبهم به في الدنيا بهموم تدبير الأموال ربحًا وخسارةً فيها وتعلقًا وانشغالًا بها عن عبادة الله وفعل الخيرات، وعند مغادرتهم الحياة بما يسلطه الله عليهم من آلام الموت وأوجاعه وزهوق أرواحهم من أجسادهم بشدة، ورعب من الإقبال على الآخرة بغير إيمان أضمروه أو عمل صالح مقبول قدموه ﴿ وَهُمْ ﴾؛ أي: المنافقون ﴿ كَافِرُونَ ﴾ على حالة الكفر المؤدي بهم إلى نار جهنم خالدين فيها، فلا يعجبك أيها المؤمن ظاهر أحوالهم ولا تطمح نفسك إلى تقليدهم ومنافستهم أو السعي لما يسعون أو العمل بما يعملون، فإن كثرة أولادهم وأموالهم لا تجلب لهم أي سعادة، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وإنما هي سبب شقاء لهم في حالهم ومآلهم بانشغالهم عن البر والعبادة والعمل الصالح، وامتلاء قلوبهم بالجزع والهم لما جمعوه وأنجبوه، واختتام حياتهم بموت على الكفر. والآية صريحة في تكفير المنافقين والتحذير من الإعجاب بأفعالهم وما اكتسبوه، وفي حث المؤمنين على الزهد والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها وفتنتها، بدئت لتأكيد معانيها بأداة "إن" المشبهة بالفعل، والمقرونة بـ"ما" الكافة، وجعلها عذابَ المنافقين أمرًا من الله لازبًا، وزهوقَ أنفسهم عند الموت على الكفر قرارًا مقضيًّا، وبيانَ أن ذلك كله مراد له تعالى بقوله عز وجل: ﴿ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 55]؛ أي: يريد الله أن يعذبهم بها، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: 85]، والفعل المضارع في: ﴿ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ منصوب بأن المضمرة في لام التعليل، أو لام "أَنْ" كما يسميها بعض القُرَّاء، والجملة الفعلية من "أنْ والفعل وما في حيزهما" مفعول: "يريد". وإذ فضحهم الله تعالى وكشف حقيقة نفاقهم وخطرهم على الأمة، أخذوا يجادلون عن أنفسهم لدفع ما وُصِموا به بأساليب شيطانية متنوعة، مرة يتلصَّقون بالصف المسلم ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ﴾ [التوبة: 56]، وفعل يحلفون بصيغة المضارع للدلالة على مواظبتهم على الحلف؛ أي: ويقسمون لكم بالله دائمًا أنهم مسلمون منكم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ﴿ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ﴾ [التوبة: 56]، والواو في الآية للحال؛ أي: وحالة ما يضمرونه أنهم ليسوا منكم ولا يعدون أنفسهم منكم ولا معكم في السعي لنصرة الدين وتحمل تكاليفه، ولا يؤمنون بأن عليهم ما عليكم من الواجبات، ولكم ما لهم من الحقوق، ومثلهم في هذا كمثل نوح عليه السلام مع ابنه في قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود: 46]، ثم عقب عز وجل ببيان ما أدى بهم إلى الحلف الكاذب بقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ [التوبة: 56]؛ أي: يفرقون منكم، من الفعل: فرِقَ يفرَق فرَقًا من الشيء، إذا خافه خوفًا شديدًا، على زنة سئم يسأم، وَرَدَ على صيغ المضارع في قوله تعالى: ﴿ يَفْرَقُونَ ﴾، للدلالة على دوام فرقهم وتجدده في أنفسهم؛ أي: ولكن ما يبدونه لكم من الولاء الكاذب والمودة المزيفة سببه الخوف الدائم المتجدد من سيوفكم وأنتم في حالة من القوة والنصر، إنهم من شدة رعبهم يكادون أن يفروا منكم ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: 57]، والمَلْجَأ لغة هو الحِصْن يتحصنون به وفيه، والمَهْرب يفرون إليه، على وزن "مَفْعَل" ظرف زمان، وظرف مكان. من فعل: لَجَأ يلجأ إلى الشيء؛ أي: انحاز إليه، وألجَأتُهُ إلى كذا؛ أي: اضطررته إليه فالتَجَأ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: 118]، والمغارات: جمع "مغارة" وهي الكهوف في الجبال والبراري التي تأوي إليها الحيوانات الضارية وقطاع الطرق والمنبوذون من المجتمع، والمُدَّخَل: أصله: مُتْدَخَل، على زنة "مفتعل" اسم مكان للإدخال من الدخول، وقلبت التاء فيه دالًا وأدغمت في الدال الأصلية؛ أي: الجحر الضيق أو الثقب يُدخَل فيه بصعوبة، أو النفق كنفق اليربوع، بذلك قرأه الجمهور، وقرأه يعقوب وحده "مُدْخَلًا" بضم الميم وسكون الدال؛ أي: دخولًا، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31]؛ أي: لو وجدوا مهربًا من خطر انكشاف نفاقهم بين المسلمين ﴿ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: 57]، لفروا إليه مدبرين خوفًا منكم ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾، كالفرس الجامح، والجموح من فعل "جمح" وهو ذهاب الشيء قدمًا بغلبة وعنف، فيقال: جَمَحَ الفرسُ بِصَاحِبِهِ جَمْحًا وجِماحًا وجموحًا: ذَهَبَ يَجْرِي جَرْيًا غَالِبًا فارسَه غير منضبط بلجامه، وجمح به الخيال أو الهوى إذا ضل أو غوى، والرجل الجَموح الراكب هواه، والمرأة الجَموح التي تجمح جِماحًا مِنْ زَوْجِهَا وتخرج من البيت عصية عليه قبل أن يطلقها؛ أي: إن المنافقين من خوفهم انكشاف أمرهم يكادون يجمحون إلى أي مكان آمن يقيهم بطش المؤمنين، سواء كان هذا الملجأ حصنًا أو كهفًا أو غارًا أو نفقًا أو ثقبًا أو جحرًا في جبل. ومرة يتصنعون الحرصَ على أحكام الدين، والتشدُّد فيها، والمزايدة على الرسول صلى الله عليه وسلم بها، بإلحاح فظ غليظ وإساءة أدب وقحة، من أجل التمويه على نفاقهم، أو أخذ نصيب لا يستحقونه من الصدقات أو الغنائم، وليس لهم من هم إلا الطمع والمراءات بالتشدد سترًا لنفاقهم، أو اللمز في ذمته صلى الله عليه وسلم، فينزل فيهم قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة: 58]، واللمز لغة من لمز يلمز، من باب ضرب يضرب، وبه قرأ الجمهور، ومن باب: نصر ينصر، وبه قرأ يعقوب وحده، وهو كلمة واحدة معناها العيب، كالغمز والإشارة بالعين تعيب بها غريمك بحق أو باطل، ومنه: الهُمَزَة اللُّمَزَة الذي يغتاب الناس ويحط من قدرهم، قال الفراء: الهمز واللمز والمرز واللقس العيب، واللمز في الصدقات أن المنافقين كانوا ينتظرون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤثرهم بأكثر مما يستحقونه شرعًا، أو يعطيهم وهم ليسوا من مصارفها، وهو صلى الله عليه وسلم كان صارمًا في تحري العدالة عند توزيع الصدقات زكاة وغيرها، فإذا لم يعط أحدهم عابه واغتابه، من ذلك ما أخرجه البخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حَاتِم وأبو الشيخ وابن مردويه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنه قال: "بَيْنَمَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقسم قسمًا إِذْ جَاءَهُ ذُو الْخوَيْصِرَة التَّمِيمِي فَقَالَ: "اعْدِلْ يَا رَسُول الله"، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَيلك وَمَنِ الْعدْلُ إِذا لم أعدل؟..الحديث))، وَما أخرجه سنيد وَابْن جرير عَن دَاوُد بن أبي عَاصِم قَالَ: أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِصَدقَة فَقَسمهَا هَهُنَا وَهَهُنَا حَتَّى ذهبت، وَرَآهُ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ: "مَا هَذَا بِالْعَدْلِ" فَنزلت هَذِه الْآيَة: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: 58]؛ أي: يعيبك سرًّا بطريقة قسمك للصدقات بين ذوي الحاجات، وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالْبَغوِيّ فِي مُعْجَمه وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي قَالَ: قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، "أَعْطِنِي من الصَّدَقَة"، فَقَالَ: ((إِن الله لم يرض بِحكم نَبِي وَلَا غَيره فِي الصَّدقَات حَتَّى حكم هُوَ فِيهَا فجزأها ثَمَانِيَة أَجزَاء فَإِن كنت من تِلْكَ الْأَجْزَاء أَعطيتك حَقك)). لقد كان المنافقون لشدة حرصهم على الأموال وأكثرُهم أغنياء عنها وليسوا من مصارفها، يعلقون رضاهم بما يعطاهم من الصدقات ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ﴾ [التوبة: 58]، وفعل "رضي" في هذه الآية أصل واحد ضد سخط، يقال رضي الشيءَ أو سخطه، فإذا تعدى إلى المفعول دل على اختيار المرضيّ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذ خطب على جليبيب امرأة من الأنصار فقال له أبوها: إن رضيته لنا رضيناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إني أرضاه)) فزوجها، وإذا عدي بالباء دل على أنه صار راضيًا، كما في قوله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ [التوبة: 38]، وقوله عز وجل: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: 87]؛ أي: فإن أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقات شيئًا قنعوا به وارتاحوا له وكفوا عن اللمز والأذى ﴿ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة: 58]، وإذا لم يكونوا من مصارف الزكاة الثمانية ومنعوها غضبوا وانطلقوا يعيبونه صلى الله عليه وسلم ويغتابونه بما ليس فيه، وهو يداريهم ويطاولهم ويهدئ من روعهم ولهفتهم إلى مال الصدقات تصريحًا وتعريضًا ونصحًا، كما في رواية أَبِي هُرَيْرَةَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: ((مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)). ثم بالتفات بياني إلى الصواب الذي فات المنافقين فضله وأجره قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 59]؛ أي: ولو أنهم قنعوا بما شرعه الله لهم في الصدقات والأموال وبما قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم منها قسمة شرعية عادلة ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾، وقالوا: يكفينا ما كتبه الله لنا من الصدقات ﴿ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾، لا نيأس من كرم الله وعطاء رسوله، فالله تعالى رزاق كريم ورسوله صلى الله عليه وسلم قاسم معطاء أمين ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾، إننا دائمًا نسأل الله غير يائسين من عطائه وفضله، إلا أنهم كانوا أشد بُعْدًا عن هذه المواقف الإيمانية، كانوا يشتطون في طلب ما ليس لهم من الصدقات، ويتجرؤون بوقاحة على مجادلة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، من ذلك ما أخرجه ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن جَابر قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلَهُ وَهُوَ يقسم قسمًا فَأَعْرض عَنهُ وَجعل يقسم فقَالَ: "أتُعْطي رِعَاءَ الشَّاء؟ وَالله مَا عدلت"، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((وَيحك من يعدل إِذا أَنا لم أعدل؟))، فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: 60]، وكان نزولها حسمًا قرآنيًّا لأمر القسمة والنزاعِ حولها، بيَّن به الحق عز وجل مصارف الزكوات بجميع أصنافها، في تشريع ثابت غير متغير إلى يوم الدين، فرضه تعالى بعلمه وحكمته على المسلمين، بقوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]؛ أي: إنما تدفع الصدقات – وهي الزكاة بجميع أصنافها - إلى ثمانية أصناف من المحتاجين، وهم: الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم فيسألونه، والمساكين وهم من عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرؤوا إن شئتم: ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: 273]، وفي لفظ: (ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس)، والعاملون عليها وهم الساعون في تحصيلها لبيت المال وتوزيعها على مستحقِّيها، ويدخل فيهم الذين يجمعونها ويشرفون على صيانتها وإدارتها وتوزيعها، والمؤلفة قلوبهم وهم أصناف: منهم من بدا فيهم ميل للإسلام ولم يسلموا بعد، مثل صفوان بن أمية، ومنهم حديثو عهد بالإسلام وعرف في إسلامهم ضعف كحال بعض مسلمة الفتح مثل الحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب بن أمية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقات تأليفًا لهم، وإشعارًا لهم برحمة الإسلام وكرمه وإحسانه [1]، وفي الرقاب؛ أي: لتحرير الأسرى عند العدو، ورقاب المدينين بقتل فتؤدَّى عنهم الدية الواجبة إن تم الاتفاق عليها، والغارمون وهم المدينون العاجزون عن الأداء، وفي سبيل الله مطلقًا بما تقره الأمة من المصالح العامة المتعلقة بالدفاع عن أرض الإسلام، وابن السبيل؛ وهو الغريب الذي انقطعت به السبيل ولا يجد ما ينفق. يتبع
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
وقد بدئت هذه الآية الكريمة بحرفي "إن" للتوكيد و"ما" للحصر، للدلالة على أنه لا حق فيها لغير هؤلاء الثمانية المذكورين، وقال عن تشريعها صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى لم يرض بقسمة الزكاة أن يتولَّاها مَلَكٌ مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه)). أما صدقة التطوع فيجوزُ دفعها إلى هؤلاء الثمانية وإلى غيرهم بحسب إرادة المتصدِّق. بهذه الآيات الكريمة حسم الحق تعالى جدل المنافقين حول تقسيم الصدقات، ولكن المنافقين لا يرعوون ولا يرتدعون، فقد واصلوا أصنافًا أخرى من الأذى لا تصدر إلا عن النفوس المريضة، يلتمسون بها ما يعيبون به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبرأ من العيب، فنزل الوحي بذلك يفضحهم ويندد بفعلهم ويرد عليهم بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ﴾ [التوبة: 61] والأذن لغة وهي حاسة السمع من الكائن الحي، وفي هذه الآية تعبير مجازي عن السامع بها، خبر المبتدأ ﴿ هُوَ ﴾؛ أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول المنافقين: ﴿ هُوَ أُذُنٌ ﴾، يعنون به أنه صلى الله عليه وسلم سليمُ القلبِ بسيط، سريع الاغترار بما ينقل إليه والتصديق بكل ما يسمعه، والقائلون كانوا جماعة من مردة المنافقين يغتابونه صلى الله عليه وسلم في مجالسهم الخاصة، منهم نبتل بن الحارث، وعتاب بن قشير، قالوا: "محمد أذن سامعة، نقول ما شئنا، ثم نأتيه فيصدقنا فيما نقول"، قال محمد بن إسحاق بن يسار: "نزلت في رجل من المنافقين يقال له: نبتل بن الحارث، وكان رجُلًا أزلم[2]، ثائر الشعر، أحمر العينين، أسفع الخدين، مشوَّه الخلقة، قال عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث))، وكان ينقل حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى المنافقين، فقيل له: "لا تفعل" فقال: "إنَّما محمد أذن، فمن حدَّثه شيئًا صدَّقه؛ فنقول ما شئنا، ثُمَّ نأتيه فنحلف له"، وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ قَالَ: اجْتمع نَاس من الْمُنَافِقين فيهم جُلاس بن سُوَيْد بن صَامت وجحش بن حِمْيَر ووديعة بن ثَابت، فأرادوا أَن يقعوا فِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَنهى بَعضهم بَعْضًا وَقَالُوا: "إنا نَخَاف أَن يبلغ مُحَمَّدًا فَيَقَعَ بكم"، وَقَالَ بَعضهم: "إِنَّمَا مُحَمَّد أذن نحلف لَهُ فيصدقنا"، وهذا من المنافقين طعن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد أن لمزوه في عدالته وقسمته الصدقات، وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، وقال عنه الحق تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]، فرد الله عليهم وعلى من يفعل فعلهم بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد، ﴿ أُذُنُ ﴾ خبر مرفوع لمبتدأ محذوف جوازًا تقديره "هو"، أي الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ بكسر الراء مضاف إلى ﴿ أُذُنُ ﴾؛ أي: هو أُذُن خيرٍ لكم، يسمعكم ويفهم ما تقولون، فيعرف بعضَه ويُعرِض عن بعضه، ويغضي عن بعضه، رحمةً بكم وإشفاقًا عليكم، ثم يصحح أخطاءكم في القول والفهم والمعرفة والتصرف بما يوحيه الله إليه من الحكمة، مستمعُ خيرٍ ورحمة، لا مستمع شر ونقمة، ولو كان غير ذلك لكذَّبكم وفضحكم. ولفظ ﴿ خَيْرٍ ﴾ بالكسر مضافًا إلى: "أذن"، هو ما عليه الجمهور، فإن قرأت "أُذُنٌ" بالتنوين كان "خيرٌ" بالضم والتنوين خبرًا ثانيًا لضمير المتكلم المحذوف "أنا"، وهي قراءة عاصم في رواية الأعمش وعبدالرحمن عن أبي عكرمة، كما تقرأ "ورحمة" بالضم عطفًا على "أُذُن" وبالجر عطفًا على "خَيْرٍ" إذا كانت بالجر. ثم زاد الحق تعالى توضيحًا لفضله صلى الله عليه وسلم بينهم وفيهم وعليهم فقال سبحانه: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ حق الإيمان ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي: يصدق ما يعلنونه له من إيمانهم على اختلاف درجاته قوةً وضعفًا، وحقيقته وجودًا وعدمًا، تثبيتًا للصادقين وسترًا وإمهالًا لغيرهم لعلهم يرعوون فيتوبون ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾، ورحمة لمن صدق إيمانه منكم، وإمهال لغيرهم ممن لم يخلص إيمانهم فيقبله منهم ملاينة واستدراجًا لهم إلى الخير، ثم هدَّد الله تعالى هؤلاء المنافقين فقال عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وهو تهديد آخر لهم يؤكد ما نزل فيهم من قبل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [المجادلة: 5]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: 57]. وقوله تعالى: ﴿ يُؤْذُونَ ﴾، من الأذى وهو الشيء يؤلم النفس أو الجسد أو يكرهه المرء ولا يتحمله، أكثر ما يطلق على الضرر الخفيف أو الضر بالقول والدسائس، يقال: آذاه يؤذيه فهو مؤذٍ؛ أي: مضر له بالقول أو الفعل أو المعاملة أو الإشارة أو التعريض، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ﴾ [آل عمران: 111]، والآية تهديد بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة للمنافقين الذين كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم سرًّا ويحاولون إذايته تعريضًا وتلميحًا أو تصريحًا ومجاهرة، أو تأويلًا فاسدًا لأقواله وأفعاله، ووعيد صارم بالعذاب لكل من يرتكب ذلك في حياته أو بعد وفاته. إن العادة المضطردة في المنافقين أنهم جبناء رعاديد لا يتورعون عن الهمز واللمز والأذى تنفيسًا لغيظهم وأحقادهم، فإن انكشف أمرهم أنكروا ما قالوه وما فعلوه وما حاولوه، وتترسوا بالتمويه والجدل والأيمان الفاجرة والغموس لإنكار ذلك، وقد روى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: "ذكر لنا أن رجلًا من المنافقين قال في شأن المتخلفين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم ما نزل: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقًّا لهم شر من الحمر"، فسمعها رجل من المسلمين فقال: "والله إن ما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار"، فسعى بها الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: (ما حملك على الذي قلت؟)، فجعل يلْتَعِنُ - أي يلعن نفسه إن قال ذلك - ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: "اللهم صدِّقِ الصادقَ وكذِّبِ الكاذبَ، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 62]، والآية خطاب من الله سبحانه للمؤمنين يحذرهم بها من تصديق المنافقين الذين يحاولون التمويه على نفاقهم بإنكاره، أو تأكيد إيمانهم بالحلف على صدقه وسلامته، ودليل على ما أصابهم من الرعب والخوف من الفضيحة، وأن الذي يهمهم هو سمعتهم ورضاء الناس عنهم على خلوِّ قلوبهم من الإيمان و إصرارهم على الكفر، ولو كانوا مؤمنين حقًّا لكان همهم إرضاء الله تعالى؛ لأنه الأحق بالرضا، وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الأحق بالاتباع ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 62]، والحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الحق أن يجعل إرضاء الله بمحبته والإيمان به وحده لا شريك له والتوبة والإنابة إليه هدفه ومقصوده، وأن يجعل إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه واتباعه وطاعته وعدم إيذائه منهج حياته وسعادة قلبه في ليله ونهاره. إن العدوَّ عدُوَّان، ظاهر معلن تعد له ويعد لك في رابعة النهار، وذلك فعل الكافر المجاهر، ومتستر يمكر بك ويكيد لك ويعد لك في ظلمة الليل وأنت نائم أو غافل، وذلك فعل المنافقين، الذين تكاثروا في المجتمع المسلم في السنتين الأخيرتين من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عقب فتح مكة وإسلام أهلها غلابًا، وشارك بعضهم في غزوة حنين، وحاول بعضهم فتنة جيش المسلمين وإرباكه، وتطور مكر بعضهم إلى المشاركة في محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من تبوك عند العقبة، ومحاولة عرقلة جيش أسامة وتأخير خروجه، ومع كل هذا المكر والغدر والخيانة يحلفون للمسلمين أنهم منهم ترضية لهم وتغطية على نفاقهم؛ ولذلك فضحهم الله بين المسلمين ثم أنَّبَهم وهددهم بقوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [التوبة: 63]، والهمزة في أول الآية للاستفهام الإنكاري التعجبي من أفعال المنافقين وإصرارهم على الفساد، وحرف ﴿ لَمْ ﴾ للجزم والنفي، تجزم فعل ﴿ يَعْلَمُوا ﴾ بحذف النون، وتنفي علمهم، والفعل ﴿ يُحَادِد ﴾، من الحد وهو الحاجز بين الشيئين يمنع اتصالهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: 229]، وقوله عز وجل: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: 97]، ويستعمل مجازًا بمعنى المفاصلة والمحاربة كما في هذه الآية من قوله تعالى: ﴿ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾؛ أي: يحارب الله بتكذيب رسوله والمكر به، والجملة الاسمية من الشرط وجوابه: ﴿ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 63]، مفعول ﴿ يَعْلَمُوا ﴾؛ أي: ألم يسبق لهم العلم في القرآن وقد بلغهم وتلي عليهم بأن من يحارب الله تعالى ورسوله كما يفعلون مصيره الخلود في جهنم؟ وهو منه تعالى سؤال للتأنيب والتوبيخ؛ لأن من يؤمن بالله حق الإيمان يعلم يقينًا أن حرب الله ورسوله كبرى كبائر الإثم، مرتكبها مُخلَّد في النار، فكيف يجرؤون على ذلك وقد بلغهم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [المجادلة: 5]. إن من يدعي الإيمان أو بلغته دعوة الإسلام يعلم بداهة أن محاربة الله والنيل من رسوله كفر بواح، فكيف غاب عنهم ما بلغهم وعرفوه وادعوا الإيمان به ثم عملوا بنقيضه؟! لذلك وصف الحق تعالى حالهم ومآلهم؛ إذ يرتكبون ما ارتكبوا بقوله عز وجل: ﴿ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 63]، والخزي من فعل"خَزِيَ يخزَى" الرجل من باب علِم يعلَم إذا وقع في بلية أو فضيحة تذله وتهينه واستحيا من قبح فعله، فهو خَزيان؛ أي: وذلك هو أعظم الهوان والذل وأوخم ما ينتظرهم ويدخر لهم في الآخرة. إن المنافقين أسوأ حالًا من الكُفَّار المعالنين؛ لأنهم يعرفون الحق الذي جاء به الإسلام وتأباه نفوسهم لأهوائها الضالة وعلاقاتها الفاسدة وأمزجتها القلقة المتقلبة، وهم كالذي صُفِع قفاه مرة ويرتقب صفعة أخرى أشد تفضح سرائرهم بين أهلهم وذويهم والناس أجمعين، ذلك حالهم الذي مردوا عليه منذ أسلموا كرهًا عقب فتح مكة، ثم تكاثروا وقويت شوكتهم وفي المسلمين سمَّاعون لهم، ثم وهم في أمر مريج من الخوف والاضطراب والترقب؛ إذ أخذ نفاقهم يفتضح، وانتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم تتوالى، والقرآن ينزل تترى آياته كاشفة لأسرارهم سِرًّا بعد سِرٍّ بقوله تعالى: ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 64]. وفعل ﴿ يَحْذَرُ ﴾؛ أي: يخاف ويترقب، مضارع فاعله ﴿ الْمُنَافِقُونَ ﴾، من الحذر وهو التحرز والتيقظ، وترقب المكروه والاستعداد له، أو الخوف منه والاحتياط له، والرجل الحذر هو الخائف المتأهب للمواجهة، ومترقب الشر من جهة ما، ومنه في القرآن: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ [الشعراء: 56]؛ أي: خائفون ومتأهِّبون. وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ جملة فعلية من "أن" والفعل، مفعول: "يحذر"؛ أي: إن المنافقين المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حاذرين خائفين مترقبين أن ينزل الله في شأنهم سورة من القرآن تفضح دخيلة قلوبهم وما فيها من النفاق والاستهزاء بالعقيدة وأحكامها، وتهتك أسرارهم وما يخفونه ويعدونه من المكر والغدر والخيانة، هذه المواقف منهم لم يكن لها من سبب إلا الشك فيما نزل من الوحي والارتياب، في الألوهية والنبوة؛ لذلك كانوا يعلنون الإيمان خوفًا، ويخفون الريب والشك والاستهزاء بالعقيدة وأهلها فيما بينهم، فإذا عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكروا شيئًا من أمره وأمر المسلمين، قالوا مستهزئين ساخرين: "لعل الله لا يفشي سِرَّنا"، فقال الله لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلِ ﴾ لهم يا محمد ﴿ اسْتَهْزِئُوا ﴾، والأمر في قوله تعالى: ﴿ اسْتهزِئُوا ﴾ للتهديد والوعيد والتحدِّي والسخرية بهم، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي * فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [الزمر: 14، 15] وقوله لإبليس: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: 64]؛ أي: اسخروا كما تشاؤون فلن تنفعكم السخرية شيئًا، وعاقبة أمركم أن تنفضحوا في الدنيا وتعذبوا في الآخرة ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾، ولفظ "مخرج" تعبير مجازي بمعنى مظهر أو كاشف أو منزل من القرآن ما يفضح أسراركم وأحقادكم وضغائنكم على المسلمين، وما تُعِدونه من خيانة لله ورسوله، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾ [محمد: 29]. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على حماية المنافقين من أنفسهم ويستدرجهم للتوبة، فيتألف قلوبهم وينصحهم أو يحذرهم بحسب ما تقتضيه الظروف، ولكنهم يراوغونه ويتفلتون من الاعتراف بالذنب وينكرون فساد عقيدتهم ونواياهم وأمراض قلوبهم، من ذلك أن رَهْطًا مِن الْمُنَافِقِينَ كانوا يَسِيرُونَ مَعَه صلى الله عليه وسلم فِي تَبُوكَ، مِنْهُمْ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ، أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَالْجُلاسُ بن سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ، ومخشي بْنُ حِمْيَرَ مِنْ أَشْجَعَ، حَلِيفٌ لِبَنِي سَلمَة، وَثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ. فَقَالَ: "تَحْسَبُونَ قِتَالَ بَنِي الْأَصْفَرِ كَقِتَالِ غَيْرِهِمْ؟ وَاَللهِ لَكَأَنّا بِكُمْ غَدًا مُقَرّنِينَ فِي الْحِبَالِ"، إرْجَافًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرْهِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ: "مَا لِي أَرَى قُرّاءَنَا هَؤُلَاءِ أَوْعَبَنَا بُطُونًا، وَأَكْذَبَنَا ألسنة، وأجبننا عند اللِّقاء؟" وقال الجلاس بن سُوَيْدٍ: "هؤلاء سَادَتُنَا وَأَشْرَافُنَا وَأَهْلُ الْفَضْلِ مِنَّا، وَاللهِ، لَئِنْ كَانَ مُحَمّدٌ صَادِقًا لَنَحْنُ شَرُّ مِن الْحَمِيرِ، وَاللهِ لَوَدِدْت أَنِّي أُقَاضِي عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُلُّ رَجُلٍ مِنّا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَأَنَّا نَنْفَلِتُ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ بِمَقَالَتِكُمْ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: ((أَدْرِك الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ احْتَرَقُوا، فَسَلْهُمْ عَمَّا قَالُوا، فَإِنْ أَنْكَرُوا فَقُلْ: بَلَى، قَدْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا))، فَذَهَبَ إلَيْهِمْ عَمَّارٌ فَقَالَ لَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَذِرُونَ إلَيْهِ، فَقَالَ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ، وَقَدْ أَخَذَ بِحَقَبِ نَاقَةِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَاهُ تَنْسِفَانِ الْحِجَارَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ"، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِيهِ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [التوبة: 65]؛ أي: لئن سألتهم أو سئلوا عن تصرُّفاتهم المخربة للصف، وأقوالهم المثبطة للهمم، تجاهلوا خطورتها وأنكروا القصد منها، وادعوا أنها مجرد تفكُّه بسيط وتسلية كانت فيما بينهم لتمضية الوقت أو قطع الطريق. هذا ديدنهم وأسلوبهم في الدسِّ والمراوغة، كلما كشف الله للنبي نفاقهم وأخرج للمؤمنين ضغائنهم وأحقادهم؛ ولذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له:﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد موبِّخًا ومهددًا ﴿ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [التوبة: 65]، هل بلغت بكم الجراءة والوقاحة والعدوان على المقدَّسات أن تسخروا بالله وآياته المنزلة، وبرسوله المبتعث إليكم؟! ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا ﴾؛ لأن الاعتذار يكون عن الخطأ غير المقصود، وما فعلتم ليس خطأ، بل هو الكفر والعدوان والوقاحة والسخرية، لقد حصدتم بأقوالكم وأعمالكم وسرائر قلوبكم كل شر، وما تركتم سوءًا إلا تلبستم به ﴿ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾، قد تحقق كفركم بعد أن ادعيتم الإيمان ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾، عن فرقة منكم تابت وأخلصت الإيمان ﴿ نُعَذِّبْ طَائِفَةً ﴾ نعذب أخرى أصرت ولم تتب ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ بسبب إصرارهم على الكفر الذي هو منتهى الإجرام. ثم رفعا لمستوى الوعي لدى المسلمين بصراع الحق والباطل في حلبة الحياة وميدان الدنيا، وارتقاء بتوبيخ المنافقين وكشف مثالبهم وتيئيسهم من رحمة الله ما أقاموا على النفاق، عرف الحق تعالى المؤمنين بطبيعة المنافقين وأسلوبهم في التخريب، وحقيقة علاقتهم بمقتضيات الإيمان فقال تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: 67] متشابهون فيما يضمرونه للإسلام والمسلمين من العداوة والجحود، متضامنون فيما بينهم، يدافع بعضهم عن بعض في تكتُّل شيطاني رجيم ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المجادلة: 19] ومن كان الشيطان قد استحوذ على قلوبهم فإنهم لا بد بألسنتهم ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ ﴾ يحرضون على كل سوء ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾ وينهون عن كل خير ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ عن أي عمل يرضاه الله، نفقة أو بذلًا أو بِرًّا وإحسانًا ﴿ نَسُوا اللَّهَ ﴾ ذهلوا عن التفكُّر في الله وتدبر آياته والعمل بأحكامه ﴿ فَنَسِيَهُمْ ﴾، فمنعهم هدايته ووكلهم لضلالهم وعبث شياطينهم بهم ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ إن المنافقين هم الأحق بأن يوصموا بالفسق؛ لأنهم انسلخوا عن الإسلام وتترَّسوا بالنفاق ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ﴾ توعَّد الله ﴿ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ ﴾ جميعًا ﴿ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ محبوسين فيها تحيط بهم من كل جانب ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ لا يغادرونها ولا يُخرَجون منها أبدًا ﴿ هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾ هي كِفاء آثامهم، وهم أهل لها ﴿ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ أبعدهم من عفوه ورحمته ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾ في الآخرة ﴿ مُقِيمٌ ﴾ دائم أبدًا. [1] بلغ عدد من عدَّهم ابن العربيفي "الأحكام" من المؤلفة قلوبهم تسعة وثلاثين رجلًا. [2] شرير.
__________________
|
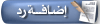 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |