|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
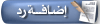 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
قضايا دعوية معاصرة (1) العذر بالجهل شريف عبدالعزيز من أهم قواعد إجراء الأحكام الشرعية وإنفاذ أثرها المادي والمعنوي هو اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع، أما اجتماع الشروط فمعلوم من الكتاب والسنة، فالوصف لا يلحق بالعمل إلا إذا اجتمعت شروطه، أما الحكم فلا يلحق إلا إذا انتفت الموانع، ومن أهم هذه الموانع ؛ عوارض الأهلية التي تمنع لحوق الوعيد بالوصف الثابت باجتماع شروطه، ومن أهم عوارض الأهلية الجهل والتأويل والإكراه، وكل واحد منها يمثل قضية كلية من قضايا العقيدة والدعوة الإسلامية، تحتاج إلى ضبط وتحقيق، ومعرفة الثابت فيها والمتغير، وما لا يسع الخلاف فيه، وموارد الاجتهاد فيه، حتى لا يطيش الدعاة عند إجراء الأحكام بين جافي وغالي، مُفرط ومفرّط، وينتج عن ذلك كثيرا من الإحن والخلافات والصراعات التي ما كان لها أن تندلع لو انضبط الدعاة بضوابط الشرع في هذه القضية الحساسة. ثوابت عارض الجهل: أولا: المعرفة لا تكون إلا بالشرع فمعرفة الله بأسمائه وصفاته وآلائه، ومعرفة الرسل - صلى الله عليهم وسلم - وواجباتهم وحقوقهم، ومعرفة الدين بتكاليفه الشرعية من حلال وحرام وجائز ومستحب، كل ذلك لا يكون إلا على لسان الشارع الكريم، وذلك عند أهل السنة والجماعة خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة من جعل المعرفة تجب عقلا على المكلفين، وقولهم ظاهر البطلان، إذ كيف يتعرف الإنسان على صفات الله - عز وجل -؟، في حين لا سبيل لهم لرؤيته أو إدراكه ما لم يخبرهم الوحي المعصوم، قال اللالكائي - - رحمه الله - - في شرح أصول الاعتقاد: " سياق ما يدل من كتاب الله - عز وجل -، وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، قال الله تعالى يخاطب نبيه بلفظ خاص والمراد به العام ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) [ محمد 29 ]، وقال تبارك وتعالى ( اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) [ الأنعام 106] وقال ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء 25 ] ". أما ما ذهب إليه المعتزلة من الاستدلال بواقعة نظر إبراهيم - عليه السلام - في آيات الله في الكون للتعرف على الله - عز وجل - فهو استدلال ناقص وفي غير موضعه، لأن الله عز وجل ختم الآيات بقوله على لسان إبراهيم عليه السلام: ( لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) [ الأنعام 77]، فدل ذلك على أن معرفة الرسل أنفسهم بالسمع والوحي، قال الغزالي - رحمه الله - في فيصل التفرقة: " وقد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع، وأن الجاهل بالله تعالى كافر، والعارف به مؤمن، فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود في النار، حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع " وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسير قوله عز وجل ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [ الإسراء 15 ]: " وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن، ويبيح ويحظر " وقال ابن القيم - رحمه الله - في طريق الهجرتين: " إن الله – سبحانه - لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة " وقال الشنقيطي في تفسير آية الإسراء: " والآيات القرآنية مصرحة بكثرة، على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وما ركز في الفطرة، بل إن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، فالله عز وجل قال فيها ( حتى نبعث رسولا ). ولم يقل: حتى نخلق عقولا، وننصب أدلة، ونركز فطرة ". ثانيا: البلاغ هو أصل الاعتبار فالأصل عند اعتبار عارض الجهل، أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، على الأظهر من أقوال العلماء، وذلك لقواه تعالى ( لأنذركم به من بلغ ) [ الأنعام 19 ]، وقوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) [ النساء 165]، ولهذا لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارا لما أجنبا، فلم يصل عمر وصلى عمار بعد أن تمرغ بالتراب، أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر من استمر في الصلاة إلى بيت المقدس، ولم يبلغه تحول القبلة بالقضاء حين بلغه خبر التحول، ومهاجرة الحبشة مكثوا فيها حتى العام السابع من الهجرة، وكانت خبر التكاليف تصل بعد فرضها بأسابيع، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الإعادة، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه ؟ وفيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى ( لأنذركم به ومن بلغ ) ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرا مما جاء به، لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى ". قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: " فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص " ثالثا: المقبول والمردود من العذر فإن من الجهل ما يعذر به صاحبه، ومنه ما لا يعذر فيه، وذلك لأن العلم علمان؛ أولهما: علم العامة: وهو ما لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله، مثل وجوب أركان الإسلام أو المباني الخمسة، ونحوه مما علم من الدين بالضرورة، وهذا لا عذر لأحد فيه، وثانيهما: علم الخاصة: وهو ما ينوب العباد في فروع العبادات والمعاملات والاعتقادات، مما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع، وهذه الدرجة من العلم لا تبلغها العامة، ولم يكلفها كل الخاصة، فهي من فروض الكفاية التي تسقط بقيام البعض بها دون البعض، وهذا العلم يعذر فيه المرء بجهله، ويقبل فيها دعواه بعدم العلم. رابعا: نسبية العذر بالجهل فقضية العذر بالجهل ليست قضية مطلقة بحيث أنها ثابتة مهما اختلفت العوامل المحيطة بها، بل هي قضية نسبية تخضع لتأثيرات البيئة وتغيرات الزمان، فما يعذر به في دار الحرب، غير ما يعذر به في دار الإسلام مثلا، فليس من نشأ في ديار الإسلام وآباؤه وأجداده مسلمون، كمن نشأ في البادية والفيافي أو كان حديث عهد بالإسلام، والعذر بالجهل في زمان رفع العلم وشيوع الفتن وكثرة الشبهات وطي أعلام السنة، ليس كالعذر بالجهل في أزمنة التمكين وتطبيق الشريعة وقمع البدع وإقامة السنن، لذلك قال أهل العلم إن العذر بالجهل مما تتغير به الفتوى، بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " كثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث عهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: " يأتي على الناس زمان، لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله " انتهى كلامه - رحمه الله -، قال الشيخ أبو زهرة من الأصوليين المعاصرين: " الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية هو جهل قوي، إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال: إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية، حتى أنه لو أسلم رجل في دار الحرب، ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية، ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة، فإنه يؤديها قضاء إذا علم، ووجهة نظر الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تستفض فيها مصادر الأحكام ولم تشتهر، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف، إذا لم يتوجه الخطاب " وكذلك قال الألباني - رحمه الله - كلاما شبيها بذلك. خامسا: لا عذر في الإقرار المجمل والبراءة المجملة فثمة أصل كلي لا عذر فيه على الإطلاق، وهو ما لم يدن بدين الإسلام فهو كافر بيقين لا مجال للاعتذار أو التأويل، سواء كان عنادا أم جهلا، أما مآله في الآخرة فهو من موارد الاجتهاد، وكان الفلاسفة والمتكلمون من أمثال الجاحظ لا يرون كفر اليهود والنصارى إلا المعاند منهم، وقد رد عليهم أهل العلم ردودا قوية مثل الغزالي في المستصفى، وابن القيم في طريق الهجرتين، ومن المعاصرين أبي زهرة في الأصول، فقد قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض حديثه عن طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم: " والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله وإتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنه كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم من عن كونهم كفرا، فإن الكافر من حجد توحيد الله وكذب ورسوله، إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد" وهذه النقطة تقود إلى الكلام عما يعذر فيه من تفاصيل التوحيد بالجهل، مثل الجهل ببعض صفات الله - عز وجل -، والتحاكم إلى بعض جزئيات في الشرائع الأرضية ظنا بجواز ذلك، اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم " أنتم أعلم بشئون دنياكم ". وقد وقع الإنكار لبعض صفات الله - عز وجل - من جماعة من العلماء، بل إنه وقع من الصحابة أنفسهم، كما جهلت عائشة - رضي الله عنها - أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، فقد قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل يعلم الله - عز وجل - كل ما يكتم الناس ؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نعم "، وعائشة بسؤالها هذا كانت جاهلة بعلم الله المحيط، ولم تكن بذلك الجهل كافرة، فالقول وإن كان كفرا بواحا إلا أن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه العلم والحجة الرسالية. أيضا وقع من الصحابة اختلاف في رؤية الله - تعالى - يوم القيامة، فأثبته جماعة وأنكره جماعة، ومن أنكره لم يصله قوله صلى الله عليه وسلم: " أنكم سترون ربكم يوم القيامة. . ". ومن ذلك أيضا جهل بعض الفضلاء والعلماء بأحوال بعض الزندقة من الحلوليين والقبوريين والمبتدعين، مثل جهل السيوطي والهيتمي والألوسي والقاسمي وغيرهم من فطاحل العلماء بحال ابن عربي الزنديق، وثناؤهم عليه في مصنفاتهم ومؤلفاتهم. ومن ذلك أيضا جهل عوام المنتسبين إلى الفرق الضالة مثل المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية ممن لا يعرفون حقائق المذهب وأسرارهم ومواطن ضلاله، ويدخل معهم بصورة أقل عوام القبوريين وأتباع سدنة المقابر وشيوخ الطرق البدعية، ولعلماء نجد من آل الشيخ المتقدمين جهد مشكور في بيان ذلك الأمر. أما الأمور الاجتهادية التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم في جواز العذر به أو عدمه فكثيرة، فمن موارد الاجتهاد قضية الجهل بعموم قدرة الله عز وجل، وإنكار معاد الأبدان إذا تفرقت، وأصل الاختلاف هو الاختلاف في فهم خبر الرجل الذي لم يفعل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة أمر بنيه أن يحرقه ويذروه في يوم شديد الرياح، ظنا منه أن الله - عز وجل - لن يقدر على جمعه، ولعلماء تأويلات ومخارج عديدة في فهم الحديث، وباختلاف الأفهام، اختلفت الأقوال بين مجيز ومانع. ومن الأمور الاجتهادية أيضا تكفير عوام الرافضة والحرورية الخوارج، ففيه قولان مشهوران عند أهل العلم. ومنها مآل من مات ولم تبلغه الدعوة فقد وقع في هذه المسألة تحديدا خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من جزم بكفرهم وخلودهم في النار كما ذهب لذلك كثير من الأحناف، ومنهم من عذره وأدلته على ذلك كثيرة، ومنهم من ذهب لاختباره في عرصات يوم القيامة، ومنهم من ذهب إلى بقائه على الفطرة. قضايا دعوية معاصرة (2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلسلة قضايا دعوية معاصرة (3) الاجتهاد والتقليد قضايا دعوية معاصرة (4) الإيمان والكفر
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
قضايا دعوية معاصرة (2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريف عبدالعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد أركان الدين الأساسية، بل هو قطب الدين الأعظم كما قال أهل العلم، فهو مهمة الرسل ووظيفة الدعاة، بإقامته تقوم الحجج الرسالية على من عصى رب البرية، به نالت أمة الإسلام شرف الريادة والخيرية، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعن في محكم التنزيل، فهو الجهاد الدائم المفروض على كل مسلم، لا قيام لشريعة الإسلام بدونه، ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه، بقيام سوقه يرتدع البغاة والمجرمون، وينتصح الغافلون، ويرعوي المفسدون، ما تركه قوم إلا هلكوا، غرقت سفينتهم وغرقوا معها، فهو الضرورة التي لا غنى للمجتمعات عنها، به تكتسب صلاحها واستقامتها. والآيات والأحاديث والآثار السلفية الدالة على فضل ومكانة وعظم وخطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر من الحصر، والمقام ليس مقام بيان فضل محل إجماع، ولكن المقصود تأسيس قواعد الضبط والترشيد. ومع غلبة الأهواء والشبهات في واقعنا المعاصر، تعرضت هذه الفرضية الركينة لكثير من العبث والتغيير، وضيعت رسومها بين تارك لها بشبهات واهية وشهوات داهية، وبين مطبق لها بلا فقه ولا بصيرة، فوقع في أعظم مما سعى لإزالته، وجاء احتسابه بنقيض مراده، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. لذلك كانت هذه الشعيرة الهامة في أمس الحاجة لضبط أصولها وبيان ثوابتها من متغيراتها، ومحكماتها من متشابهاتها، ليكون القائم بها على بصيرة، فتحقق غاياتها وأهدافها، وتتبوأ دورها الريادي في حفظ ضرورات الحياة والمجتمعات. ثوابت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي في غالب أحواله وذلك لقوله عز وجل ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [ آل عمران 104] فالله - عز وجل - لم يكلف الجميع في الآية، بل قال: ( لتكن منكم أمة )، وهو خطاب كفائي عند الأصوليين، وهو ما يسقط الحرج عن الجميع إن قام به البعض، واختص الفلاح بالقائمين به، وإن تقاعد الخلق أجمعون عم الحرج القادرين عليه كافة لا محالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - -: " وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة: السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان حسب قدرته، قال تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) " وقال في موضع آخر: " وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجب على كل أحد يعينه بل هو على الكفاية، كما دل القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". ثانيا: عدم اختصاص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذوي الولايات وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " وقوله: " فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " أخرجه مسلم. قال النووي - رحمه الله - : " ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل جائز لآحاد المسلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية ". قال الإمام القرطبي في تفسيره: " وأجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بالتغيير إلا اللوم الذي لا يتعدى الأذى، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره، والأحاديث في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولكنها مقيدة بالاستطاعة ". وقد جزم الغزالي بفساد قول من اشترط إذن الإمام أو الوالي في مباشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لعموم الآيات والأحاديث. وقد نقل الشوكاني في السيل الجرار قول إمام الحرمين الجويني قوله: " ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله، ما لم ينته الأمر على نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان ". ثالثا: لا إنكار في موارد الاجتهاد فمعظم مسائل الدين هي من موارد الاجتهاد التي اختلفت فيها الأنظار والأفهام بما لا يشذ معنا وفهما عن المعمول به في قواعد الاستنباط، ومسائل الإجماع قليلة ولم يشذ عنها إلا القليل ممن لا يعتد بخلافهم، دون ذلك فالمجال رحب والطريق مهيأ، لذلك كان الإنكار في موارد الاجتهاد من الأمور التي تورث الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين، سئل ابن تيمية عن تقليد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أو يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين، فأجاب: " الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين "، وقال في موضع آخر: " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ". ولكن يبقى معرفة أن هذا الكلام كله يدور في فلك الاختلاف السائغ الذي يستمسك فيه كل طرف بدليل من الكتاب والسنة، أما الخلاف غير السائغ الذي مبناه الخطأ البين والهوى والتعصب فليس لأحد من الناس أن يعمل به، ثم يحتج بأنه من موارد الاجتهاد التي لا ينكر فيها عليه، بل يجب عندها الإنكار والتثريب على الفاعل. رابعا: الأصل حسم المنكر وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من رأي منكم منكرا.. " فيجب حسم المنكر بما ينحسم به من الكلمة إلى القوة. قال القاضي عياض - رحمه الله - : " هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا وفعلا، فيكسر أدوات الباطل، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها ". وقال الجصاص الحنفي: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته، ففرض على من أمكنه أن يزيله بيده أن يزيله، وإزالته باليد تكون على وجوه: منها ألا يمكنه أن يزيله إلا بالسيف، وأن يأتي على نفس الفاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك، كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله، أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك، وعلم أنه لا ينتهي إلا إن أنكره بالقول، أو قاتله بما دون السلاح، فعليه أن يقاتله لقوله صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره.. " فإن لم يمكنه تغيره إلا بقتل المقيم على هذا المنكر، فعليه أن يقتله فرضا عليه، وإن غلب على ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه، لم يجز له الإقدام على قتله ". قال الشوكاني: " إذا كان قادرا على تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه ولو بالمقاتلة، وهو إن قتل فهو شهيد، وإن قتل فاعل المنكر فبالحق والشرع قتله، ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين، فإن لم يؤثر فيه ذلك جاء بالقول الخشن، فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد، ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا بها ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين، وفي الصحيح " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " وقال: " من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان ". خامسا: الإنكار للإزالة لا للعقوبة فالمقصود من إنكار المنكر هو إزالته لا إيقاع العقوبة على الفاعل، فالإنكار من حق أي مسلم في حين أن العقوبة من شأن السلطان ومن ينوب عنه. قال الغزالي: " فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي، والدفع عن الحاضر الراهن، وليس لآحاد الرعية إلا الدفع أي إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية ". سادسا: الوجوب مرتبط بالقدرة والمصلحة ارتباط الوجوب بالقدرة من الأمور المعلومة بالضرورة من التكاليف الشرعية، إذ أن القدرة شرط عام فيها كلها لقوله عز وجل ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة 286] وقال ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [ التغابن 16 ] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ". والتدرج المذكور في حديث الإنكار من اليد إلى اللسان إلى القلب يدل على اعتبار القوة في هذه الفريضة، بحيث من الممكن أن يسقط التكليف باليد واللسان، بخلاف القلب الذي لا يسقط التكليف به لعدم تصور العجز عنه، حيث لا سلطان لأحد من الناس في حب القلب وبغضه، بحيث يمنعه أو يهدد صاحبه. والقدرة لا تنتقص بالعجز البدني والحسي فحسب، ولكنها أيضا تنتقص بالخوف من المكاره التي تلحق بالمحتسب في نفسه أو ماله أو أهله أو غيره من المعصوم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ما عدا الأذى الخفيف الذي لا يسلم منه أي متعامل مع أصحاب المنكرات مثل السب والشتم والتهويش ونحو ذلك، قال ابن رجب - رحمه الله - : " من خشي الإقدام في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، ومتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو أخذ المال سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك " ولكن ينبغي التنبيه هنا على مسألة هامة حتى لا يفهم الكلام بالخطأ ويكون مدعاة للنكول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أن فضيلة الصبر على الأذى والتغرير بالنفس في إعزاز كلمة الدين وإجلال رب العالمين من أعظم أبواب الشهادة وأعلاها وأفضلها بنص حديثه صلى الله عليه وسلم: " سيد الشهداء حمزة، ورجل قام على سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله " وقوله: " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وقد اتفق القائلون بسقوط الوجوب عند الخوف على بقاء الاستحباب والندب لمن قوي على تحمل المشاق، إذا كان لإنكاره تأثير في إزالة المنكر أو كسر جاه الفاسق، أو تقوية أهل الديانة، أو إحياء لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبقى أيضا أن من كان عنده قدرة واستعداد للبذل والفداء بنفسه لا يلزم غيره بذلك أو يوجبه على عموم المسلمين. أما ارتباط هذا الوجوب بالمصلحة أو غلبة الظن عليها، فالمقصود إلا يؤدي الأمر والنهي إلى مفسدة أعظم هي أسخط وأشد من مفسدة إضاعة هذا المعروف أو التلبس بهذا المنكر، فالشريعة مبناها على تحقيق أكمل المصلحتين، ودفع أعظم المفسدتين عند التعارض، وهذا مستقى من فعله صلى الله عليه وسلم عندما رفض قتل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ونهيه عز وجل عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، وامتناعه صلى الله عليه وسلم عن إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " من تأمل ما جرى في بلاد الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا ألأصل، وعدم الصبر على منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في مكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح مكة وصارت دار الإسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام، كونهم حديثي عهد بكفر ". فإنكار المنكر له أربع درجات: الأولى: أن يزول أو يخلفه ضده الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة: أن يتساويا الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه فالدرجة الأولى والثانية مشروعة مندوبة، والدرجة الثالثة مورد اجتهاد، أما الرابعة فهي الممنوعة المحرمة. متغيرات قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تنحصر دائرة متغيرات هذه القضية في مسألة انعدام الجدوى، بمعنى إن غلب على ظن المحتسب أن أمره ونهيه لا فائدة من ورائه، هل يؤدي ذلك لسقوط الوجوب لهذه الفريضة أم لا ؟ فمن أهل العلم من ذهب لإسقاط الوجوب في هذه الحالة، وإن كان يستحب التذكير بالأمر لرفع منار الدين وإظهار لشرائع الإسلام، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وكثير من الصحابة - رضوان الله عليهم -، وهو قول جمعة من أهل العلم منهم الأوزاعي والغزالي وابن العربي والعز بن عبد السلام وأحد الروايتين عن أحمد. واستدلوا على ذلك بما ورد في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العامة "، وما أخرجه أبو داود في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ ذكر الفتنة فقال: " إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم وكانوا كذلك، وشبك أصابعه، فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك ؟ فقال: " الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة ". ومنهم من ذهب إلى وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يقبل منه ذلك، لأنه مطالب بذلك وليس مطالب بالقبول أو الرفض، وقد استدلوا على ذلك بخبر القرية التي كانت حاضرة البحر في سورة الأعراف، وخبر الذين أنكروا على المعتدين في السبت، رغم يأسهم من استجابة قومهم لهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم قال النووي رحمة الله: " قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه ألأمر والنهي لا القبول، كما قال الله عز وجل ( ما على الرسول إلا البلاغ ) "
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
قضايا دعوية معاصرة (3) الاجتهاد والتقليد شريف عبدالعزيز لقد كان من الإيجابيات الكبرى التي تذكر للعمل الإسلامي المعاصر أنه كسر حاجز التقليد الذي ظلت الأمة حبيسة أسواره وأغلاله لقرون عديدة، تراجعت خلالها قيمة وأثر وفعالية الفقه الإسلامي في الحياة العامة، حيث جمدت الأمة عند أقوال وآراء واجتهادات قرون خلت، فجاء العمل المعاصر ليحمل على عاتقه إرجاع الأمة لمنابعها الأولى في العمل بالأدلة الشرعية، وأزال الغبار عن كتب الحديث والسنة، بعد أن كادت أن تندثر وينساها الناس، في ظل اشتغال الأجيال المتتابعة بكتب الفقه والشروح والمتون والفروع، وجددوا العمل بفقه الحديث ودراسته وأعادوا مجالس التحديث للحياة، حتى عادت للسنة مكانتها ومنزلتها اللائقة. ومع عودة دراسة الحديث والسنة، عاد الكلام عن قضية تاريخية من قضايا العمل الإسلامي؛ إلا وهي قضية الاجتهاد والتقليد، والشد والجذب بين أنصار كل فريق، والغلو الذي حدث في القضية من كل جانب، حتى صار الأمر إلى غلو مفرط وتنطع قبيح، بين من ينكر كل صورة من صور التجديد، ولا يرى إلا وجوب الإتباع للإنتاج العلمي والفقهي لسلف الأمة، والدوران في فلك مقالات الأولين، وبين من فتح باب التجديد على مصراعيه مشرعا لكل والج، ونودي بالتجديد في كل شيء حتى في الكليات والقطعيات المحكمات، بصورة أهدرت معها كل النقولات بدعوى التجديد والاستنارة وإعمال العقل. لذلك كان من الضروري وضع الضوابط العامة الحاكمة لعملية الاجتهاد والتقليد، وتميز الثوابت من المتغيرات في هذه القضية الهامة، حتى لا نتجاوز محكما مقطوعا به تحت دعوى التجديد أو الإحياء، أو تتهارج الصفوف بسبب الخلاف في أمور ظنية متشابهة تحت مسمي التمسك بالأصول وآثار السلف، وفي النهاية جمع الكلمة على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع. ثوابت قضية الاجتهاد والتقليد: أولا: محل الاجتهاد في كل ما لم يرد به النص، فكل ما ورد في النص القاطع الصريح، وكل ما أجمعت عليه الأمة وتلقته بالقبول؛ فهو من الأمور التي لا يسوغ الاجتهاد فيها، حيث لا يحل لأحد خرق ومخالفة النص والإجماع الثابت كائنا من كان، والواجب فيه هو الإذعان والإتباع، قال تعالي: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) [ الأحزاب 36 ]، وقال تعالى: ( ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) [ النساء 115 ]. قال الغزالي - رحمه الله - في المستصفى: " والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما، كوجوب الصلوات الخمس والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف، فليس ذلك محل اجتهاد ". ثانيا: عصمة الإجماع، حيث أنه لا عصمة لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم - إلا لما أجمعت عليه الأمة وتلقته بالقبول، واستقر عبر الأجيال، وقد اتفقت كلمة العلماء على ذلك، وكلامهم أشهر وأكثر من ذكره في هذا المقام. ثالثا: لا إثم على المجتهد ولو أخطأ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر "، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - - رحمه الله - -: " ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ "، وقال الآمدي في الإحكام: " اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية "، وقال ابن القيم - - رحمه الله - -: " وأما الحكم المؤول، فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب إتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا: اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة، قال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءني بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه، .... ". رابعا: ترك الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية، فهذه المسائل لا ينكر فيها على المجتهد لا باليد، ولا بالقدح، أو النيل من دين المجتهد وعدالته، إنما يرد عليه بالآيات البينات والحجج العلمية، فمن بان له رجحان أحد القولين عمل به، قال النووي - رحمه الله - في معرض شرحه لحديث مسلم " من رأي منكم منكرا فليغيره بيده " وبيان مراتب الناس في هذا الإنكار: " ثم العلماء لا ينكرون ما أجمع عليه الأئمة. وأما المختار فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر ". مع مراعاة أن المقصود بالخروج من الخلاف من هذا المقام هو العمل بالأحوط، أي الإتيان بالفعل على وجه يكون موضع اتفاق الجميع. والسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر يجعل من هذا المعنى قاعدة من قواعد الفقه بالكلية، فيقول: " لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه " مع عدة استثناءات ذكرها في الإنكار على المختلف فيه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تقليد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، هل ينكر عليه أو يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين، فأجاب: " الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين "، وقال ابن القيم: " والصواب الذي عليه الأئمة، أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل، يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها ـ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به ـ الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها ". قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: " والمنكر الذي يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا " وقد قرر هذا الأصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل العقيدة أيضا فقال: " فكون بعض العلماء يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور: إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ". رابعا: الاختلاف في الفرعيات ليس مقبولا بإطلاق، بل منه ما هو مقبول، ومنه ما هو مذموم، فما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه، لا يحل الاختلاف فيه لمن علمه، والاختلاف عندها مذموم، وما كان يحتمل التأويل ويدرك قياسا فهو من مسائل الاجتهاد التي يقبل فيها الاختلاف ولا تثريب على العامل بأي الأقوال وقتها، ومن هنا يستبان خطأ من أطلق القول بأن الخلاف شر كله، أو رحمة كله، ففيه من الرحمة عند التوسعة على المكلفين، وفيه من الشر العظيم عند الشقاق والتدابر والبغي على المخالف، قال ابن تيمية: " والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابا سماه ( كتاب الاختلاف ) فقال أحمد: سمه ( كتاب السعة )، ونقل عن بعض العلماء أنه كان يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة "، وقال الجصاص في الأحكام: " وقد يختلف المجتهدان في نفقات الزوجات، وقيم المختلفات وأروش كثير من الجنايات، فلا يلحق واحدا منهما لوم ولا تعنيف وهذا حكم مسائل الاجتهاد. ولو كان هذا الضرب من الاجتهاد مذموما لكان الصحابة من ذلك الحظ الأوفر، ولما وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متواصلون يسوغ كل واحد منهك لصاحبه مخالفته من غير لوم ولا تعنيف ". خامسا: زلة العلماء مغفورة ولا يعتد بها، لأنها لم تصدر إلا عن اجتهاد معتبر، بل هي نتاج خفاء بعض الدليل، أو عدم ثبوته عنده، لذلك لا يشنع عليه بها أو يقلل من قدره، أو يهدر علمه وآراءه بسبب زلته تلك، قال الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات: " إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا لو كان معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب صاحبها إلى الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن ذلك خلاف ما تقتضي رتبته في الدين ". قال ابن القيم في إعلام الموقعين: " ومن له علم بالشرع والواقع، يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ". قال الحافظ الذهبي كلمات ذهبية مثل علمه وكتبه في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي - رحمه الله -: " ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه وبدّعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ". خامسا: الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر من أهله، فلا يعتبر الاجتهاد شرعا إلا إذا صدر ممن استجمع أدوات الاجتهاد، وأهل الاجتهاد هم الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وإلا كانت عملية الاجتهاد ألعوبة في يد العابثين والمحرفين، ومن اجتهد بغير أدوات الاجتهاد كان متبعا لهواه، عاصيا لمولاه، لا يتابع ولا يعتبر، قال تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) [ ص 26] . سادسا: التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، وذلك لقوله عز وجل: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [ النحل 43] وهذا نص قرآني يحتم على الجاهل الرجوع لأهل الذكر وسؤالهم عما لا يعلمه، وكذا حديث الشجة الشهير وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال " رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، وأن التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد ". قال ابن قدامة -رحمه الله -: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع " وقال " وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل وفي الفروع أيضا، وهو باطل بإجماع الصحابة ". قال الرازي في المحصول: " يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد ". وهنا يأتي الحديث عن مسألة أخرى متفرعة من هذا الأصل، وهي وجوب إتباع المقصر الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد لإمام من الأئمة، وذلك حتى لا ينفرد بفهم ليس له فيه سابقة في مسألة من المسائل، وإلا عدّ مبتدعا في الدين، ومتبعا لغير سبيل المؤمنين من حيث لا يدري. سابعا: التقليد نوعان مشروع وممنوع، فالمشروع هو عمل العامي بمذهب المجتهد دون معرفة دليله معرفة تامة، أما الممنوع فهو التقليد التي قامت الأدلة البينة على خلافه، أو تقليد إمام بعينه دون سواه، بحيث تقبل جميع آرائه وإن تبين مخالفتها للحق، وترد أقوال غيره من الأئمة، وإن شهدت لصحتها النصوص. وعلى هذا جوّز العلماء دراسة الفقه على الطريقة المذهبية بشرط عدم التعصب، كما استحسنوا ذكر الأدلة للمستفتي إذا كان أهلا لفهمها، وإن كان ذلك ليس شرط واجب النفاذ على المفتي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: " ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب ،... وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري ". وقال الشاطبي: " فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة للمقلد وعدمها سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز لهم ألبتة ". ويتضح كلام الشاطبي من تتبع كتب الحديث حيث يري استدلال التابعين الصغار بأقوال من قبلهم من التابعين الكبار، وهؤلاء يستدلون بأقوال وأعمال من قبلهم من الصحابة، وهي أقوال وأفعال لم تذكر أدلتها، فدل ذلك على عدم اشتراط ذكر الأدلة لصحة الفتوى، أو جواز العمل بها، فإيراد الأدلة للعامي لا يخرجه من دائرة التقليد من الناحية العلمية. أما ما ورد من عبارات الأئمة و العلماء في النهي عن التقليد، والاحتياط في الدين، فهي عبارات ذات دلالات، ويجب أن تنزل على وجهها الصحيح، فهي سيقت في سياق نهي الناس عن الإتباع فيما قامت الأدلة على خلافه، وعلى ما تبين للجميع فساده وبطلانه، وفي سياق دعوة من يمتلك أدوات الفهم والتحصيل لئن يبحث وينظر في الأدلة ويرتقي في العلوم والمعارف، وفي سياق النهي عن التعصب المذموم الذي يفضي لتقديم قول الإمام والمجتهد على النصوص الشرعية، قال الإمام مالك - رحمه الله-: " يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة ". وقال العز بن عبد السلام - رحمه الله - بعد إنكاره التقليد وبيان بطلانه: " ويستثنى من ذلك العامة، فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم ". ثامنا: الدليل الصحيح السالم من المعارضة لا يجوز رده مطلقا، فلا يرد لقول أحد من الناس مهما كانت درجته ورتبته، وإلا كان ذلك إخلالا بأصل الدين، قال تعالى: ( اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ) [ التوبة 31 ]، وقد أخرج الترمذي في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ " قال: قلت: بلى. قال: " فتلك عبادتهم " قال ابن تيمية: " وهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: الأول: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء. والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، ولكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، ... ثم ذلك المحرم للحلال، والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده إتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه ".
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
قضايا دعوية معاصرة (4) الإيمان والكفر شريف عبدالعزيز لقد كان الخلاف في حقيقة الإيمان أول خلاف نشأ بين أهل القبلة، وأول نبتة للبدع الغليظة كانت يوم أن خرجت طائفة من المؤمنين متبنية لبدعة التكفير بمطلق المعصية، فاستحلوا دماء مخالفيهم، وقاتلوا الأمة أشد ما يكون القتال، بل كان شعارهم؛ ترويع وقتل أهل القبلة وترك وتأمين أهل الشرك والكفر. ومنذ أن ظهرت بدعة التكفير على يد الخوارج ومسلسل البدع لم يتوقف في الأمة، إذ ظهرت المرجئة ثم القدرية ثم الجهمية ثم الجبرية وهكذا، وهذا الشطط جميعه بدأ مع الانحراف في تعريف حقيقة الإيمان، بين من يجعل الإيمان حقيقة كلية تذهب كلها بذهاب أو نقصان بعضها، فيضم العمل بقسميه من حقيقة الإيمان، وبين يجعل الإيمان قول لا عمل، ويخرج كل الأعمال من مسمى الإيمان، ثم توالت الانشطارات والانشقاقات لوقتنا الحاضر. ومن هنا نقول أننا في أمس الحاجة لتحرير حقيقة الإيمان بأن نميز المحكم من المتشابه، وموضع الإجماع من محال النزاع، حتى لا تختلط الأمور فنترخص في المجمع عليه، وننكر في مجتهد فيه. الثوابت والمحكمات في قضية الإيمان: أولا: نصوص الشرع هي الضابط الوحيد لتحرير المصطلحات، فالإيمان والكفر وغيرهما من الألفاظ والمصطلحات الشرعية يجب أن يرجع في بيانها وضبطها إلى الكتاب والسنة والآثار السلفية، فقد بيّن النبي -- صلى الله عليه وسلم - - المراد من هذه المصطلحات والألفاظ بصورة كاملة لا يحتاج معها لشواهد أو اشتقاقات من أجل الاستدلال عليها، لذلك عند الاختلاف لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وبيان الله ورسوله فيهما فهو شاف كاف. قال ابن تيمية - - رحمه الله - -: "وما ينبغي أن يعلم، أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ". ثانيا: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، والمقصود بالقول هنا هو قول القلب: وهو تصديق القلب، وإقراره، ومعرفته. وقول اللسان: وهو النطق بالشهادتين، والإقرار بلوازمهما. والمقصود بالعمل عمل القلب: وهو قبوله، وانقياده، ومحبته، وإخلاصه. وعمل الجوارح: وهو سائر ما افترض الله - عز وجل - على عباده من أعمال الجوارح. قال الإمام البخاري - رحمه الله -: " لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أن أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ". وقد نقل اللالكائي هذا المعنى في اعتقاد أهل السنة عن الأئمة الأعلام مثل الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم كثير. ثالثا: أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للأمر، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر بلا أدنى ريب، ولذلك لم يعتبر يهود المدينة مثل حي بن أخطب وغيره مسلمين باعترافهم بنبوة الرسول- صلى الله عليه وسلم -، لأنه اعتراف بمعنى الاخبار لا بمعنى الاقرار والانقياد، فمجرد العلم والإخبار عن هذا العلم ليس بإيمان، حتى يظهر ما يتضمن الإقرار والانقياد، بالقول والفعل، فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا في ميزان الشرع كافرين معاندين في الباطن. وأبو طالب عم النبي- صلى الله عليه وسلم - قد استفاض عنه العلم بنبوة ابن أخيه، وأنشد في ذلك أشعارا سائرة، ولكنه امتنع عن الإقرار بالتوحيد، حبا لدين آبائه وأجداده، ومخافة من معايرة قومه له ولولده، فمات كافرا. قال ابن تيمية - رحمه الله-: " ومعلوم أن الإيمان هو الانقياد، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب وهو الانقياد، تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر، كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به، والعبادة له، والكفر هو عدم الإيمان، وسواء كان معه تكذيب، أو استكبار، أو إباء، أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر ". قال ابن القيم - رحمه الله -: " فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبنيه، بل هو معرفته المستلزمة لإتباعه والعمل بموجبه، وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمى تصديقا، فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته ". رابعا: التولي عن تحكيم الشريعة كالتكذيب بها، وكلاهما كفر أكبر مخرج من الملة، وهذه حقيقة نابعة من أصل أن الإيمان هو الإقرار والانقياد، فمن لم يحصل له من ذلك شيء فهو كافر أصلي، لذلك كان رد الحكم الشرعي والامتناع عن قبوله والالتزام به دينا يعبد الله - عز وجل - به، وحكما واجب الإتباع في موارد النزاع، كان من الكفر الأكبر، قال تعالى: ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) [ البقرة 34]، فلم يكن كفر إبليس عن تكذيب، ولكن عن امتناع واستكبار. قال تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) [ النساء 65 ]. قال الإمام الجصاص في تفسير الآية: " وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله – تعالى -، أو أوامر رسوله- صلى الله عليه وسلم - فهو خارج عن الإسلام، وسواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة بارتداد من امتنع من أداء الزكاة، قتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله - تعالى - حكم بأن من لم يسلم للنبي- صلى الله عليه وسلم - قضاءه وحكمه، فليس من أهل الإيمان ". لذلك حكم الصحابة على مانعي الزكاة بالارتداد وقاتلوهم عليها. ويعتبر القوانين الوضعية البشرية من أبرز صور التولي عن قبول الحكم الشرعي، ومعظم هذه القوانين تهدر وتبطل الأحكام الشرعية، حتى وإن وجد تشابه بين الحكمين في بعض أجزائه، إلا إن المرجعية في النهاية تكون للقوانين الوضعية، وهو عين الامتناع عن تطبيق شرع الله. خامسا: الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله، فالشريعة الإسلامية مليئة إلى حد التواتر بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار السلفية الدالة بمنطقوها ومفهومها على هذا الأمر، نذكر منها طرفا بسيطا: قال تعالى: ( ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ) [ الفتح 4]، ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) [ الأنفال 2 ]، ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ) [ التوبة 124]. وفي أحاديث الشفاعة روايات كثيرة بأن الله - عز وجل - سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ومثقال برة، ومثقال شعيرة، ومثقال خردة، وهكذا. سادسا: الكفر كفران، ناقل عن الملة، وغير ناقل، فأما الكفر الناقل عن الملة، فضابطه عدم الإقرار بشيء مما أنزل الله، من باب التكذيب والرد. وأما الكفر غير الناقل، ويسمى كفرا أصغر، وهو ما ورد في نصوص الوعيد التي اتفق أهل العلم على أنها لا تخرج من الإيمان إلا بالاستحلال، مثل الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، وقتال المسلمين. ومثل هذا التقسيم ينطبق على سائر ألفاظ الذم: " من النفاق والشرك والظلم والفسق ونحوه ذلك، حتى أن الإمام البخاري عنون في كتابه الصحيح بابا لذلك سماه: باب كفران العشير وكفر دون كفر، وساق فيه قوله- صلى الله عليه وسلم -: " أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن " قيل: " أيكفرن بالله يا رسول الله ؟ قال: " يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط ". قال ابن تيمية: " والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان: أصغر، وأكبر ". سابعا: ثبوت عقد الإسلام لكل من أقر بالشهادتين حتى يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام، والإقرار المقصود في هذا المقام، هو الإقرار الالتزامي الذي يقصد به الإجابة إلى الإيمان، وليس مجرد الإقرار الخبري الخالي من قول القلب، كما هو حال كثير من علماء الغرب في الفيزياء والكون، عندما يرون إعجاز القرآن الكريم فينطق بعضهم بما يعد إقرارا، مع بقائه على دين قومه. قال النووي - رحمه الله -: " واتفق أهل السنة، من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يخلد في النار، ولا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق الشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنا ". والناقض المشار إليه قد يؤدي إلى سقوط ركن التصديق إذا كان تكذيبا وإنكارا، وقد يؤدي إلى سقوط ركن الانقياد إن كان ردا وإباء واستكبارا. ويحتاج تحقيق ذلك في معين إلى التحقق من توافر شروط وانتفاء موانع. وهذا يقتضي أيضا وجوب التحقق إذا حدث لوث في دلالة الشهادتين على الإقرار المجمل بالإسلام، فإن حدث لوث في دلالة الشهادتين على الإجابة إلى الإيمان، وإرادة الدخول في الإسلام، وجب التحقق، ويكفي عن قائلهما ويتثبت من أمره، حتى يستوفي منه ما يدل على إقراره المجمل بالإسلام، براءته من كل دين يخالفه. قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب " الأم ": " والإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان، ومن لا دين نبوة وكتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقد أقر الإيمان، ومتى رجع عنه قتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية، فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى - صلوات الله وسلامه عليهما -، وقد بدلوا منه، وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد- صلى الله عليه وسلم -، فكفروا بترك الإيمان به وإتباع دينه، مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. فقد قيل لي: إن فيهم من هو مقيم على دينه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقول: لم يبعث إلينا، فإن كان فيهم أحد هكذا لم يكن مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: وأن دين محمد حق أو فرض، وأبرأ مما خالف دين محمد- صلى الله عليه وسلم - أو خالف دين الإسلام، فإن قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان، فإن رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل " والذي يتدبر مقولة الشافعي يجد أن مناط الإيمان عنده هو القبول المجمل للإسلام والبراءة المجملة مما يخالفه، ومتى نطق الإنسان بالشهادتين ثبت له عقد الإسلام بيقين. قال القاضي عياض - رحمه الله - ، كما نقل عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم: " اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا الله، تعبيرا عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان، ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى في عصمته بقوله: لا إله إلا الله. إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: " وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ." وكلام عياض متوافق تمام الموافقة مع كلام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. ونقل الحافظ ابن حجر نفس الكلام بمعناه عن البغوي ناصر السنة، وهو قول سائر علماء أهل السنة. مع مراعاة بقاء القاعدة الشرعية: إذا وردت الشبهة على الإقرار المجمل بالإسلام فقد وجب التحقق. كما هو الحال في المجتمعات التي تكثر بها النحل الكفرية مثل القاديانية والبهائية والنصيرية وغير ذلك. ثامنا: التلازم بين الظاهر والباطن في قضية الإيمان، فالقلب إذا كان عامرا بالإيمان، فلابد أن ينطبع ذلك على أعمال الجوارح، بالاستقامة على أمر الله عز وجل، وإذا كان القلب فاسدا كان الظاهر فاسدا، إلا أن يكون منافقا، يبدي ما لا يبطن، ولا يتصور وجود الإيمان في القلب مع انعدام جميع أعمال الجوارح. وفي الحديث :" ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ". فمتى نقصت الأعمال الظاهرة دل ذلك على نقصان الإيمان في القلب، ومتى زادت كان ذلك لزيادته، ولهذا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع آية على ما في الباطن، فإن كان الظاهر فاسدا حكم على الباطن بذلك، وعلى هذه القاعدة تدور كلية التشريع وعمدة التكليف في إقامة حدود الشعائر الإسلامية. قال ابن تيمية: " وإذا قام في القلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك، من الأقوال والأفعال الظاهرة، ..، كما أنه ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه ". قال ابن رجب في جامعه للعلوم والحكم: " وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإراداته، فإن كانت حركته وإراداته لله وحده، فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركات القلب وإرادته لغير الله، فسد وفسدت حركات الجسد، بحسب فساد حركة القلب " وممن هذه الثوابت والمحكمات السالف ذكرها يتضح لنا عدة مسائل هامة في باب الإيمان منها: 1 ـ أن من اقتصر في تعريف الإيمان على التصديق، من أهل السنة ومن عامة المرجئة، كان مقصوده التصديق الانقيادي المستلزم لقبول الأحكام والتزام الشرائع، فلم يؤثر إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان، وقصره على مجرد التصديق الخبري إلا الجهمية، وقد أجمع العلماء على تكفيرهم بهذه المقولة. قال القسطلاني في تعريف الإيمان: " وهو لغة التصديق. وهو كما قال التفتازاني: إذعان لحكم المخبر وقبوله. فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر، من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم ". قال ابن القيم: " ونحن نقول: الإيمان هو التصديق. ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا، لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح، واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم، مؤمنين صادقين،. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما، اعتقاد الصدق. والثاني، محبة القلب وانقياده ". قال الكمال بن الهمام الحنفي: " فلابد في تحقيق الإيمان من المعرفة، أعني إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع. ومن أمر آخر: هو الاستسلام الباطن والانقياد لقبول الأوامر والنواهي، المستلزم ذلك الاستسلام والانقياد للإجلال، أي إجلال الإله تعالى، وعدم الاستخفاف بأوامره ونواهيه ". قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية: " والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق، ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان الكفر أعظم، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان، يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق ". 2 ـ بطلان ما ذهب إليه الخوارج والمرجئة من القول بأن الإيمان معنى واحد، لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ذهب بعضه، ذهب كله، وهو الأمر الذي أدى بالخوارج والمرجئة إلى نقيضين، فالخوارج أدخلت جميع الأعمال في أصل الإيمان تعلقا بظواهر نصوص الوعيد، والمرجئة أخرجوها جميعا عن مسمى الإيمان تعلقا بظواهر نصوص الوعد، ولا يستفاد من كلام كل فريق إلا بطلان ما ذهب إليه الفريق الآخر. قال ابن تيمية: " إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء، ثم قالت المعتزلة والخوارج: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. وهو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه، ولم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه، لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه، وبقاء بعضه ". 3 ـ الإيمان ينتقض بالردة، كما ينتقض الوضوء بالحدث، الردة تكون بمفارقة ملة الإسلام بالكلية إلى ملة أخرى أو الإلحاد البحت، وتكون أيضا بعدم الإقرار بشيء مما أنزله الله، تكذيبا أو ردا، وعقوبة المرتد إذا أصر بعد الاستتابة وإقامة الحجة الرسالية والإمهال ثلاثة أيام هي القتل، وعدم إجراء أحكام الإسلام عليه بعد موته، من الغسل والدفن في مقابر الإسلام، قال- صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه ". 4 ـ عدم تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب إلا بالاستحلال أو الجحود، فقد اتفق أهل السنة على أن المعاصي هي بريد الكفر، ومن إرث الجاهلية، إلا إن صاحبها لا يكفر بإتيانها إلا على وجه الاستحلال، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، إن شاء عفا، وإن شاء عذب، ولا نشهد لهم بكفر في الدنيا، ولا بمنزلة بين المنزلتين، كما لا نحكم عليهم بخلود في النار كما ذهبت المعتزلة والخوارج، والاستحلال تارة يؤول إلى كفر التكذيب، تارة يؤول إلى كفر الرد، وذلك كله يعود على أصل الإيمان بالنقض. والأدلة على ذلك كثيرة، فالشريعة قد فرقت بين الشرك والكفر من ناحية، وبين بقية الذنوب من ناحية أخرى، قال تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء 48]. وقوله ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) [ الحجرات 7 ]، ففرق الله - تعالى - في الآيات بين الكفر والشرك والفسوق والعصيان. ومنها تفريق الشريعة لعقوبة المرتد المقررة لمن وقع في الكفر والشرك، وبين العقوبات المقررة للمعاصي من جلد ورجم وقطع وقتل، في حين أن عقوبة الردة واحدة وهي القتل، ومنها أحاديث الشفاعة الكثيرة والمتواترة، وفيها أن الرسول- صلى الله عليه وسلم - قد ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وآثار الأئمة والعلماء من السلف والخلف على ذلك كثيرة، قال أحمد - رحمه الله -: " ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله - عز وجل - ". وقال ابن المديني: " ومن لقيه مصرا، غير تائب من الذنوب التي قد استوجبت بها العقوبة، فأمره إلى الله - عز وجل -، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ". قال أبو زرعة: " ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ". قال النووي: " واعلم أن مذهب أهل الحق، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، لا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، فيّعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل، أو غير ذلك، من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة "
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
قضايا دعوية معاصرة (5) الجهاد شروطه وثوابته وضوابطه شريف عبدالعزيز الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وأعظم شعائره، وهو التجارة الرائجة، والدرجة الفائقة، رتب الله عز وجل للقائمين به من الثواب والثناء في الدنيا والآخرة، ما لا يساويه أو يدانيه عمل مثله، ودرجة المجاهد في سبيل الله كدرجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر، وهي درجة غير متصورة، لاستحالة بقاء الإنسان عمره كله صائما قائما، وذلك من عظم المثوبة. قال تعالى: (لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [سورة النساء: الآية 95-96 ]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ". إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الأمر بالجهاد وبيان فضله من الكتاب والسنة. والجهاد شريعة قديمة جاءت به الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كليم الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام خرج ببني إسرائيل بعدما نجاهم الله من فرعون وجنوده، خرج بهم إلى بيت المقدس ليخلصهم من أيدي الجبابرة الكفار، قال تعالى حكاية على لسان موسى عليه السلام: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ العَالَمِينَ يا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) [سورة المائدة: الآية 20-21]. وكذلك سليمان عليه السلام لَمَّا بلغه أن بلقيس تملك قومها، وأنهم يسجدون للشمس من دون الله ويشركون بالله، راسلهم، فأهدوا إليه هدية ليستكشفوا شأنه، هل هو يريد طمعا دنيويا أو هو جادٌّ في القتال، أرسلوا إليه بهدية، فعند ذلك أظهر سليمان عليه السلام القوة والشجاعة (قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهَُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) [سورة النمل: الآية 36- 37]. ومفهوم الجهاد الشرعي مفهوما واسعا يشمل كل نصرة لدين الإسلام، سواء أكان نصرة لدين الإسلام باليد، والسِّنَان، والقوة، ومقاتلة الأعداء الذين يعتدون على المسلمين، ولا يمكنونهم من اعتناق دينهم، والسير على تعاليم دين الإسلام، ويشمل ذلك أيضا الدعوة لدين الله، والذب عن محارم الله باللسان، كما ورد في المسند وسنن النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ "، فدل ذلك على مشروعية الجهاد باللسان، ولا يكون ذلك إلا بالدعوة لدين الله، وببيان محاسن هذا الدين، وعظم الفوائد التي يحصل عليها العباد في آخرتهم من اعتناقهم لدين الإسلام.وهناك مجاهدة المنافقين كما قال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ) [سورة التوبة: الآية 73]، ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان معه في المدينة عدد من المنافقين، وقد أخبره الوحي بأن هؤلاء من المنافقين، فماذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم حتى نعرف مدلول هذه الكلمة؟ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُهَادِنُهُم، ويُجَادلهم، وكان يدعوهم، وكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم أحكام الشرع، ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويدرأ أفعالهم السيئة ما استطاع، وهذا هو مفهوم جهاد المنافقين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد ليس منحصرًا في القتال، فهو يشمل مجاهدة النفس على الإقدام على أنواع الطاعات، والبعد عن المعاصي، ويشمل مجاهدة الشيطان في وساوسه التي يقذفها في قلوب العبد، ويشمل جهاد المنافقين فيما يفعلونه بأهل الإسلام، من رغبة في تفريقهم وإبعادهم عن دينهم، ودلالتهم على الخير، وتحذير الناس من سوء ما يفعلونه، وباطن ما يضمرونه لأهل الإسلام، ويشمل أيضا جهاد الكفار المحاربين الذين يحاربون المسلمين، ويصدون عن دين الله، فهذا كله يدخل في أنواع الجهاد في دين الإسلام. ولكننا سوف نقتصر في هذا المقام عن جهاد خصوم الأمة وأعدائها. فالعمل الجهادي هو نهاية المطاف لكل العاملين لدين الله، فدولة الإسلام التي أقامها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تأت بالمفاوضات والاتفاقيات والمعاهدات، إنما قامت وتأسست بدماء وعرق الفئة المؤمنة التي جاهدت أعداء الدين الذين لم ولن يتخلوا أبدا عن عداوتهم للدين وأهله. ونظرا لأن العمل الجهادي كان وما زال أحد أهم وسائل التغيير المطروحة على صعيد العمل الإسلامي، فإن ترشيد هذا العمل ووضع أصوله وضوابطه، ومعرفة ثوابته التي لا يجوز التنازل عنها أو الترخص فيها، مهما كانت قسوة الضغوط والتحديات، وبين المتغيرات وموارد الاجتهاد التي تترك لاجتهاد كل فريق ـ يصبح أمرا في غاية الأهمية والضرورة، حتى لا تذهب الجهود الغالية سدى، أو تتحول الأعمال العظيمة إلى هبات وهوجات غاضبة، أو ردود أفعال عفوية، لا تقتل صيدا، ولا تنكأ جرحا، ولا تزيدهم إلا بعدا عن هدفهم السامي، وخصما من رصيدهم عند عموم الأمة. ومن أهم الثوابت في العمل الجهادي: أولا: مشروعية قتال الممتنع عن الالتزام بشعائر الله، فقد اتفقت كلمة السلف والأئمة الأعلام على مشروعية قتال من امتنع عن الالتزام بشعائر الإسلام، حتى يفيء إلى الحق ويرجع لأمر الله، وقد انعقد إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقد بوب البخاري في كتابه الصحيح بابا بعنوان: " قتال من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ". وقال الإمام مالك في موطئه: " الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه، كان حقا عليهم جهاده ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام رمضان أو حج البيت العتيق. وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع، بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة، مثل أن يلحدوا في أسماء الله وآياته،. ....، وأمثال هذه الأمور.قال تعالى: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) [ الأنفال 39 ]، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ". فالغرض الرئيس من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "، والله - جل وعلا - قال: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [سورة البقرة: الآية 190] أي: في طاعته ونشر دينه وإعلاء كلمته، فليس الغرض إذا هو التسلط على الناس، أو أخذ أموالهم أو سفك دمائهم، إنما الغرض هو إعلاء كلمة الله - سبحانه وتعالى - ونشر هذا الدين؛ لأنه دين البشرية الذي ارتضاه الله لخلقه، فجهاد الكفار من صالحهم؛ لأنهم ينقادون لدين الله وبذلك يحقنون دماءهم ويخرجون من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمة إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ "، وقوله: يدخلون الجنة في السلاسل. بمعنى أنهم كانوا يقاتلون ثم يؤسرون، ثم يمن الله عليهم بالإسلام فيُسْلِمون فيدخلون الجنة، ولو تركوا على كفرهم لدخلوا النار. فالجهاد فيه مصلحة للكفار؛ لأنه قد يكون سببًا لإسلامهم ودخولهم الجنة، وفيه أيضًا مصلحة للمسلمين وذلك بنشرهم دينَ الله من خلاله، مما يكون سببًا لحصول الأجر والثواب بما ينالونه من التعب والعنت وفي قوله تعالى دلالة على ذلك حيث قال: (وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ القَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ) [سورة النساء: الآية 104]. فالمسلمون يتحملون في الجهاد المتاعب والأخطار لإعلاء كلمة الله وإنقاذ البشرية من الضلال، فليس الغرض من الجهاد سفك الدماء كما يقول أعداء الدين المنفرون منه، وإنما المقصود منه هو مصلحة البشرية لتدخل في دين الله الذي به تسعد في الدنيا والآخرة، هذا هو الجهاد في سبيل الله - عز وجل -، وهذه بعض أحكامه وضوابطه، وهو من أعظم أصول الإسلام والعقيدة، فيجب أن يُفْهم هذا، لا أن يقال: لا جهاد في الإسلام، فالإسلام دين رحمة ودين تسامح مع الآخرين. نافين بذلك ما أمر الله به من تبليغ الدين من خلاله. ثانيا: استيفاء الشرعية، فالجهاد يصاحبه إراقة دماء واستحلال حرمات، وهو أمر عظيم في غاية الخطورة، ومن ثم كان لابد من التأكد بأن الخصم قد أتى بما يهدر دمه، وذلك بوضوح وجلاء وبعد إقامة الحجج الرسالية، حتى لا تبقى عنده شبهة يتعلق بها، ولم يبق له عارض من جهل أو تأويل أو إكراه معتبر، كما بين ذلك أهل العلم المعتبرون. فالشرعية المقصودة في العمل الجهادي هي موافقته للشرع، وأيضا من الشرعية القبول العام من الأمة لهذه الأعمال الجهادية، بمعنى عدم الإضرار العام بالأمة، وهذا يقتضي تحديد دائرة الأعداء، وحصار المواجهة ضدهم في هذه الدائرة، حتى لا تتسع دائرة المواجهة ويدخل فيها من لم يستعد لتبعات أمثال هذه الأعمال الكبيرة، فلا يجب أن تفضي الأعمال الجهادية إلى المساس بالمصالح العامة للأمة من المساس بأقوات الناس وأرزاقهم ومرافقهم الحيوية، لأنها في هذه الحالة تتحول إلى أعمال تخريب وعدوان على المال العام، وهو أكثر أموال المسلمين حرمة وعصمة. وأيضا من الأمور التي يجب توافرها لاستيفاء الشرعية؛ مراعاة العهود والمواثيق التي يعقدها أهل الإسلام، فإذا كان هناك عهد وميثاق، فإنه لا يجوز نقضه باسم الجهاد، وإذا خِيفَ من العدو أن يقاتل المسلمين في وقت العهد والميثاق فإنه حينئذ يُبَلَّغُونَ بانتهاء العهد والميثاق، كما قال سبحانه (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) [سورة الأنفال: الآية 58] يعني: حتى تكونوا جميعا على حال متساوية من العلم بإمكان غزو الآخرين لكم. فالشريعة قد نصت على وجوب التزام العهود والمواثيق في كثير من النصوص الشرعية، منها: قول الله - عز وجل-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [سورة المائدة: الآية 1]، وقوله (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [سورة الإسراء: الآية 34 ]. وجاءت الشريعة بالتحذير من الخيانة والترهيب منها، وبيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "، وجاء في الحديث الصحيح أن من خصال المنافق أنه: " إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ". ومما يتعلق بمراعاة العهود والمواثيق: أن الإمام الأعظم إذا عاهد قومًا، أو أَمَّنَهُم لزم من تحت يده أن يلتزموا بما صدر من الإمام من عهد وميثاق، ويحرم عليهم أن ينقضوا ذلك العهد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله-: " وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ، لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " ويدل على هذا المعنى ما وقع في صلح الحديبية، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح قريشًا على ترك القتال مدة، وكان فيه بعض البنود التي لم يرضها بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجز أحد من المسلمين أن يقول: إن ذلك الصلح إنما عقده الإمام فلا يلزمني، لأنني لم أعقده. ثالثا: سلامة الراية، فلا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية غير إسلامية، مهما كانت المبررات، فلا يقاتل تحت راية تدعو إلى عصبية أو قومية، فمن فعل ذلك فمات، فميتته جاهلية، والمسلم مطالب باعتزال كل هذه الرايات الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل تحت راية عَمِّيًّة، ينصر العصبية، ويغضب للعصبية، فقتلته جاهلية " صححه الألباني في الجامع الصغير ( 6442). ولو أكره المسلم على الاشتراك في مثل هذا النوع من القتال، فلو كان القتال ضد فريق من المسلمين، فلا يمكن بحال أن يشترك في قتال المسلمين، ولو كان في ذلك الرفض إزهاق نفسه، فالإكراه على القتل مرفوض إجماعا بين أهل العلم، إذ ليست نفسه أولى بالعصمة والصيانة من نفس أخيه المسلم الذي سيقتله. أما لو كان القتال ضد فريق من الكافرين يريدون استباحة ديار الإسلام، فعندها يسعه تجديد النية، وتخليصها لله عز وجل، باستحضار نية الجهاد الخالص لإعلاء كلمة الله عز وجل، ونصرة لدينه وأمته وعباده الموحدين، ولو قتل بعث على نيته الصالحة. رابعا: غلبة المصلحة، فالجهاد ليس عملا دمويا يستهدف سفك أكبر قدر من الدماء كما يحاول المستشرقون وخصوم الأمة تصويره في عقول أبنائه، إنما هو عمل يرتبط بالمصالح والمفاسد المتحصلة من ورائه، والمصلحة العليا المستهدفة من شعيرة الجهاد؛ إظهار الدين، وكف بأس الكافرين، والدفع عن المستضعفين من المسلمين، قال تعالى: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) [ الأنفال 39]، وقال تعالى: ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف باس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ) [النساء 84]. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله ". وعناصر تحقق المصلحة كثيرة منها: توقع الظفر. ومنها تأمين الذراري والضعفاء حتى لا يبطش بهم العدو نكاية في المجاهدين. ومنها القبول العام من الأمة لهذا العمل، حتى لا يستغله الخصوم في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. ومنها سلامة التوقيت من حيث الزمان والمكان لتقليل حجم الخسائر قدر المستطاع. ومنها القدرة على توظيف العمل في خدمة الدعوة الإسلامية، والتعريف بقضاياها، واكتساب أنصار جدد. ويجب أن يتم ذلك كله وفق حسابات دقيقة، يعدها فريق من المتخصصين والخبراء في كل المجالات بداية من الفقه وأصوله انتهاء بالجغرافيا والمناخ، شريطة أن يكونوا ممن عركتهم التجارب، وخبرتهم الخطوب، ممن تجاوز مرحلة الاندفاع والحماسة الزائدة، حتى يكون العمل مميزا سالما قدر المستطاع من العيوب والآفات. ومسألة تحقيق المناط في قضية غلبة المصلحة من موارد الاجتهاد الكبرى في العمل الجهادي، بين معظم لشأن الجهاد غير مبال بالعواقب والمخاطر والمفاسد مهما عظمت وعمت، وبين حذر وجل متردد في موارد الوضوح والإقدام. وجماع القول بين هذا الإفراط، وذاك التفريط، أن العمل الإسلامي عندما يكون في مقام اتخاذ الأسباب وحساب النتائج المتوقعة، يجب أن يكون في أدائه لهذا العمل واقعيا يزن الأمور بموازين البشر، ويتعامل في حدود السنة المعهودة في حياة البشر، فلا يقدم على عمل مليء بالعيوب والخروق، انتظارا لمعجزة من السماء تسد هذا الخلل، فهو يتعامل مع السنن والأسباب، في ضوء أوامر الشرع الآمرة باتخاذ هذه الأسباب، وفي نفس الوقت متوكلا على رب الأسباب وحده في تحقيق الظفر. خامسا: الولاية، وذلك في مجال المواجهة العامة، ذلك أن الأصل في الجهاد أنه من الأعمال الكبرى في الأمة، والتي تناط في الأصل ينظر الإمام لتعلقه بالمصالح العامة للأمة. قال ابن قدامة رحمه الله: " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ". فإن عدم الإمام وشغر الزمان عن سلطان شرعي، فالأمور عندها توكل إلى أهل الحل والعقد الذين يمثلون إرادة الأمة، ويعبر رضاهم واختيارهم عن رضا الأمة واختيارها، وهم في هذه الحالة جماعة المسلمين، ويعتبر لزومهم لزوما للجماعة، وإلى هؤلاء ترجع مهمات الإمام عند غيابه أو فقده. سادسا: الكفاية، فإعداد العدة من المقدمات الحتمية في فقه الجهاد، وقد اتفق على أصل اعتباره عامة المسلمين. قال تعالى: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [ الأنفال 60 ]. ولكن المنازعة تقع في مدى تحقق العدة الكافية التي تؤهل للقيام بهذا العمل بعينه، فلذلك الذي تتفاوت فيه التقديرات، وتتباين فيه الاجتهادات لتعلقه باستقراء الواقع، والوقوف على القوة التي تتوقع أن يقذف بها الخصوم في هذه المواجهة، والقوة اللازمة لدفعها وتحقيق الغلبة عليها، وكل ذلك من مجاري الاجتهاد، ومسائل الخبرة الفنية التي يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص في إطار من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة. وهنا ينبغي الكلام عن أحد القواعد الهامة في فقه الجهاد ؛ وهي " مراعاة حال القوة وحال الضعف ". فليس بخافٍ أن حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين ضعف وقوة، فقد كان حال الأمة عند بعثة النبي صلى الله عليه و سلم كانت ضعيفة، وكان لهذا الضعف الأحكام الشرعية الخاصة به، كعدم الجهر في الدعوة، وكالأمر بكف اليد وعدم القتال، وتأخر نزول كثير من الأحكام الفقهية. أما في العهد المدني، وبعد أن صار للمسلمين دولة وشوكة ومنعة، نزل الأمر بالقتال ومجاهدة المشركين المعتدين، ونزلت الأحكام الشرعية التفصيلية، وما ذاك إلا لأن الحال حال قوة ومنعة. ولذا ذهب أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال، وقد أشار ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه إعلام الموقعين إلى إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال. فالواجب هو التفريق بين فقه القوة وفقه الضعف، وإن كان هناك من أهل العلم من يقول إن الأحكام هذه نسختها آية السيف، لكن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك بل يربطون هذا بحال المسلمين، فإذا كان في ضعف نُزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزّلت عليهم أحكام غربة السنة، إذا كان في قوة تنزّل عليهم أحكام القوة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه و سلم: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ". وبقوله صلى الله عليه و سلم :" إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها". رواه أبو داوود. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول فيمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بأية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من الذين أتوا الكتاب والمشركين. وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله - عن شرط القوة في الجهاد: وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال, فان لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال هو إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة, ولهذا لم يوجب الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين القتال وهم في مكة , لأنهم عاجزون ضعفاء, فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية, وصار لهم شوكة أمروا بالقتال , وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط, وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات, لان جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ) [ التغابن 16] وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [البقرة 286].
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
قضايا دعوية معاصرة (6) التنوع والتعددية شريف عبدالعزيز الدعوة الإسلامية هي أشرف مهام المسلم، وأعلى درجات المؤمن، فهي نيابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمته، وخلافته في طريقته ومنهجه ووظيفته، بها اختص الله - عز وجل - صفوة خلقه. ومهما تكلمنا عن فضائل الدعوة الإسلامية، وفضل الدعاة، وما أعد الله - عز وجل - لهم من المثوبة والكرامة، فلن نوف الدعوة والدعاة حقهم الواجب. والأصل في هذه الأمة هو الوحدة بكل مفردات هذه الكلمة، أي وحدة في الجماعة، ووحدة في الراية، ووحدة القيادة، ووحدة المرجعية، وكل مظهر من مظاهر الخروج عن هذا الأصل، هو خلل طارئ يجب رده إلى أصله، ولا يكون الرضا به إلا من جنس قبول المضطر بالأمر الواقع، مع مواصلة السعي لاستصلاح الأحوال، والاجتهاد في تكميل المصالح، وتقليل المفاسد، تمهيدا للعودة إلى الأصل الثابت ؛ الوحدة الشاملة المتكاملة. ومع اتساع دائرة الحياة، وكثرة المستجدات فيها، وتنوع رايات خصوم الأمة، وتكالب أعدائها عليها، يتم كل يوم استحداث باطل جديد تحارب به الأمة الإسلامية، فلم يعد الأمر كما كان من ذي قبل؛ كأس وغانية، إنما أصبح للباطل دول ومؤسسات وإستراتيجيات وخطط ومناهج وكوادر تعمل ليل نهار من أجل محاربة الإسلام، وصد الناس عن سماع دعوة الحق بشتى السبل والوسائل. لذلك كان من الطبيعي أن تتعدد فصائل العمل الدعوي وتتنوع في مقابلة خصم تتنوع أساليبه وتتعدد بنادقه المصوبة في صدور أبناء الأمة. وهذا التنوع قد يكون مصدر إثراء للدعوة الإسلامية، وقد يكون مصدر بلاء تؤتى الأمة من قبله بصورة أشد مما تفعله نصال الخصوم. فالتعدد المحذور هو الذي ينشأ عنه التضارب والتباين في الرؤى السياسية، والاختيارات الفقهية بحيث يؤدي إلى التعصب، الذي يعقد على أساسه الولاء والبراء، والذي يفضي إلى تمزق العاملين وتدابرهم وفساد ذات بينهم، والذي يقود إلى رايات شتى وانتماءات متصارعة، وكيانات متحوصلة، وكلها أمور أفقدت الدعوة الإسلامية حلاوة الإنجاز، وأورثتها أدواء شتى ما زالت الأمة تعاني من آثارها وأعراضها الجانبية. أما التعدد المقبول أو الراشد فهو الذي يخلو من كل هذه الآفات المزمنة، وليس معنى هذا أن تكون جميع فصائل العمل الدعوي عبارة عن نسخة واحدة مكررة من بعضها البعض، لا خلاف بينها في أي شيء، ولكن تلك التي تحصر خلافاتها في دائرة الفروع ومسائل الاجتهاد، فالتعدد والتنوع وقتها يكون تعدد تخصص، وتنوع تكامل، يتنافس به الناس في الخيرات، كل حسب ما فتح الله - عز وجل - عليه من أبواب الدين والعلوم والمعارف، وذلك في إطار من التسامح والتناصح والتراحم والتغافر. لذلك كان لابد من وضع الثوابت والضوابط العامة لبقاء التنوع الدعوي في إطاره الراشد، بحيث تكون ظاهرة تعدد فصائل العمل الدعوي ظاهرة إيجابية، ومن أهمها: أولا: وحدة الأصول فالعمل الدعوي إذا ما كان مجتمعا على أصول واحدة من الدين، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والكتاب والسنة، وإجماع الأمة، بحيث ينحصر الخلاف في دائرة الفروع والمسائل الاجتهادية، عندها يكون قد جاوز العمل المتنوع عقبة كئودا، زلت عندها الأقدام، وتاهت عنها الأفهام. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لنفس المعنى فقال: " فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء، قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [ العنكبوت 69 ] وقال (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه) [ المائدة 15 ]، والتنوع قد يكون في الوجوب تارة، وفي الاستحباب تارة " ثم قال في موضع آخر بعد أن شرح هذه العبارة بعدة أمثلة: " فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء، فإنهم متفقون على أن الله أمر كلا منهم بالدين الجامع، وأن نعبده بتلك الشرعة والمنهاج، كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به، إما إيجابا وإما استحبابا، وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة، فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم، ولا أخطأ أحد منهم، بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا " هذا بالنسبة للأصول التي لا يسع أحد أن يخرج عنها أو يتنازل في التمسك بها مهما كانت الضغوط والإغراءات. أما الأمور الاجتهادية التي يتنازع فيها، فيقر لكل فصيل العمل باجتهاده، وقد شبهها ابن تيمية - رحمه الله - بتنوع شرائع الأنبياء من وجه دون وجه، فقال رحمه الله: " فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء، فإذا قصدوا بها وجه الله – تعالى - دون الأهواء، ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة، بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام، هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء، وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته الله وحده لا شريك له، وهو الدين الجامع. " ثانيا: حصر الاختلاف فلاشك أن وحدة الأصول المذهبية والاعتقادية من الأمور الأساسية في بناء مشروع التكامل الدعوي بين مختلف الفصائل الدعوية، وهذه الوحدة تقتضي حصر الاختلاف في دائرة الفرعيات والمسائل الاجتهادية، والعمل المستمر على بقاء أي خلاف بين الفصائل الدعوية في هذا النطاق. فمن الخطورة بمكان أن يتم تصعيد الخلاف في الفروع وموارد الاجتهاد إلى نطاق الأصول والكليات التي لا يسع أحد فيها التجاوز والتغافر، مما يقود للتفرق والاختلاف والتنازع، ومن هنا ينبغي اليقظة والبصيرة الدائمة والمتابعة المستمرة لكل ما يطرأ من قضايا ومستجدات ونوازل حتى يتم تنسيق المواقف المشتركة حيالها، ابتداء من توصيفها، وهل هي من جنس الفروع، أم جنس الأصول ؟ وذلك قبل الحكم عليها، واتخاذ موقف ما بشأنها، فالحكم على شيء فرع من تصوره، وإذا لم يتم التوصيف بدقة، تباينت الآراء واختلفت الفتاوى، ومن ثم وقع الخلاف والنزاع الذي نحذر منه. ثالثا: بقاء الألفة وإخوة الدين الأصل في العلاقة بين المؤمنين هو المحبة والإخوة والعصمة المتبادلة، فالمسلم أخو المسلم، والمؤمن مرآة أخيه، والمؤمنين مثلهم كمثل الجسد الواحد، لو أن المسلمين مع كل خلاف يقع بينهم تدابروا وتشاحنوا لم تبق ألفة ولا إخوة بينهم. ولو نظرنا لتاريخ الأمة الإسلامية وتراثها العلمي الزاخر بالاختلافات والتباينات لعلمنا أن الفضل في وجوده ابتداء بسبب ما كان عليه الأئمة الأوائل من سلف الأمة وصدرها من التغافر والتراحم والإخوة والمحبة المتبادلة، وما كانوا عليهم من إجلال بعضهم بعضا، والاقتداء بعضهم بعضا، ونهيهم أتباعهم هن التعصب لهم بغير الحق، وتأكيدهم الدائم على أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع، وأن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإن استطاعت فصائل العمل الإسلامي حاليا أن تبقى على تناصح وتآلف وتعاضد، وأن تعقد ولاءها وبراءها على أساس الإسلام لا غير، وأن تستأصل جرثومة التعصب المذموم من جسد العمل الدعوي، وألا تفرق بين المسلمين أو تمتحنهم بما لم يأمر به الله ورسوله ـ كما كانت تفعل المعتزلة وقت الخلفاء العباسيين ـ أو يتنابذوا بألقاب وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، عندها فقط يصل العمل لمرحلة الرشد الدعوي الذي يرقى بالعمل لأعلى درجات سلم الإنجاز. وإن آفة الآفات ونازلة النوازل وعلة العلل، في التعدد القائد في ساحة العمل الدعوي، يتمثل في عقد الولاء والبراء على أساس الانتساب لهذه الفصائل، والتفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في الشرع. رابعا: توحيد المواقف العامة هناك اختلاف جوهري بين تعدد فصائل العمل الدعوي، وتعدد المذاهب الفقهية. فالمذاهب الفقهية حركات علمية بحتة، تمحورت حول عدة اجتهادات فقهية، وليس لها برامج واقعية حركية متعلقة بنشر الإسلام، وإبلاغ رسالته للعالمين، وتغيير المنكر الواقع بدرجات التغيير المعروفة، كما هو الحال في الدعوة الإسلامية. وفي خضم تحقيق هذه الرسالة السامية تقابل فصائل العمل الدعوي الكثير من النوازل والقضايا العامة، الأمر الذي يقتضي معه تنسيقا كاملا بين هذه الفصائل، وتوحيدا في المواقف إزاء هذه المسائل العظام. فيجب على كافة فصائل الدعوة انتهاج إستراتيجية واحدة خاصة في إزاء مخططات الخصوم وأعداء الدعوة الذين لا يكفون أبدا عن التنسيق فيما بينهم ضد هذه الأمة ودينها. خامسا: التكامل مع الآخرين وذلك بتأسيس النظرة إلى التعدد على أنه تعدد تنوع وتخصص، تتكامل به الجهود، وتحيا به شعائر وفرائض الدين كله. وليس تعدد تضاد وتنازع، تنقطع به العلائق، وتتهارج به الصفوف، ولعل آكد ثمار هذه النظرة الشاملة التكاملية ؛ زوال عقدة الانغلاق على النفس، والتكور والاستعلاء على الآخرين، وامتهاد الطريق إلى مزيد من التواصي بالحق والتناصح في الله، وقطع السبيل على قالة السوء ودعاة الفتنة، وتصحيح النظرة إلى الآخرين، وانتهاء التشنيع عليهم بالجزئية والقصور، لأنه في ظل هذا التصور لا حرج في الجزئية والتخصص، وما يقصر عنه فصيل، يغطيه فصيل آخر، فتتكافل كل هذه الفصائل في أداء هذه الفروض الكفائية، ويرتفع الإثم عن الجميع، خاصة وأن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية أكبر من طاقة الفصائل الموجودة فعلا مجتمعة، فكيف بها لو تفرقت واهترئت وتناحرت ؟!.
__________________
|
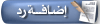 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |