|
|||||||
| ملتقى الشباب المسلم ملتقى يهتم بقضايا الشباب اليومية ومشاكلهم الحياتية والاجتماعية |
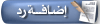 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
لقد كان اجتماعهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول نواة لمدارس تخريج الدعاة في الإسلام، تلمذةً وانضباطًا وقيادةً وتفرُّغًا للعلم، وتدريبًا على العمل به، كلُّ منهم ساعٍ لكفاية نفسه، حريص على نفع غيره، ونصرة دينه، يحدُوهم الإخلاص لله، وابتغاءُ مرضاته عز وجل؛ ولذلك قُيِّدت دعوتُهم بقوله سبحانه عقب ذلك: ï´؟ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ï´¾ [الأنعام: 52]: وإرادة وجه الله تعالى هي القاسم المشترك الأعظم، ونقطة الارتكاز والانطلاق في العبادة التامة المقبولة، بجزأيها اللذين هما إخلاص النية، وصواب العمل؛ أي تصفية الباعث على العمل من كل الشوائب، وتوحيد التوجه إلى الله وطلب رضاه؛ لأن رضاه عز وجل هو المفتاح الوحيد للنعيم الأبدي في الآخرة، ولا تتحقق هذه الغاية إلا بإيمانٍ جوهره الإخلاص، وقصدٍ سليم مَبْناه محبته سبحانه، وعملٍ بالكتاب والسنَّة أساسه اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذلك ما كانت عليه هذه الفئة المؤمنة الربانية في أول مؤسسة تربوية تعليمية إيمانية في الإسلام، مدرسة النبوة الأولى، فَجْر الدعوة الإسلامية، بتلامذتها من الفقراء والمستضعَفين الذين ï´؟ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ï´¾ [الأنعام: 52]، فكان قيامهم وقعودهم وممشاهم ووقوفهم عبادةً، وكلامهم وصمتهم وراحتهم وتعبهم قُرْبَى، ويقظتهم بالنهار جهادًا، ونومهم بالليل تهجدًا، وتمتعهم بالمباحات شكرًا، وامتناعهم عن المحرمات زكاةً، كل ما لديهم وما يعملون، من الله ولله وفي سبيل الله، وابتغاء وجه الله. إن قوله تعالى عنهم: ï´؟ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ï´¾ [الأنعام: 52] شَهادةٌ منه عز وجل لهم، لا تضاهيها شَهادة، وتكريم لا أعز منه من تكريم، وتزكية ما أشرفها من تزكية، لا سيما وقد وردت مباشرة عقب إشارته تعالى إليهم بتزكية أخرى بقوله عز وجل: ï´؟ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ï´¾ [الأنعام: 51]؛ لِما يتميزون به من تمام الإيمان بالغيب، والخوف من يوم الحساب، والولاء الحق لله تعالى، ونَبْذ ما سواه من الأولياء والأنداد والشفعاء[5]. ولا شك أن قيام هذه المدرسة الأولى في فجر الإسلام برجالها الأشداء الذين اختاروا الآخرة والتفُّوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم - قد أثار توجُّس المشركين وخوفهم، وحسَدهم وحفيظتهم، فانطلقوا يكيدون لتفريق جمعهم وإبعادهم عن قيادتهم، بتحقيرهم وتسفيهِ وضعهم الاجتماعي، ووصفهم بالأوصاف النابية، مثل: الأعبُدِ والعُبْدان والعُسَفاء كما في الحاشية[6]، والطعن في إيمانهم وصدقهم، والتشكيك في ولائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والزعم بأنهم ما آمنوا إلا لأنهم فقراء عاطلون يجِدون عنده الطعام والكساء، فكان الرد عليهم بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تعريضًا بهم: ï´؟ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ï´¾ [الأنعام: 52]: ليس عليك مِن حساب هذه الفئة شيءٌ مما يُبطنون أو يعمَلون؛ لأن نتائج نياتهم وأعمالهم لازمةٌ لهم وحدهم، لا تتعدى لغيرهم، وحسابهم بيد الله الذي يعلم السر وأخفى، هو وحده يقدر العمل ويقدر الجزاء، وكما أنه تعالى في أمر الصوم استأثر بحساب أجره؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ عمل ابن آدم يضاعَف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به)) - فكذلك أعمال هذه الفئة المؤمنة، له سبحانه وتعالى حسابها وجزاؤها. ولئن كان هذا هو موقفَ عُتاة المشركين من هذه الفئة المؤمنة، وكان هذا ما ردَّ به ربُّ العزة تعالى عليهم - فإنما ذلك معهود في تاريخ الرسالات الإيمانية منذ كانت، كلما بُعِث نبي أو رسول سارع المستضعَفون إلى اعتناقها، وتحمُّل ثِقَل دعوتها ومحنتها ولَأْوَائِها، وسارع الملأ من الكُبَراء والأغنياء إلى مقاومتها والمكر بها، وكأنه مشهد نوح عليه السلام مع قومه؛ إذ طعنوا في دِين أصحابه، وشكَّكوا في إخلاصهم، وازدَرَوْا بوضعهم الاجتماعي، وطالَبوه بطردهم: ï´؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ï´¾ [الشعراء: 111 - 114]، ï´؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ * وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ï´¾ [هود: 27 - 29]. وكما أن حسابَ عملهم لا يتعداهم إليك، فكذلك حساب عملك يا محمد لازمٌ لك وحدك، لا يتعدى لغيرك، على الله وحده حسابه وتقدير جزائه، وليس على أحد منهم أو له تقديره وحسابه: ï´؟ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ï´¾ [الأنعام: 52]،إنه العدل الإلهي المطلَق، لا يستأثر أحد بأجر عمل غيره، ولا يتحمَّل وِزره؛ قال تعالى: ï´؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ï´¾ [فاطر: 18]، لا فرق في ذلك بين نبي ورسول، وتابع ومتبوع. وما دام أمرُ معرفة النيات وصدقها، والأعمال وصوابها، وتقدير الجزاء عليها بيد الله تعالى، فإن محاولةَ المشركين طَرْدَ هذه الفئة المؤمنة، وإبعادَها عن مجلسك - تَأَلٍّ على الله، واجتراءٌ على أمره، وظلمٌ يريدون استدراجك إليه؛ مكرًا بك وبالمؤمنين وخديعة، وذلك ما نبَّه إليه الحق تعالى وحذَّر منه؛ إذ عقَّب بقوله عز وجل: ï´؟ فَتَطْرُدَهُمْ ï´¾ [الأنعام: 52] جوابًا للنفي في قوله تعالى: ï´؟ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ï´¾ [الأنعام: 52]، أما قوله تعالى عقِبها: ï´؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ï´¾ [الأنعام: 52]، فجواب النهي السابق عن الطرد في قوله عز وجل: ï´؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ï´¾ [الأنعام: 52]؛ أي: لا تطردهم فتكون ظالِمًا، باعتبار أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، تقديره: ليس عليك من حسابهم شيء فتطردهم، ولا تطردهم فتكون من الظالمين. إن هذا المكر لم يكن أول ما مارسه عتاة قريش ضد المؤمنين؛ فلقد مدُّوا إليهم الأيديَ بالتجويع والحبس والضرب والكي بالنار والسحل على الرمل المُحمَّى في هجير الصيف، عند ظهور تباشير الإيمان الأولى، فما زادهم التعذيب إلا إيمانًا، وما زاد ثباتُهم المشركين إلا غيظًا وحَنَقًا وإصرارًا على محاربة الدعوة الإسلامية وأهلها،وإذ فشلت أساليبهم في التعذيب والإرهاب، عمَدوا إلى الكيد والمكر لإبعادهم عن قائد مسيرتهم صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك عقَّب الحق سبحانه بقوله: ï´؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ï´¾ [الأنعام: 53]، والفتنة لغةً هي الاختبار، مِن "فَتَنَ الذهَبَ يَفْتِنُه" بالكسر: إذا وضعه في النار ليختبر جودته، يقال: فُتِن بعضُ الناس ببعض، وابتُلِيَ بعضهم ببعض،ومنه قوله تعالى: ï´؟ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ï´¾ [العنكبوت: 2، 3]، وقوله عز وجل: ï´؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ï´¾ [الأنبياء: 35]، والفتنة في الحياة الدنيا مطلقًا أداةُ الاختبار الإلهي للعباد، عليها بُنِيَ الوجودُ البشري، تكون باختلاف الأرزاق والأخلاق والأعباء والتكاليف، وما يصيب الناسَ مِن حالات اليُسر والعُسر، والسقم والعافية، يُبتلى الوالدُ بالولد، والولدُ بالوالد، والزوج بالزوجة، والزوجة بالزوج، والمريض بالمعافى، والمعافى بالمريض، والمؤمن بالكافر، والكافر بالمؤمن، ويُبتلى الصادق في عبادته بمن يعبد اللهَ على حرف، والثابت على دِينه بالمتاجر بدِينه، ويُبتلى الأشقَّاء ببعضهم البعض، كل منهم بمميزات خاصة قد تثير بينهم التباغض والتحاسد، فمَن تمسَّك بالعدل، وآمَن بقدر الله في توزيع المواهب والقدرات والأرزاق، وسلَك أقوم الطرق في السعي - أَمِنَ شرَّ الفتن، ومَن سَخِط قدر الله، واستكثَر على غيره ما وهبه الله - خسِر نفسه، ذلك ما قرره الحق سبحانه بقوله عز وجل: ï´؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ï´¾ [الأنعام: 53]؛ أي: وكما هي سنَّتنا فيما ابتلَيْنا به الأمم السابقة فتَنَّا عُتاةَ مشركي قريش بسَبْق الفقراء إلى الإيمان، والثبات عليه، والاستعلاء به، واختبَرْنا فقراءَ المؤمنين ببطش المشركين، وقسوتهم، واستعلائهم على الحق، وازدرائِهم بأهله: ï´؟ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ï´¾ [الأنعام: 53]، واللام في قوله تعالى: ï´؟ لِيَقُولُوا ï´¾ للعاقبة والمآل؛ أي: لتكون عاقبة المشركين ومآلُ أمرهم أن يقولوا إنكارًا على الفئة المؤمنة ما فضلها الله به: "أهؤلاء الصعاليكُ مِن الفقراء والموالي والعبيد والعتقاء والأجراء هم الذين أنعَم الله عليهم بالتوفيق إلى الحقِّ، وفضَّلهم علينا في الدِّين الجديد؟!". هذا الموقف من المشركين عرَفه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قبل أن يعرفه أتباعه المؤمنون؛ إذ قالوا عنه حسَدًا عندما أُنزِل عليه الوحيُ: ï´؟ أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ï´¾ [ص: 8]، ï´؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ï´¾ [الزخرف: 31]، وقالوا بعد ذلك عن الفقراء الذين سبَقوا للإيمان: ï´؟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ï´¾ [الأحقاف: 11]. لذلك ردَّ الحق سبحانه عليهم باستفهامٍ تقريريٍّ بقوله: ï´؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ï´¾ [الأنعام: 53]، وصيغة التفضيل في قوله تعالى: ï´؟ بِأَعْلَمَ ï´¾ يراد بها أنَّ علمَه ليس فوقه علم؛ أي: هل غاب عنكم أيها المشركون أن عِلمَ الله تعالى بالشاكرين مِن عباده عِلمٌ مطلَق تام بأقوالهم وأفعالهم ونياتهم؟! وأنه وحده العالم بمن يستحقُّ الفضل والتكريم وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة؟! العليم بمن يستحق اصطفاءَه عز وجل، وإخراجَه مِن الظلمات إلى النور، وهدايتَه إلى صراطه المستقيم. ثم بالتفاتٍ بيانيٍّ لطيف يخاطب الحق سبحانه نبيَّه الكريم بقوله ناصحًا وآمرًا وموصِّيًا بهذه الفئة المؤمنة السبَّاقة إلى الإيمان والإحسان، يمسَح عن قلوب أهلها ما نالهم مِن أذى المشركين وعَجْرفتهم، ويعجِّل لهم البشرى من ربهم: ï´؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 54]، والمؤمنون بآياتِ الله في سياق هذه الآية والراجحِ من أسباب النزول: هم أولئك المستضعَفون الذين سأل المشركون إبعادَهم عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن ذهب بعض أهل التأويل إلى أنها نزلت في قوم استفتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب أصابوها عظامٍ، فلم يُيْئِسْهم الله من التوبة، ونزلت الآية، وآخرون، منهم عكرمة وعبدالرحمن بن زيد، قالوا: إنها في قوم من المؤمنين أخطؤوا وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بطرد الفئة المؤمنة المستضعَفة تأليفًا لقلوب أغنياء قريش وعُتاتها، ثم ندموا، فأمر اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم إذا أتَوْه بأنه قد غفر لهم،إلا أن السياقَ القرآني وتتابعَ الضمائر وأدواتِ العطف في الآية ووحدةَ الموضوع ومحوريتَه حول أولئك المستضعَفين - يؤكد نزولها فيهم، لا في غيرهم، وإن كانت الآية الكريمة بعمومها وإطلاقها في قوله تعالى: ï´؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا ï´¾ [الأنعام: 54] تبشِّر بمغفرته سبحانه لكلِّ مَن تاب من المؤمنين. أما السلام مِن الله تعالى فهو عهدٌ بالأمن والأمان، والسلامة والبراءة من الشرك، والبِشارة بالمغفرة والرضوان، كما هو تحية لقاء المؤمنين ربَّهم يوم القيامة؛ قال عز وجل: ï´؟ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ï´¾ [الأحزاب: 44]، ومِن سعادة هذه الفئة المؤمنة التي استكثر عليها المشركون الاستئثارَ بمجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم: أن زاد اللهُ في إكرامهم، وعجَّل لهم في الدنيا تحية لقائه لهم في الآخرة، فقال عطفًا على النهي عن طردهم: ï´؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 54]؛ أي: إذا جاءك هؤلاء الذين يَدْعون ربهم بالغداة والعَشيِّ يريدون وجهه، فبادِئْهم بالسلام عليهم مِن الله تعالى؛ إكرامًا لهم، وتطييبًا لقلوبهم، وترويحًا عن نفوسهم، وتخفيفًا عنهم ما نالهم من أذى المشركين وعجرفتهم، وأبلِغْهم وَعْدَه لهم بلقاءٍ آمنٍ يوم الدِّين، ما داموا على عهدهم له، ووفائهم لدِينه، واقتدائهم برسوله صلى الله عليه وسلم؛ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآهم بادَأَهم بالسلام، وقال: ((الحمدُ لله الذي جعل في أمَّتي مَن أمَرني أن أبدأَه بالسَّلام)). لذلك عقَّب الحق سبحانه ببِشارة عامة شاملة لعباده، هي مصدر كل مغفرة، وقَبول كل توبة فقال: ï´؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ï´¾ [الأنعام: 54]؛ أي: أوجَب على نفسه الرحمةَ بعباده؛ لأنه هو الرحمنُ الرحيم، اللطيف بعباده، ولصفاتِه هذه كان أرحمَ بعبده من الأم بولدها، كما ذكر عمرُ عن امرأة من السبيِ تحلَّبَ ثديُها، فكانت تسعى إذا وجدت صبيًّا في السبيِ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أترون هذه طارحةً ولدها في النار؟!))، فقالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال: ((لَلهُ أرحمُ بعباده مِن هذه بولدها))،وكما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((جعل الله عز وجل الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخَلْق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها؛ خشيةَ أن تصيبه))،وفي صحيح البخاري: ((إن الله تعالى كتب كتابًا، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقَتْ غضبي)). ولئن تساءل البعض عن كيفية إضفاء هذه الرحمة على العباد في سياق هذه الآية الكريمة، أَلْفَى الجواب في الآية الكريمة بعدها وقد تضمنت أصلًا من أصول الدِّين، وهي قوله تعالى: ï´؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ï´¾ [الأنعام: 54]، والسُّوء في هذا السياق يعني أعظَمَه، وهو الشرك، كما يعني الذنبَ، صغيرًا أو كبيرًا، والجهالة التي يرتكب بها السوء، كفرًا كان أو ذنبًا، هي عدم الاعتزاز به أو الإصرار عليه؛ كما قال تعالى: ï´؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ï´¾ [البقرة: 206]، أو كفِعل قوم نوح في قوله تعالى: ï´؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ï´¾ [نوح: 7]، وفي قوله تعالى: ï´؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ï´¾ [الواقعة: 46]، وقول نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم على المنبر: ((ويلٌ للمُصرِّين الذين يصرُّون على ما فعلوا وهم يعلمون))، كما رُوي بإسناد صحيح: أنَّ رجلًا قال لابن عبَّاسٍ: كم الكبائرُ، أسَبعٌ هي؟ قال: هي إلى سَبعِمائةٍ أقربُ منها إلى سبعٍ، غيرَ أنه لا كبيرةَ مع استغفارٍ، ولا صغيرةَ مع إصرارٍ. أما أن يرتكب المرء الذنب عن جهلٍ بحرمته، أو جهل بعقوبته، أو بمقدار ما يفوته من الثواب وما يستحقه من العقاب، أو جهل بعاقبة إيثار اللذة العاجلة في الدنيا على الخير الكثير الموعود به في الآخرة، ثم يُعقِب ذلك بتوبة صادقة يقصِد بها وجه الله تعالى، ندمًا على الارتكاب، وعزمًا على الإقلاع وعدم العودة، وردًّا للحقوق، وإصلاحًا لِمَا أفسده الذنب في نفسه وفي غيره ما استطاع، فإنه يجدُ الله توَّابًا رحيمًا، وهو قوله عز وجل: ï´؟ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ï´¾ [الأنعام: 54]؛ أي: إن أدَّى شروط التوبة، إنابةً وإصلاحًا، وجَد الله غفارًّا للذنوب، رحيمًا بالعباد. وجديرٌ بالذكر أن أحكامَ التوبة مِن ارتكاب السُّوء بجهالة قد انتظمتها في الفترة المكية بعد سورة الأنعام: سورةُ النحل، بقوله تعالى: ï´؟ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ï´¾ [النحل: 119]، ثم زادت أحكامَها تفصيلًا سورةُ النساء في الفترة المدنية بقوله عز وجل: ï´؟ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ï´¾ [النساء: 17، 18]. ولعل مِن كرامة هذه العُصبة المؤمنة عند الله تعالى أن بَشَّرها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالسلام والأمن في الدنيا والآخرة، في أشد فترات الجاهلية واعتراضها ولَظَى تكذيبها، وجعل صبرها واحتسابها سببًا لنزول هذه الآية الكريمة، آية التوبة على المؤمنين كافة، وجعل الجَهالة المطلَقة بكافة أصنافها إذا تبِعَتْها التوبةُ سببًا للمغفرة والرحمة. أما من حيث قراءة هذه الآية الكريمة فجدير بالذكر أن قوله تعالى: ï´؟ أَنَّهُ ï´¾ ورد فيها مرتين، الأولى قوله: ï´؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ.. ï´¾ [الأنعام: 54]، والثانية قوله: ï´؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ.. ï´¾ [الأنعام: 54]، وقد قرأ نافع: ï´؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ.. ï´¾ بفتح همزة "أن" على البَدَلِية من الرحمة، وقرأ: ï´؟ فَإِنَّهُ غَفُورٌ ï´¾ بكسر همزة "إن" على الاستئناف بعد حرف الفاء، وقرأ عاصم وابن عامر بفتح همزة ï´؟ أَنَّ ï´¾ فيهما، أما الباقون فقرؤوا بكسر همزة ï´؟ إِنَّ ï´¾ فيهما. ثم ختم الحق تعالى بذِكر حكمته في ابتلاء ضعَفة المؤمنين بكفَرة المشركين، بعد بيان غضبه لهم ورضاه عنهم، وما كتبه على نفسه من الرحمة العامة المطلقة، وما شرعه من أحكام التوبة وشروط قبولها، فقال: ï´؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ï´¾ [الأنعام: 55]. والإشارة في قوله تعالى: ï´؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ï´¾ [الأنعام: 55] إلى آيات الخَلْق والتدبير، ودلائل التوحيد والألوهية والربوبية والنبوة الواردة فيما سبق من هذه السورة المباركة، وآيات فشَل محاولات المشركين المكرَ بالمؤمنين والتفرقة بينهم وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم، وآيات حماية الله لهم بتثبيت قلوبهم على الحق، وإكرامهم ورفع درجاتهم، ونهيه عن طردهم من مجلس الذِّكر والعلم ومدرسة النبوة، وآيات اتضاح معايير الدِّين وقِيَمه المستعلية على قِيَم المال والجاه والنسَب والقوة المادية الغاشمة، ï´؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ï´¾ [الأنعام: 55]، والسبيل هو الطريق والنهج والمنهج، يُذَكَّر كما في قوله تعالى: ï´؟ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ï´¾ [الأعراف: 146]، ويُؤَنَّث كما في قوله عز وجل: ï´؟ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ï´¾ [الأعراف: 86]،أما استبانته فاتِّضاحه بعد اشتباهٍ؛ أي: ليتضحَ لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في كل عصر ومصرٍ: طريقُ المجرمين المنحرفين عن منهج الرشد ومسلك السداد، كفرةً ومشركين ومنافقين، فلا يبقى عليها أيُّ غموض مُخِلٍّ، أو اشتباه مُضلٍّ، وتتميز بذلك عن سبيل الله وصراطه المستقيم، وتنكشف حقيقة الهدى وحقيقة الضلال، وتتم المفاصلة الشعورية بين أهل الإيمان وأهل الكفر والجحود، ويَهلِك مَن هلك عن بينة، وينجو مَن نجا عن بينة. ولئن اختلفتِ القراءات لهذه الآية لدى القراء، فقرأ نافع: ï´؟ لِتَسْتَبِينَ ï´¾ بالتَّاء، وï´؟ سَبِيلَ ï´¾ بالنصب على المفعولية؛ أي: لتستبينَ يا محمدُ والمؤمنون معك طريقَ المجرمين، كفرةً ومشركين، وتتضحَ لكم معالمُ كيدِهم ومكرهم، وما يُلقُون من الشبهات، وقرأ حمزةُ والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ï´؟ لِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ ï´¾ بالياء وتذكير السبيلِ مرفوعًا على الفاعلية؛ أي: ليتَّضحَ سبيلُ المجرمين، وقرأ الباقون: ï´؟ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ï´¾ بالتاء وتأنيث السبيل مرفوعًا - فإن جميعَ هذه القراءات تلتقي في معنى واحد، هو وجوب معرفة الحقِّ، واتِّباعه، وموالاة أهله، ومعرفة الباطل، واجتنابه، ومفاصلة أهله، وتجنُّب مكرهم، والحذَر مِن كيدهم وغدرِهم. إن هذه الآية الكريمة قاعدة أساس للتصور الإيماني؛ إذ ينعكس على تصرفات المرء وعلاقاته وولائه وبرائه، وتحديد مسار حياته، فبغير استبانة سبيل المجرمين لا يستطيع المؤمن محاذرتها وتجنُّبَها، بل قد تكون رؤيته لسبيل المؤمنين غائمةً أو مضطربة، وبضدها تتميز الأشياء، كما هي سنَّة الله في الخَلْق، السواد مقابل البياض، والليل ينسلِخُ منه النهار، والحياة تُعرَف بالموت، والحسَنُ يعرف بالقبيح، وهكذا دواليك؛ولذلك عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تمييزَ سبيل الرشد من سبل الضلال، خطَّ لأصحابه خطًّا مستقيمًا، ثم قال: ((هذا سبيل الله مستقيمًا))، ثم خط عن يمينه وشِماله، وقال: ((هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه))، ثم قرأ: ï´؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ï´¾ [الأنعام: 153]،وقد أُثِر عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقول: "مَن لم يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام))، وهذا نُعَيم بن حماد شيخُ البخاري، قيل له: "إنك شديدٌ على الجهمية[7]"، فقال: "لأني كنتُ منهم"،وقال ابن تيمية: "ومَن نشأ في المعروف لم يعرِفْ غيره، فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكَر وضرره ما عند مَن علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم". إن قاعدة تمييز سبيل المؤمنين عن سُبل الضالين، كانت في هذه الآيةِ الكريمةِ الحكمةَ المستخلَصةَ من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة السبَّاقة إلى الإسلام فَجْرَ الدعوة الإسلامية، في أول مدرسة نموذجية للنبوة أقضَّت مضاجع كفار قريش؛ حيث كان يتحلق حوله الفقراء والمستضعَفون والأجراء ونزَّاع القبائل والأعراق، فيعلمهم القرآن، ويفقههم في العبادات، ويصحح عقيدتهم، ويبلور تصورهم الإيماني الخالي من الشوائب، ويعلي هممهم عن الأطماع الوضيعة والمشاعر الرخيصة والقِيَم الزائفة، ويستخلصهم للولاء الحق لله ورسوله والمؤمنين، ويُعِدُّهم لنصرة الدِّين بأغلى ما يملِك الإنسان،ولعل خيرَ مثال على ما بلغه تصوُّرُهم الإيمانيُّ مِن وضوح رؤيةٍ وإشراقِ إيمان: ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى على سَلْمان وصهيبٍ وبِلالٍ ونفرٍ فقالوا: "واللهِ ما أخذَتْ سيوفُ اللهِ مِن عنقِ عدوِّ اللهِ مأخذها"، فقال أبو بكرٍ: "أتقولون هذا لشيخِ قريشٍ وسيدِهِم؟!"، فأتى النبيَّ صلى الله عليهِ وسلم فأخبره، فقال: ((يا أبا بكرٍ، لعلك أغضبتَهم، لئِن كنتَ أغضبتَهم لقد أغضبتَ ربَّك))، فأتاهم أبو بكرٍ فقال: "يا إِخوتاه، أغضبتُكم؟"، قالوا: "لا، يغفِر الله لك يا أخِي". إنها أول مدرسة نموذجية في التاريخ الإسلامي تعلِّمُنا ما ينبغي أن يكون عليه المعلِّم والمتعلِّم، ومنهج التربية والتعليم،المعلِّم وهو في الذروة من قريش والذؤابة من بني هاشم وسيد ولد آدم، يجالس بكل تواضع تلامذتَه مِن ضعَفة القوم كأنه منهم، حتى لَيقولُ سلمان الفارسي وخبَّاب بن الأرتِّ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا ويدنو منا حتى تمَسَّ ركبتُنا ركبته، وكان يقوم عنا إذا أراد القيام، فنزلت: ï´؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ï´¾ [الكهف: 28]، فترَك القيام عنا إلى أن نقوم، فكنا نعرف ذلك ونعجله القيامَ"؛أي: إنهم كانوا يقومون أولًا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الأدب إذا شعَروا بأنهم أطالوا الجلوس معه؛ كيلا يُحرجوه مع ربه وقد أمره أن يصبر نفسه معهم، وفي هذا قمة الحب والأدب والتكريم من المعلِّم والمتعلِّم. وحتى لَيقولُ أبو سعيد الخدري: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العُرْي، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فسلَّم، ثم قال: ((ما كنتم تصنعون؟))، قلنا: يا رسول الله، كان قارئ لنا يقرأ علينا، وكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحمد لله الذي جعل مِن أمتي مَن أُمِرت أن أصبر نفسي معهم))، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلقوا وبرزت وجوههم، قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَف منهم أحدًا غيري،ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة عام)). أما المتعلِّم في هذه المدرسة على فقره وخلوِّه مما يفاخر به كبراءُ قريش، فهو مستعلٍ بإيمانه، لا يستذلُّه الغِنَى من الأغنياء، ولا تفتنه القوة من ذوي الجاه والسلطان، ولا يقف متوددًا أو متسولًا على أبواب الكُبَراء والمكاثرين، كما يفعله بعض الدعاة الذين استرخصوا مروءاتهم وعِلمهم مسترفدين الأعطيات، تحت ذريعة الاستقواء على تكاليف الدعوة وأعبائها. لقد كانت هذه العُصبة المؤمنة المستضعَفة مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى العلم والأدب مستورةَ الحال، صابرة على البلاء، محتسبة شاكرة في البأساء والنَّعماء، لا يعلَم صدق نياتهم وصفاء نياتهم إلا اللهُ تعالى، وهو الحكيم العليم بالشاكرين، حتى إذا اشتد حسَد المشركين لهم على سبقهم للإسلام، وحنَقُ الكفار على استعلائهم بالإيمان، وحاوَلوا خفضهم عن درجتهم عند الله تعالى، أراد اللهُ أن يُشهِرَ منزلتهم عنده، ويَغيظ بهم أعداءه، ويجعلهم قدوة لعباده، فشهد لهم مِن فوق سبع سموات بصدق العبادة والتقوى: ï´؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ï´¾ [الأنعام: 52]، وبشَّرهم بسلامة الحال بين يدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة الورود بين يدَيْ ربه عز وجل: ï´؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 54]، وجعل أمرهم مدخلًا لتنزيل تشريع رحمته بعباده: ï´؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ï´¾ [الأنعام: 54]، فهنيئًا لهم سلامة الحال، وسعادة المآل، وهنيئًا لِمَن كان على سيرتهم فكثَّر رفقاء دربهم، واتبع سنة نبيهم صلوات الله عليه وسلامه. [1] الرِّيح: نسيم الهواء، والجمع أَرْواح، تعبير عن رائحة عرق أجسادهم وملابسهم. [2] إشارة إلى قوله تعالى: ï´؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ï´¾ [الكهف: 28]. [3] أي: إلى ما تحت عظامه. [4] وهم المقداد، والزبير، ومرثد بن أبي مرثد. [5] تخلِّيهم عن الأولياء والشفعاء لا ينافي ثبات ولاء المؤمن للمؤمنين، ولا إثبات الشفاعة للمؤمنين؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى، وهي بذلك في الحقيقة منه عز وجل؛ لقوله تعالى: ï´؟ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ï´¾ [المائدة: 55]، وقوله عز وجل: ï´؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ï´¾ [البقرة: 255]. [6] العُسَفاء جمع عسيف، وهو: الخادم والأجير. [7] أتباع الجهم بن صفوان الذي قتل عام 128هـ بعد اشتراكه مع الحارث بن سريج التميمي في الثورة على الدولة الأموية.
__________________
|
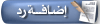 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |