|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
تطوّر الأرشيف في الحياة الإسلاميّة: دَوْر الأرشيف في حماية الأوقاف الإسلامية
تنبعُ أهمّيّة التدوينِ والتوثيق من كونِه الوسيلةَ التي تحتفظُ بها الحضاراتُ والثقافاتُ والدّول بتراثها وأفكارها، وصوابها وخطئِها، ونجاحاتها وإخفاقاتها على السّواء، على نحو جعل من المدرَك والمفهوم بوضوح، أنّ التطوّر البشريّ ما كان له أن يكون، لولا التوثيقُ والأرشَفَة؛ إذ لولا ذلك لكانت كلّ دورةٍ حضاريّةٍ في عمر الكائن الإنسانيّ وتاريخ وجوده على هذه الأرض، تبدأ من الصّفر، وتنتكسُ إلى البدايات الأولى؛ لانعدامِ إمكانيّة بناءِ كلّ جيلٍ على منجَزَات الجيلِ الذي سبقَه، ولتعذّر المعرفةِ التراكميّة والبناء على الخبرات. إنّ التجذير اللّغويّ المعجميّ لكلمة (أرشيف) غير ممكن؛ لأنّ الكلمة ليست عربيّة أصلاً، بل هي يونانيّة الأصل؛ فلا يبقى سوى محاولة تعريفها تعريفاً عامًّا، نظراً لعدم استقرار تعريفها الاصطلاحيّ أيضاً، وتناوُب استعمال المفردةِ في أكثر من نطاق، وقد وصلت هذه المفردةُ إلى اللّغة اللاتينيّة من اليونانيّة، ثمّ انتشرت في اللّغات الأوروبيّة الحديثة ومنها الإنجليزية (Archive)؛ «حيث أُطلقت على وثائق الدّولة التي جُمعت نظراً لقيمتها العلميّة والقانونيّة، واختُزنت في مؤسسة خاصّة تُسمّى أيضاً: الأرشيف..»، فهذا تعريف الأرشيف باعتباره الوثائقَ نفسَها، كما يُعرَّف باعتباره مكان حفظ الوثائق أو الهيئة القائمة على الحفظ، فيقال: هو «الهيئة التي تتولى مهمة حفظ الوثائق والسجلّات والقيود والمدوّنات بطريقة منظّمة». الوقف والأرشيف في العصر النبوي وعصر الخلافة الراشدة بهذا الاعتبار، وبالتعريف الذي مضى، لم يكن للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا في حياتِه تدوينٌ معروفٌ في أيّ جانبٍ من جوانب الحياةِ الإداريّة للدّولة، فكانت الأمور على أرجح تقدير تقضى بالأوامر الشفهيّة منه - صلى الله عليه وسلم -، وربما تكون أوّل تدوينةٍ يمكن أن تُعد تدوينا رسميا في شأنٍ إداريّ جاءت بأمره المباشر - صلى الله عليه وسلم -، بإحصاء من تلفّظ بالإسلام من النّاس في أيّام صلح الحديبية، قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «اكتبوا لي من تلفّظ بالإسلام من النّاس»، فكتبنا له ألفًا وخمسَ مائة رجل، فقلنا: نخافُ ونحن ألفٌ وخمسُ مائة؟ فلقد رأيتنا ابتلينا، حتى إنّ الرجل ليصلي وحدَه وهو خائف. والمشهور عند أهل العلم أنَّ هذا الإحصاء أو الكتابة أو التّدوين، كان لغايات إحصاء المقاتِلة من الرّجال الذين يستطيعون الدّفع عن المسلمين إذا دعا داعي الجهاد أو نزلت بهم نازلة، ويشير حذيفةُ - رضي الله عنه - إلى أنَّهم بعد أنْ أُحصِيَ العدد اغترّ بعضُهُم بكثرتِه، فكأنّما عوقِبُوا على هذا الاغترار بأنْ ابتُلُوا بعد ذلك حتى صار أحدُهُم يصلّي وهو خائف، وقد اختلف أهلُ العلم في تعيينِ وقْت حصولِ ذلك والمراد به بالضّبط. فضيلةِ التدوين المبكّر هذا مع إقرارهم بفضيلةِ ذلك التدوين المبكّر، كما قال ابن المنيّر: «موضع الترجمة من الفقه ألا يُتَخَيَّلَ أنّ كتابتَه النّاسَ إحصاءٌ لعددِهم، وقد تكون ذريعة لارتفاع البركةِ منهم كما ورد في الدّعوات على الكفار: «اللهمّ أحصِهِم عدَدا» أي: ارفع البركة منهم. فإنّما خرج هذا من هذا النّحو؛ لأنَّ الكتابةَ لمصلحةٍ دينيّة، والمؤاخذةُ التي وقعت، ليست من ناحيةِ الكتابة، ولكن من إعجابهم بكثرتهم، فأُدّبوا بالخوف المذكور في الحديث...»، فهذه الرواية وأمثالُها هي التأسيسُ النبويّ لمشروعيّة ما صار يُعرَفُ بعد ذلك بـ(ديوان الجند)، على الرغم من أنَّه لم يتحقّق في شكلِه المؤسّسيّ في العصر النبويّ، بل كان هذا التأسيسُ النبويّ هو ما هيّأ للمسلمين بعد ذلك قبولَ نقْلِ الدّواوين عن السّاسانيّين في خلافة عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -. خلافةُ أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - أمّا خلافةُ أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه -، فهي لِقِصَرها لم تشهد تحوُّلاً يُذكَر في موضوع التّوثيق والأرشَفَة، حتى جاءت خلافةُ عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -، فكان أوّل من دوّن الدّواوين، ويستعرِض ابن طباطبا نشأة الدّواوين في شكلِها المؤسّسيّ، مع بيانِ الحاجةِ لها على ما اقتضته المرحلةُ التأريخيّة، بعد تكاثر الفتوح وتوافُر الغنائم واتّساع الأراضي المفتوحة. نقلة نوعيّة للدواوين ولقد انتقلت الدّواوين نقلةً نوعيّةً أخرى في العصر الأموي، واستُحدثت دواوين جديدة نشأت معها مساراتٌ جديدةٌ للتّدوين وميادين جديدةٌ لتوثيق الوقائع المادّيّة؛ فصار منها ما يتعلّق بالإدارةِ العامّةِ كديوانِ الجُنْدِ، وديوان البريدِ، والرسائل، وديوان الخاتَم، ودواوين أخرى تتعلّق بالإدارةِ الماليّة كدواوين الأوقاف والصدقات والمستغَلَّات والخَراج، وفئةٌ أخرى من الدّواوين تتعلّق بالقَضاء وتوابعه الإجرائيّة مثل نظام الاحتساب ونحو ذلك، وقد كانت المسؤوليّة عن معظمها أعجميّة في أوّل الأمر ثمّ عُرّبت. تطوّر أساليب التوثيق ثمّ استمرّ ظهور الدّواوين وتطوّرت أساليب التوثيق، حتى ظهرَ في التّاريخ الإسلاميّ أدبيّاتٌ خاصَّةٌ بشؤون تدويناتِ الإدارة العامّة المختلفةِ، انتهت إلى جمعِهَا تحت تخصّصاتٍ علميّة وتلقيبها بألقابِ علومٍ خاصّة، فـ(علمُ الشّروط والسّجلّات) هو أحدُ العلوم التي ارتضاها حاجي خليفة في تقسيمِه للعلوم، وعرّفه بأنَّه: «علمٌ باحثٌ عن كيفيّة ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلّات، على وجه يصحُّ الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال». وعلى أساس هذه الوظيفة، استمرّت الدّواوين الإسلاميّة والأرشيفات ومؤسّسات ودُوْر الوثائق تنمو وتتزايد ويقتبسُ لاحقُها عن سابقها، ويستفيدُ القائمون عليها من تجارب النّاس، حتى بلغت في العصر العثمانيّ مبلغاً عظيمًا وترتيباً خاصًّا. اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
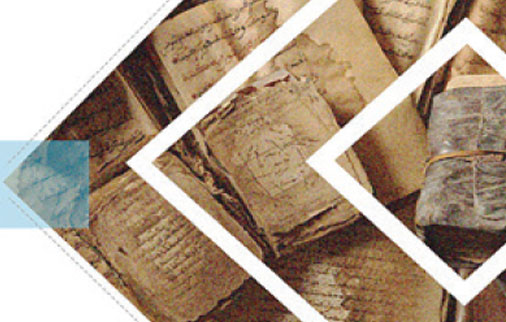 تطوّر الأرشيف في الحياة الإسلاميّة: الأوقاف الإسلامية ودور التوثيق في حمايتها
توثيق الأوقاف من أعظم أسباب حفظها واستمرارها ومنع أيدى المعتدين عليها، وهو السبيل الذي يحقق مقاصد الواقفين في بقاء أوقافهم مع تعاقب السنين، والحفاظ عليها من الضياع والاندثار، والتقيُّد بمصارفها كما نصَّ عليها الواقف، وضبطها من التغيير والأهواء، والحكمة من مشروعية التوثيق للوقف واضحة جلية، قال الشيخ العلامة السعدي: «فكم في الوثاق من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات»، كما أن في إثبات الأوقاف وضبط إجراءاتها حفظًا لها من الاندراس والنسيان، أو الاعتداء عليها بالظلم والعدوان، وضبط جميع الحقوق المتعلقة بها، وهو مقصد معتد به في الشرع. إثبات الوقف بالكتابة لأن الكتابة أبقى من الشهادة؛ لذهاب أعيان المستشهد بهم، ووقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثبتَ بدايةً بالإشهاد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبكتابة الأحاديث النبوية الشريفة الخاصة به وتدوينها، ومع ذلك كتب عمر - رضي الله عنه - وثيقته وأشهد عليها؛ لأن في توثيق الوقف صيانة للحقوق، وقطع للمنازعة، وديمومة للوقف، ونقلت لنا كتب التاريخ أن هناك من أثبت الوقف في لوحة رخامية كبيرة على مدخل الموقوف؛ كما في المدرسة النورية الكبرى في دمشق، التي بُنيت في عام 567هــ/ 1171م. توثيق الأوقاف في المغرب وفي المغرب بلغ حرصهم في المحافظة على المدارس أنهم كانوا ينقشون الموقوفات على رخام كان يُبنى في جدرانها؛ حفاظًا على استمرار إنفاقه عليها؛ فالمحافظة على الأصول الوقفية يستلزم تثبيت وضعها القانوني، وعُني المسلمون -لحماية الوقف- بتجديد وثائقه مع تعاقب السنين، وقد نصَّت بعض الوثائق الوقفية على اشتراط الواقف في كل عشر سنين بالإثبات والتنفيذ لدى قاضي القضاة. وهذا التعاهد بتجديد وثيقة الوقف لحفظ الأصول على الدوام وقطع الطريق على المتلاعبين، وكان بعضهم ينقش ملخصًا لكتاب وقفه على الحجر أو الخشب داخل المنشآت التي أقامها لتكون وقفًا للّه تعالى، ليعلم الجميع أنها وقف، وكذلك ما وُقف للصرف على هذا الوقف؛ إن كان مدرسة أو مستشفى أو نزلاً لابن السبيل أو لطلبة العلم. كتابة الحُجج الوقفية وكانت الحُجج الوقفية تُكتب على الورق والجلود والخشب والحجر، إلا أنه خوفًا من تلفها، وبخاصة ما كان مكتوبًا على الورق أو الجلد؛ فقد كانت تجدَّد كلما مضى عليها فترة من الزمن، كما كان بعض الواقفين يشترط أن يقوم ناظر الوقف بتعهد كتابة الوقف كل عشر سنين بالإثبات والتنفيذ لدى قاضي القضاة. وبعض هذه الوثائق يجدَّد على رأس كل مائة سنة، ويصاحب ذلك قراءتها في الجوامع، أو من خلال تكرار توقيع القضاة على الوثيقة الوقفية، كما في وقفية صلاح الدين الأيوبي المؤرخة في سنة 585هـ/ 1189م، وقد جرى توثيقها في المحكمة الشرعية في القدس في عام 1022هـ/ 1613م، ولكن قبل ذلك كان القضاة المتعاقبون يضعون أختامهم على الوثيقة تأكيدًا عليها والتزامًا بها، وقد رُصد خمسة عشر توقيعًا وختمًا للقضاة على تلك الوثيقة خلال مائتي سنة، ويُستحب تفصيل الواقف في وثيقته الوقفية؛ وذلك لضمان حفظ وقفه واستمرار نفعه، وإزالة اللبس في أعيانه وحدوده وشروطه ومصارفه، وكذلك النصُّ على تعيين ناظره. ضبط تحرير الوثائق الوقفية لذا كان لا بدَّ من ضبط تحرير الوثائق الوقفية بما يضمن حقوق أطراف الوقف، وقد اتفق العلماء على أن شروط الواقف -في الجملة- معتبرة في الشريعة، وأن العمل بها واجب، وعبَّر ابن القيم عن هذا المعنى بقوله: «الواقف لم يُـخرج ماله إلا على وجه معيَّن؛ فلزم اتِّباع ما عيَّنه في الوقف من ذلك الوجه»، وأهل العلم رفعوها إلى منـزلة النصوص الشرعية؛ من حيث لزومها، ووجوب العمل بها، فقالوا: «إن شرط الواقف كنصِّ الشارع»، ولكن هذه الشروط لا تكون بهذه المنـزلة إلا إذا كانت محقِّقة لمصلحة شرعية، أو موافقة للمقاصد العامة للشريعة، وهي المتمثلة في حفظ: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «من قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع؛ فمراده: أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب العمل بها، والشروط إن وافقت كتاب اللّه كانت صحيحة، وإن خالفت كتاب اللّه كانت باطلة». تأكيد الوقف وتأبيده ولزومه وقد حرص الواقفون على تأكيد الوقف وتأبيده ولزومه؛ فتضمَّنت وثائق الوقف تلك العبارات، فقد جاء في جُلِّها عبارة: «وقفًا صحيحًا شرعيًّا مؤبدًا، وحبسًا صريحًا، حبَّسه وسبَّله للّه تعالى، دائما أبدًا حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها»، ولهذا فإن من الطرائق الوقائية والعلاجية لموضوع الاعتداءات على الأعيان الموقوفة؛ ضبط الحجج الوقفية عند تحريرها بضوابط تمنع ذوي الشوكة أو الموظفين المسؤولين أو النظار من التدخُّل بما يؤدي إلى الاستيلاء على الوقف، والنصُّ كذلك على تأبيدها وعدم استبدالها إلا بأمر من القضاء. حرمة الاعتداء والتبديل ومن الحماية القاطعة النص في وثيقة الوقف على حرمة الاعتداء والتبديل في الوقف وذلك تذكيرًا وتحذيرًا من عقوبة الاعتداء والتبديل في الوقف؛ فلا تكاد تجد وثيقة وقفية تخلو من قول اللّه -عز وجل-: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم}، ومثال ذلك ما جاء في خاتمة الوثيقة الوقفية للمدرسة التنكزية في القدس: «وقد صحَّ هذا الوقف ولزم، وصار وقفًا على الوجوه المشروحة في هذا الكتاب، فلا يحلُّ لأحد يؤمن باللّه العظيم واليوم الآخر، ويعلم أنه إلى ربه الكريم صائر؛ نقض هذا الوقف ولا تبديله ولا تغييره، ولا الحيد به عن وجوهه وشروطه المذكورة فيه، ولا بيعه ولا إتلافه ولا المناقلة به ولا بشيء منه، ولا يخرج إلى ملك أحد من سائر الناس أجمعين، بل كلما مرَّ بهذا الوقف زمن أكَّده، وكلما أتى عليه عصر أو أوان أخلده وسدده، فهو محرم بحرمات اللّه، متبع فيه مرضات اللّه، لا يوهنه تقادم دهر، ولا يبطله انقراض عصر، وهذا الواقف المسمى -خلَّد الله سعادته ونعمته- يستعدي إلى الله عز وجل على من يقصد وقفه هذا بفساد، أو يرومه بنقض وعناد، ويحاكمه إليه ويخاصمه لديه يوم القيامة؛ يوم الحسرة والندامة، يوم التناد، يوم عرض الأشهاد، يوم عطش الأكباد، يوم يكون اللّه تعالى هو الحاكم بين العباد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم}». الإكثار من الشهود وكان الإكثار من الشهود على الوقف، فالأصل في الوقف أن يُشاع بين الناس، والإخفاء يكون بداية من الواقف؛ ظنًّا منه أن ذلك أكثر أجرًا، وهذا قد يدفع بعض الورثة إلى كتمان الوقف الذي وقفه مورِّثهم، ويتلفون عمدًا أي ورقة كتبها المورِّث؛ ليتصرفوا فيه بيعًا ونفعًا، فلا مرجعية في ذلك بعد أن أُتلفت وثائق الوقف. جاء في «الموسوعة الفقهية»: «الشهود على التصرفات وسيلة لتوثيقها، واحتياط للمتعاملين عند التجاحد... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي [ وغيرهم؛ لأن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس؛ فوجب الرجوع إليها»، وفي العهود الإسلامية لجأ بعض الواقفين إلى الإكثار من الشهود على كتاب الوقف، ومما ذكره المقريزي -عند كلامه عن الدار البيسرية التي أنشاها الأمير بدر الدين الشمسي الصالحي النجمي- أنه أشهد على وقفه اثنين وتسعين عدلاً. الإعلام على الأوقاف ومما شاع في العهود الإسلامية أن الواقفين كانوا يتعمدون الإعلام على أوقافهم؛ حتى يعرف الناس على اختلاف طبقاتهم بالوقف وشروطه، ومن الطرق التي نقلتها كتب التاريخ؛ زفُّ كتاب الوقف بالأناشيد والأشعار في شوارع القاهرة! فضلاً عن الحفلات التي تقام -عادة- عند افتتاح المنشآت الموقوفة؛ مثل المدرسة وغيرها، فالأَوْلى إظهار الوقف والإعلام عنه، حتى لا يُنازع فيه؛ ولا سيَّما من الورثة، أو ممن يطمع في سلبه. اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |