|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 11 : التوضيح  كتاب التوضيح للشيخ الفقيه أبي المودة خليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي (767هـ) من أكثر شروح كتاب جامع الأمهات لأبي عمرو ابن الحاجب (646هـ) فائدة، وأجودها وأنفعها وأشهرها. تتبع فيه المؤلف كتاب ابن الحاجب، فحل مشكلاته، ووضح مبهماته، معتمدا أقوال فحول علماء المذهب المبثوثة في كتبهم المشهورة، وعلى شروح الكتاب التي تقدمته؛ شرح ابن راشد القفصي (736هـ)، وشرح ابن عبد السلام الهوراي (749هـ)، وشرح ابن هارون الكناني (750هـ)، مع ما بثه فيه من علمه وفقهه، فصح أن يطلق على شرحه «جامع شروح جامع الأمهات»؛ لكون الشروح المذكورة من الأهمية بمكان، فإنها تمتاز بالإجادة والحسن، وتلقاها الناس بالقبول، فقد قيل عن شرح ابن عبد السلام: إنه بالنسبة لبقية الشروح كالعين من الحاجب، وقيل: إن ابن عبد هارون فتح مقفلات جامع الأمهات وحل مشكلاته، ونفس الكلام قيل عن شرح ابن راشد، فكيف إذا أضيف إلى هذا انتقاءات الشيخ خليل وإضاءا ته!. وقد نهج خليل في توضيحه طريقة واضحة، فيأتي أولا بكلام ابن الحاجب، فإن ظهرت له مفردة لغوية غامضة شرحها، أو مصطلح فقهي ينبغي تفسيره فسره، ثم يفك كلام ابن الحاجب متوسعا في ذكر الأقوال وسرد النقول التي دأب على نسبتها لأصحابها، كما يذكر تعقيباته وتنبيهاته وإجاباته هو عقب المسائل التي يراها تحتاج إلى ذلك، ويبين المشهور وما يقابله، ومذهب الجمهور وما يخالفه، واختيارات المحققين. أما عن اهتمام العلماء بالكتاب فيمكن القول: إن جميع شرّاح مختصر خليل اعتمدوا على توضيحه، وأكثروا النقل عنه، فقد اعتمده الحطاب في مواهب الجليل(ت 953/954 هـ)، وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بحلولو (ت898هـ) في الشرح الكبير، بل قيل: إن محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصري (ت940هـ) لخص شرحه الذي وضعه على كتاب ابن الحاجب من التوضيح، و اعتمده محمد بن أحمد عليش (ت1299هـ) في منح الجليل، وغيرهم كثير. ولم يقتصر اهتمام العلماء بالكتاب في النقل عنه فقط، بل وضعوا عليه الحواشي والطرر، كما فعل الحطاب المذكور آنفا، وناصر الدين اللقاني (958هـ)، وقد قام بدر الدين القرافي -صاحب توشيح الديباج- بجمع طرره في مجلدين لطيفين وقال عنها: فيها فوائد وتقييدات بديعة، ولأبي بكر بن إسماعيل الشنواني (ت1019هـ) حاشية عليه في مجلدات لم تكمل... ويكفي للدلالة على ما لقي هذا الكتاب من عناية أن المتأخرين من المالكية اقتصروا عليه وعلى المختصر المشهور، وفي هذا يقول القرافي: ولقد عكف الناس على قبول كتابيه (المختصر والتوضيح)، وبقريب من هذه العبارة يقول التنبكتي: وقد عكف الناس على مختصره وتوضيحه شرقا وغربا. ويقول ابن فرحون: وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته. من فوائد الكتاب ما ذكره الشيخ خليل في بيان مصطلحات ابن الحاجب، قال رحمه الله: قاعدة ابن الحاجب وغيره من المتأخرين أن يستغنوا بأحد المتقابلين عن الآخر. ومقابل المشهور: شاذ، ومقابل الأشهر: مشهور دونه في الشهرة، وكذلك في الصحيح والأصح، والظاهر والأظهر، ويقابل المعروف بقول: غير معروف، ولم تطرد للمصنف - رحمه الله - قاعدة في مقابل المنصوص، فقد يكون منصوصا وقد يكون تخريجا وهو الأكثر. وكل ما قال: «فيها» فمراده المدونة وإن لم يتقدم لها ذكر وهو الأكثر... ولا يأتي بقوله:«فيها» في الغالب إلا لاستشهاد أو استشكال. وإذا قال:«ثالثها» فالضمير عائد على الأقوال المفهومة من السياق. وحيث أطلق الرواية: فالمراد فيها قول مالك، «والقول» يحتمل أن يكون للإمام وغيره. ومن قاعدته أيضا: أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين، فيجعل صدره دليلا على الأول، وعجزه دليلا على الثاني إلا في النادر. ومن قاعدته: أنه إذا ذكر قسمة رباعية أن يبدأ بإثباتين ثم بنفيين، ثم بإثبات الأول ونفي الثاني ثم بعكسه. ومن قاعدته: أنه إذا صدر بقول ثم عطف عليه ب«قيل»: أن يكون الأول هو المشهور. ومن قاعدته: إذا حكى الاتفاق فمراده أهل المذهب، وإذا حكى الإجماع فمراده إجماع الأمة. ومن قاعدته: إذا ذكر أقوالا وقائلين أن يجعل الأول من الأقوال للأول من القائلين، والثاني للثاني، وأول الأقوال للأول من القائلين. طبع من الكتاب لحد الآن كتاب الطهارة في مجلد بتحقيق الدكتور أحسن زقور، نشر دار ابن حزم الطبعة الأولى 1428هـ/2007م. لتحميل الكتاب رابط التحميل 1 (PDF) (11.17 ميجا بايت) رابط التحميل 2 (PDF) (13.75 ميجا بايت) رابط التحميل 3 (PDF) (12.98 ميجا بايت) رابط التحميل 4 (PDF) (12.78 ميجا بايت) رابط التحميل 5 (PDF) (13.18 ميجا بايت) رابط التحميل 6 (PDF) (13.05 ميجا بايت) رابط التحميل 7 (PDF) (1.16 ميجا بايت) رابط التحميل 8 (PDF) (112.93 كيلو بايت)
__________________
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 12: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. 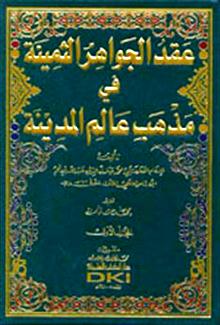 يعتبر كتاب: «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لأبي محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي (ت616هـ)، من المختصرات الفقهية الجامعة لأمات المذهب المالكي، المتقدمة منها والمتأخرة. ذكر المؤلف في مقدمته باعثه على تأليفه بقوله: «بعثني على جمعه في مذهب عالم المدينة، إمام الهجرة مالك بن أنس ... ما رأيت عليه كثيرا من المنتسبين إليه في زماننا من ترك الاشتغال به، والإقبال على غيره». والكتاب من المختصرات الجيدة النظم، والمحكمة التقسيم، بحيث قسمه المؤلف إلى كتب تفرعت عنها أبواب وفصول، استهله بفقه الطهارة، وختمه بكتاب جامع لمجموعة من الآداب الشرعية التي يجب على المسلم التحلي بها. سلك ابن شاس في كتابه منهجا رصينا، إذ بين أنه نظم المذهب بأسلوب يوافق مقاصد علماء المالكية ورغباتهم، مع حذف التكرار المعيب، كما نص على أنه جعله على طريقة الإمام الغزالي في كتابه الوجيز - في فقه الشافعية - لكونه غاية منتهى التحرير. ومن جملة منهجه أيضا: الاستدلال بالنصوص والآثار، وعزو الأقوال إلى أصحابها، والترجيح بينها، والاحتكام للغة العرب في بعض الأحيان، والحكم على المسائل التي لم يرد فيها حكم، واستنباط قواعد فقهية من بعض المسائل، واستعماله لبعض المصطلحات الفقهية للاختصار، مثل: المدنيون، والمصريون، والعراقيون. اعتمد ابن شاس في كتابه حوالي أربعين مصنفا من مصنفات المذهب، أهمها: المدونة لسحنون، والعتبية للعتبي، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد، والمعونة، وشرح الرسالة، والإشراف للقاضي عبد الوهاب، وشرح التلقين للمازري، والمنتقى للباجي، والتبصرة للخمي، وعارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي، والتنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر التنوخي، والبيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات لأبي محمد بن رشد الجد. ولم يسلم الكتاب من الانتقاد لبعض مسائله، التي خَرَجَ فيها مؤلفه عن المذهب المالكي، آخذا بكلام الغزالي، ومثال ذلك ما أورده الونشريسي في المعيار (4/158): في مجموعة من الأسئلة طرحت على ابن مرزوق تتعلق بجواهر ابن شاس منها: وسئل عن قول ابن شاس: وإذا قال العبد لزوجته: إن مات سيدي فأنت طالق، فبت السيد عتقه في المرض ثم مات، فبقيت معه بطلقة على حكم يوم الحنث، انظر هذا فإنه خالف المذهب، والذي عندي في غالب الظن نَقْله هذا الفرع من كتاب الغزالي. وقد حاول بعض العلماء تتبع الأماكن التي خالف فيها المؤلف المذهب، كابن غازي المكناسي في كتابه: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل»، وعليش في: «منح الجليل». وما ذكر لا ينقص من قيمة الكتاب ولا من أهميته، إذ استحسنه العلماء وأثنوا عليه، قال ابن خلكان: «وصنّف - يقصد ابن شاس - في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه كتابا نفيسا أبدع فيه». وقال القرافي في الذخيرة:« ومنهم من سلك الترتيب البديع، وأجاد فيه الصنيع، كالإمام العلامة صاحب الجواهر الثمينة رحمه الله، واقتصر على ذلك، مع اليسير من التنبيه على بعض التوجيه». وعلى العموم فالكتاب لقي اهتماما بالغا من قبل من جاء بعده، فهذا عبدالعظيم بن عبدالله البلوي (ت666 هـ)، كان يقرئ الفقه وأصوله، ويعتمد في الأكثر قراءة مستصفى أبي حامد، وجواهر ابن شاس، وكان له بهذين الكتابين اعتناء كبير، وفيهما تصرف لتعويله عليهما، ودؤوبه على تدريسهما.ومما يرفع أيضا من شأنه كثرة نقول المتأخرين عنه، كابن عرفة، والرصاع، والبقوري، وابن جزي، والشيخ خليل وغيرهم. طبع الكتاب مرتين: الأولى بتحقيق محمد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور، مراجعة الأستاذين: الحبيب بن الخوجة، وبكر بن عبدالله أبو زيد، نشر المجمع الفقهي بجدة. والثانية بتحقيق حميد بن محمد لحمر، نشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1423 – 2003. عنوان الكتاب: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة المؤلف: جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المحقق: حميد بن محمد لحمر حالة الفهرسة: غير مفهرس سنة النشر: 1423 - 2003 عدد المجلدات: 3 رقم الطبعة: 1 عدد الصفحات: 1590 نبذة عن الكتاب: - أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة - تم دمج المجلدات للتسلسل. رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: تحميل الكتاب تحميل المقدمة تصفح الكتاب تصفح المقدمة (نسخة للشاملة)
__________________
|
|
#13
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي  تواليف مالكية مهمة 13: التهذيب في اختصار المدونة يعد كتاب التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشهير بالبراذعي(ت438هـ) من أهم المختصرات لكتاب المدونة، قصد فيه مؤلفه تيسير فهم المدونة وتسهيل حفظها وتدريسها، فعمد إلى اختصارها وتقريب مسائلها. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من أمرين: *أولهما كونه اختصارا للمدونة التي هي عمدة المذهب، وديوان أقوال الإمام مالك، وقيمتها لا تخفى في الفقه المالكي. *وثانيهما حسن صنيع البراذعي في التهذيب والاختصار. وكان السبب الذي دعا البراذعي إلى هذا التأليف أن ابن أبي زيد اختصر المدونة ليسهل تدارسها، وزاد في مختصره زيادات من الأمهات الأخرى، فامتنع الطلبة من درسه لما فيه من الزيادات، فبلغ ذلك أبا سعيد فاختصرها وهذبها دون أن يزيد فيها كما صنع ابن أبي زيد رحمه الله. وأفصح البراذعي عن منهجه في تهذيب المدونة والمقصد الذي يهدف إليه فقال في مقدمة كتابه: «واعتمدت فيها على الإيجاز والاختصار، دون البسط والانتشار، ليكون ذلك أدعى لنشاط الدارس، وأسرع لفهمه، وعُدّة لتذكره». وتهذيب البراذعي لم يكن من تلك المختصرات المخلة التي عِيب عليها صعوبة حل ألفاظها، مما استوجب جهدا في فهمها فجاءت على نقيض قصد مصنفيها، بل اتسم اختصاره ـ رحمه الله ـ بسلاسة اللفظ مع وضوح الفكرة وشمولها، وقد عمد إلى حذف الأسئلة، والأسانيد، وكثير من الآثار التي تضمنتها المدونة، مما يرى أن في ذكره تطويلا، إلا ما تدعو الضرورة إلى بقائه، مع التزام حرفي لنص المدونة فجاءت مسائل الكتاب مختصرة، مركزة، منظمة في تسلسلها، مرتبة في أفكارها، ترتيبا منطقيا يجمع شتات القضية الواحدة. وقد كانت مسائل المدونة متناثرة غير مرتبة فجعلها على الولاء بحسب اتصال بعضها ببعض، فربما قدم ما هو مؤخر في الأصل، وربما أخر ما هو مقدم، واستقصى في كل كتاب مسائله إلا ما تكرر من المسائل فإنه يحذف المكرر منه، وفي ذلك يقول: «وجعلت مسائلها على الولاء حسب ما هي في الأمهات إلا شيئا يسيرا ربما قدّمته أو أخّرته، واستقصيت مسائل كل كتاب فيه خلا ما تكرر من مسائله، أو ذكر منها في غيره فإني تركته»، وعلى عكس ما فعل ابن أبي زيد فإن البراذعي اقتصر على مسائل المدونة والمختلطة دون أن يضيف إليها غيرها من مسائل الأمهات الأخرى، وقد نص على ذلك أيضا بقوله: «قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غيرها»، هذا مع اعتنائه بتصحيح المدونة وروايتها بسند متصل إلى سحنون. وقد اشتمل كتاب التهذيب على مقدمة وخمسة وثمانين كتابا أولها كتاب الطهارة، وآخرها كتاب الديات. واعتنى العلماء بالنقل عن كتاب التهذيب، فنقل عنه القاضي عياض في «التنبيهات»، وأبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (من علماء القرن السابع ) في «مناهج التحصيل»، والحطاب(ت954هـ) في «مواهب الجليل» في غير ما موضع... وغيرهم، كما تمثلت عناية العلماء به أيضا في تصدي كثير منهم لشرحه، من أمثال: عبد الرحمن بن محرز الإفريقي القيرواني (ت405هـ)، وأبي محمد بن عبد الله بن إسماعيل الإشبيلي (ت 497هـ)، وأبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني (ت839هـ) الذي له عليها شرحان؛ كبير وصغير، إلى غير ذلك من الشروح والتعاليق. قال القاضي عياض: « وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه، وتيمنوا بدرسه وحفظه، وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس» . صدر كتاب التهذيب عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، بتحقيق د. محمد الأمين ولد محمد سالم ابن الشيخ، ظهر الجزء الأول سنة 1420هـ/ 1999م، ثم ظهرت الأجزاء الثلاثة الأخرى سنة 1423هـ/2002م عن نفس الدار، ولنفس المحقق. مصادر الترجمة----------------- ترتيب المدارك: 7/256، معالم الإيمان: 3/146، الديباج المذهب: 1/305. لتحميل الكتاب رابط التحميل 1 (ZIP) (37.05 ميجا بايت) رابط التحميل 2 (PDF) (916.19 كيلو بايت) رابط التحميل 3 (PDF) (8.77 ميجا بايت) رابط التحميل 4 (PDF) (86.57 كيلو بايت) رابط التحميل 5 (PDF) (9.25 ميجا بايت) رابط التحميل 6 (PDF) (9.39 ميجا بايت) رابط التحميل 7 (PDF) (8.66 ميجا بايت)
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 02-03-2023 الساعة 08:05 PM. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 14 : مختصر الطليطلي. 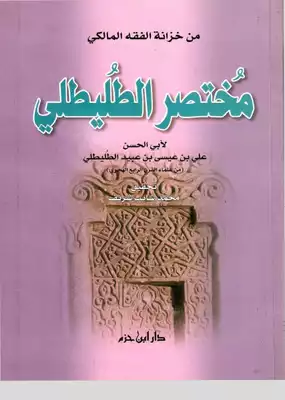 يعد كتاب المختصر لأبي الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي، أحد أعمدة المدرسة الفقهية المالكية بالأندلس خلال القرن الرابع الهجري، نتاجاً لما بذله علماء الأندلس في ترسيخ المدرسة المالكية ببلادهم، تميزت خلالها هذه المدرسة بحركة علمية نشطة، حظيت بتأييد حكام الأندلس، فألف أبو الحسن الطليطلي هذا المختصر الفقهي الذي قيل عنه: من حفظه فهو فقيه قرية، قال ابن مغيث: ولو كانت مثل مصر لمن أتقنه وحفظه، وقال عنه ابن الفخار - ويبدو أنه أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار (ت 419هـ)- كما نقل ذلك ابن فرحون في الديباج: يا أهل طليطلة كتابان جازا قنطرتكم وتلقاهما الناس؛ تفسير يحيى بن مزين ومختصر ابن عبيد. وقد بسط أبو الحسن مختصره بأسلوب سهل وميسر، حرص فيه على تقرير المشهور في المذهب دون ذكر الخلاف في المسألة، مع اجتهاده ما أمكن في تأصيل المسائل الفقهية من الكتاب والسنة. ومما يؤخذ على المختصر عدم استيعابه لجل المباحث الفقهية، فقد اقتصر فيه أبو الحسن على أحكام العبادات بشيء من الإسهاب من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، وبعض أحكام المعاملات مما يتعلق بالربا، وما يجوز بيعه بعضه ببعض وما لا يجوز، وما لا يجوز أن يباع، وبيع الحيوان باللحم، وما يجوز من السلف وما لا يجوز، وباب كراء الأرض، وباب في الاستهلاك. ورغم أن الكتاب جاء مختصرا اسماً ومضمونا، فقد حظي بعناية كبيرة من لدن من جاء بعد الطليطلي من أئمة المذهب المالكي؛ نظماً وتقييداً وشرحاً، فقد عمل عليه أبو عبد الله الكرسوطي الفاسي (ت 690هـ) تقييداً، وشرحه الإمام أبو بكر محمد بن علي ابن الفخار الجذامي(ت 723هـ) في شرح ماتع سماه: منظوم الدرر في شرح كتاب المختصر، كما نظمه في أرجوزة مزدوجة أبو حاتم الضرير أتى فيها على أبوابه، وشرحه ابن كشتغدي محمد بن أحمد المصري القاضي مدرس المالكية بمصر(من علماء ق8هـ)، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الكتاب وقيمته. كما أن المتتبع لكتب الفقه المالكي يقف على نقول عديدة من الكتاب؛ وأبرز من نقل عنه الإمام الباجي (ت 478هـ) في شرحه على الموطأ، وابن جزي الغرناطي(ت 741هـ) في قوانينه، والحطاب الرعيني (ت 954هـ) في مواهب الجليل، والعبدري (ت 897هـ) في التاج والإكليل، وغيرهم. قال القاضي عياض : « قال بعض الفقهاء: من حفظه فهو فقيه قرية؛ قال ابن مغيث: ولو كانت مثل مصر» . والكتاب مطبوع طبعة وحيدة هي المعتمدة في التعريف به؛ طبعة دار ابن حزم- بيروت، بتحقيق محمد شايب شريف، الطبعة الأولى 1425هـ/2004م. مصادر الترجمة -------------- ترتيب المدارك: 6/171-172، بغية الملتمس: 426، الديباج المذهب: 2/88-89. لتحميل الكتاب لا اله الا الله لتصفح الكتاب سبحان الله وبحمده
__________________
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 15: الذخيرة في الفقه المالكي يعد كتاب: « الذخيرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري: (ت 684هـ)، من أهم المصنفات التي ألفت خلال القرن السابع الهجري في الفقه المالكي، أبان فيه عن طول باعه، ورسوخ قدمه في العلم. افتتحه بمقدمة أفصح فيها ، عن سبب التأليف، الذي يعود لما رآه من حاجة مؤلفات كتب المذهب إلى ضرورة جمعها وتهذيبها وتنقيحها وترتيبها في مؤلف، تقبل عليه النفوس ويحرك الهمم. والكتاب تضمن مقدمتين الأولى: في بيان فضيلة العلم وآدابه، والثانية: فيما يتعين معرفته من أصول الفقه، وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء، ثم أردف ذلك بذكر كتب الفقه مع الشرح والتفصيل، بدءا من الطهارة وانتهاء بالجامع. وسلك فيه منهجا رصينا كشف فيه عن قوة ابتكاره وسلامة إبداعه، وسلاسة أسلوبه، ودقة تعبيره، وإحكام تنظيمه، وطريقة إيراده للأقوال وأدلتها، وربط الفرع بالأصل – أي المدونة - وتقديم المشهور من الأقوال متى أمكن ذلك، مع التنبيه على مذاهب المخالفين من الأئمة الثلاثة، واستعماله لبعض الاصطلاحات تفاديا للتطويل الممل، مثل استعماله لحرف «الشين» علامة للشافعي، و«الحاء» لأبي حنيفة، و«الأئمة» علامة على الشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل، و«الصحاح» لمسلم والبخاري والموطأ. كما استعمل داخل الأبواب والفصول والمباحث والفروع المعتادة عناوين فرعية، مثل: تمهيد – تحقيق – تفريع – تنقيح – تحرير – تذييل- قاعدة- فائدة – نظائر ... وتكررت في الذخيرة بعض العبارات وهي: « ليكون الفقيه على بصيره... ليستدل الفقيه... تحفيزا للهمم على إعمال الفكر، وإمعان النظر، واستنكافا عن التقليد والجمود، وأخذ المسائل أحكاما مسلمة». جمع شهاب الدين كتابه من نحو أربعين مصنفا من تصانيف المذهب، اعتمد خمسة منها مصادر أساسية، حيث يقول: «وقد آثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها المالكيون شرقا وغربا، وهي المدونة والجواهر والتلقين والجلاب والرسالة». وقد لقي هذا الكتاب إلى جانب كتبه الأخرى استحسان العلماء وقبولهم لها، عبّر عن ذلك ابن فرحون بأسلوب أدبي رائع حيث قال في الديباج: «سارت مؤلفاته مسير الشمس! ورزق فيها الحظ السامي عن اللّمس! مباحثه كالرياض المونقة! والحدائق المورقة ! تتنزه فيها الأسماع دون الابصار! ويجني الفكر ما بها من أزهار وأثمار! كم حرر مناط الأشكال! وفاق أضرابه النظراء والأشكال! وألف كتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع! وتشنفت بسماعها الأسماع! منها: كتاب الذخيرة من أجل كتب المالكية». وقال أيضا عن القرافي: "الإمام الحافظ، والبحر اللافظ، المفوه المنطيق والآخذ بأنواع الترصيع والتطبيق، دلت مصنفاته على غزارة فوائده، وأعربت عن حسن مقاصده، جمع فأوعى، وفاق أضرابه جنسا ونوعا". طبع الكتاب مرة واحدة بتحقيق مجموعة من المحققين، ونشر عن دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994. مصادر ترجمته : ------------ الديباج المذهب: ( 1/205-208)، شجرة النور الزكية: (188- 189). لتحميل الكتاب رابط التحميل 1 (PDF) (6.64 ميجا بايت) رابط التحميل 2 (PDF) (8.66 ميجا بايت) رابط التحميل 3 (PDF) (8.13 ميجا بايت) رابط التحميل 4 (PDF) (7.63 ميجا بايت) رابط التحميل 5 (PDF) (9.06 ميجا بايت) رابط التحميل 6 (PDF) (6 ميجا بايت) رابط التحميل 7 (PDF) (6.75 ميجا بايت) رابط التحميل 8 (PDF) (5.84 ميجا بايت) رابط التحميل 9 (PDF) (5.39 ميجا بايت) رابط التحميل 10 (PDF) (7.02 ميجا بايت) رابط التحميل 11 (PDF) (6.39 ميجا بايت) رابط التحميل 12 (PDF) (7.05 ميجا بايت) رابط التحميل 13 (PDF) (5.77 ميجا بايت) رابط التحميل 14 (PDF) (3.67 ميجا بايت) رابط التحميل 15 (PDF) (139.42 كيلو بايت) وصف الكتاب كتاب الذخيرة مبتكر في الفقه المالكي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره التي هي في الأعم اختصارات أو شروح وتعليقات وربما كانت الذخيرة أهم المصنفات في الفقه المالكي خلال القرن السابع الهجري وآخر الأمهات في هذا المذهب إذ لا نجد لكبار فقهاء المالكية المغاربة والشارقة الذين عاصروا القرافي أو جاؤوا بعده سوى مختصرات لم تعد على ما أدركت من شهرة وانتشار أن كرست عن غير قصد تعقيد الفقه وإفراغه من محتواه النظري الخصب وأدلته الاجتهادية الحية ليصبح في النهاية مجرد حك ألفاظ ونقاش عقيم يدور في حلقة مفرغة لا تنتج ولا تفيد وإذا كان المذهب المالكي تركز أكثر في الجناح الغربي من العالم الإسلامي فإنه قطع أشواطا متميزة قبل أن يصل إلى تعقيدات عصر القرافي فقد كانت القيروان بالنسبة لهذا الجناح الغربي منطلق إشراق الفقه المالكي وأفوله معا ففيها نشر أسد بن الفرات (ت. 213) المدونة الأولى التي حوت سماعاته من مالك وغيره المعروفة بالأسدية فأخذها سحنون عبد السلام بن سعيد (ت. 240) وصححها على ابن القاسم وسمع من أشهب وابن وهب وغيرهم من تلاميذ مالك ورجع إلى القيروان بالمدونة الكبرى التي نسخت الأسدية وجمعت ستة وثلاثين ألف مسألة فانتشرت في أقطار المغارب والأندلس وظلت ركيزة المذهب المالكي ومرجع فقهائه طوال القرون الأولى وفي القيروان لاحظ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت. 386) كسل الهمم عن إدراك مدونة سحنون فاختصرها اختصارا غير مخل حل محلها وعفى على الاختصارين الأندلسيين السابقين لفضل بن سلمة الجهني (ت. 319) ومحمد بن عيشون الطليطلي (ت. 341) ولسوء الحظ قام في القيروان أيضا خلف بن أبي القاسم البراذعي المتوفى أوائل القرن الخامس باختصار مختصر شيخه ابن أبي زيد القيرواني للمدونة سماه التهذيب فتقبله الناس بقبول حسن وقد ازدادوا حاجة إلى الاختصار حتى إذا جاء أبو عمرو بن الحاجب الدمشقي (ت. 646) واختصر التهذيب فزاده تعقيدا وطم السيل مع خليل بن إسحاق المصري (ت. 749) الذي اختصر مختصر ابن الحاجب في بضعة كراريس فأصبح مختصر خليل المختصر الرابع في مسلسل مختصرات المدونة عبارة عن رموز لا تفهم يحفظ عن ظهر قلب ويقرأ أحزابا في جامع القرويين وغيره ولا تفك رموزه إلا بالرجوع إلى عشرات المجلدات من الشروح والحواشي والتعليقات دون إدراك روح التشريع طبعا وغدا بعض المدرسين (المحققين) لا يختم مختصر خليل إلا بعد أربعين سنة وبذلك تقرر جمود الفقه وتحجره واستمر إلى أيامنا هذه اعتمد القرافي في الذخيرة على نحو أربعين من تصانيف المذهب المالكي وخص خمسة منها كمصادر أساسية يرجع إليها دائما ويقارن بينها ويناقش وكلها كتب مستقلة مبتكرة أصيلة (1) مدونة سحنون القيرواني (2) والتفريغ لعبيد الله بن الجلاب البصري (ت. 368) (3) ورسالة ابن أبي زيد القيرواني (4) والتلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت. 422) (5) والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لعبد الله بن شاس المصري (ت. 610) وتميزت الذخيرة - إلى ذلك - بدقة التعبير وسعة الأفق وسلالة الأسلوب وجودة التقسيم والتبويب الأمر الذي يضفي عليها من جهة أخرى طابع الجدة والحداثة حتى لكأنها كتبت في عصرنا الحاضر بقلم أحد أعلام الفقه والقانون تظهر عبقرية مؤلف الذخيرة وموسوعيته التي سنتحدث عنها بعد قليل في مزجه بين الفقه وأصوله واللغة وقواعدها والمنطق والفلسفة والحساب والجبر والمقابلة في المواطن التي تقتضيها وفي وضعه مصطلحات دقيقة ورموزا واضحة تختصر أسماء الأشخاص والكتب التي يكثر تداولها في الذخيرة تقليلا للحجم فكلمة الأئمة تعني عنده الشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل وش ترمز للشافعي وح لأبي حنيفة والصحاح تعني الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم ونجد في الذخيرة داخل الأبواب والفصول والمباحث والفروع المعتادة عناوين فرعية تضبط المعلومات الإضافية وتحددها وتبرزها أمثال تمهيد تحقيق تفريع تنقيح تحرير تذييل قاعدة فائدة نظائر فروع مرتبة ويمكن أن يعد من مميزات الذخيرة كذلك عناية المؤلف بإبراز أصول الفقه المالكي دحضا للشبهات التي علقت بالأذهان منذ قديم قاصرة أصول الفقه بالنسبة للمذاهب الأربعة على الإمام الشافعي واعتباره هذا الفن برسالته التي حددت منهاجه في استنباط الأحكام من القرآن وكتب أخرى له في القياس وإبطال الاستحسان واختلاف الأحاديث وإذا كان القرافي مسبوقا في هذا المضمار بما كتبه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المتوفى بفاس عام 543 في شرحيه على الموطأ القبس وترتيب المسالك مما يدل على سبق مالك في بناء مذهبه الفقهي على قواعد أصولية محكمة لا شك أن تلميذه الشافعي أخذها عنه ووسعها وألف فيها الرسالة والكتب المذكورة فانتشرت حتى أصبحت الأصول علما مستقلا بذاته إذا كان ذلك فإن مزية مؤلف الذخيرة أن جعل من شرطه فيها تتبع الأصول في مختلف الأبواب قائلا في المقدمة
__________________
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 16 : المنتقى في شرح الموطأ للباجي  يعتبر كتاب المنتقى لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (تـ494هـ) من أهم شروح موطأ الإمام مالك وأحسنها تفريعا وأكثرها فائدة، عمّ نفعه بين الناس، وكثُر تداوله بينهم، ولقي قبولا منقطع النظير. فلا غرابة من كون الكِتَاب أخذ أنظار المهتمين بشروح الموطأ؛ فمؤلفه ـ رحمه الله ـ كان فقيها نظّارا، محققا، راوية، محدّثا، يفهم صنعة الحديث ورجاله، ومتكلما، أصوليا، فصيحا، برز في علم الرّواية والدراية، وفي كتبه الفقهية امتزجت مناهج العراقيين في البحث مع طرائق الأندلسيين والقرويين المحققين، فكان ثمرة ذلك أن تلقى أهل المشرق والمغرب مصنّفاته بقبول كبير. وكتاب «المنتقى في شرح الموطأ» من هذا القبيل؛ فهو دليل على تبحّر مؤلّفه في العلوم والفنون، وكان الباجي قد وضع على الموطأ شرحا موسّعا كبير الحجم سمّاه «الاستيفاء»؛ بلغ فيه الغاية واستوفى، إلاّ أنه لما رأى أكثر الناس قد تعذّر عليهم جمعه، وبَعُدَ عنهم درسه، تصدّى لاختصاره وانتقى منه الكلام على معاني ما يتضمّنه الموطأ من الأحاديث والفقه، ثمّ رأى بعد ذلك أن يزيد في اختصاره، ويقرب للمبتدئين منابع أسراره، فألّف كتاب «الإيماء» مُـخْتَصِراً ما في «المنتقى» من المعاني، ومُقتصراً على إشارات تفيد الشَّادِينَ في الإحاطة بأصول أهل المدينة. وقد وُفّق الباجي توفيقا كبيرا في تطبيق منهجه؛ فهو في المنتقى يورد حديث الموطأ ويشرحه، وكثيرا ما يورد مسائل وفروعا متعلّقة به، مع عرض أقوال الأئمة ومناقشتها أحيانا، ودعم الاتجاه المالكي بدليله، مع ذكر مختلف الروايات، وتوجيه الحُكم في الغالب، كل ذلك مع حسن ترتيب وتنظيم في العرض. ظهرت ملكة الباجي الحديثية والفقهية واضحة متميزة في هذا الكتاب الجليل، كما برزت قدرته الفذة على الجمع بين المدرستين المالكيتين: العراقية والقيروانية، يتضح ذلك في استشهاده بنصوص وآراء القاضي إسماعيل في مبسوطه، والقاضي عبد الوهاب في التلقين، والإشراف، والمعونة، وشرح الرسالة، وابن الجلاب في التفريع، وابن القصار في عيون الأدلة، ممزوجة مع آراء أبي محمد ابن أبي زيد في النوادر، والرسالة، ومختصر المدونة، مع الاعتماد على المدونة والواضحة والعتبية، ولم يكتف الباجي باستيعاب آراء أمّهات الكتب المالكية بل قدّم لنا آراء المذاهب الأخرى شارحاً وموجِّهاً. وقد وصف العلماء الكتاب بأنه أحسن ما أُلّف في مذهب مالك، قال القاضي عياض: «لم يؤلّف مثله»، وقال المقّري:«أحسنُ كتاب أُلّف في مذهب مالك»، وهذا ما حذا بالعلماء إلى العناية به عناية خاصة؛ إذ نجد عليّ بن عبد الله اللّمائي المالطي(تـ539هـ) ألّف كتابا جمع فيه بين «المنتقى» و«الاستذكار» لابن عبد البر، ومحمد بن سعيد بن زرقون (تـ586هـ) ألّف «اختصار المنتقى»، وكتاب «الجمع بين المنتقى والاستذكار» ولهذا الأخير نسخ خطية في المكتبات، كما ألف محمد بن عبد الحق اليَفْرَني (تـ625هـ) «المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار» منه أجزاء في بعض الخزائن، وألّف موسى بن الرويَّة الرُّنْدي «الجمع بين المنتقى والاستذكار»، إلى غير ذلك. ظهرت أولى طبعاته في القاهرة بمطبعة السعادة سنة: 1331هـ/1912م، في 7 أجزاء، ثم طبع بعد ذلك طبعات أخرى يعتريها الكثير من القصور، ولا يزال الكتاب في حاجة إلى تحقيق علمي يرقى به إلى المستوى المطلوب. مصادر ترجمته ------------------------- ترتيب المدارك (8/117)، الصلة (1/198)، تاريخ قضاة الأندلس-المرقبة العليا-(ص95)، الديباج المذهب (1/330)، تذكرة الحفاظ (3/1178) لتحميل الكتاب رابط التحميل 1 رابط اخر رابط التحميل 2
__________________
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 19: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  حظي مختصر الشيخ أبو الضياء خليل بن إسحاق بن موسى بعناية شديدة من لدن العلماء، ما بين مقيد وشارح وناظم، ويعد كتاب أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، والشرح له (الشرح الصغير) للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد الدردير، من أهم الشروح التي وضعت على هذا المختصر، قال عنه صاحبه:«كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل». أما عن تسمية الكتاب فقد أطلقها الشيخ الدردير ليطابق الاسم المسمى، إذ لا تخلو المؤلفات الموضوعة في المذهب، ومنها شروح مختصر خليل من صعوبة في المعنى، فجاء كتابه سهلاً منقحاً، قال عنه: يقرب الأقصى بلفظ موجز*** ويبسط البذل بوعد منجز أما عن شرحه فقد جاء فيه على جميع أبواب المختصر، مبتدئاً بأبواب الطهارة، ومنتهياً بأبواب الفرائض، وختم الكتاب بأبواب في جمل من مسائل شتى وخاتمة حسنة، يظهر فيها الشيخ الدردير فقيهاً ومربياً. وبخصوص منهجه في الكتاب؛ فقد سعى فيه جاهداًً إلى تسهيل مباحثه وتبسيطها، معتمداً في ذلك تجنب ذكر الأقوال الضعاف، وتقييد ما أطلق من المسائل وضده، كما اقتصر الشيخ الدردير عند ذكر الاختلاف في حكم معين، على القول الراجح لدى أهل العلم، فلا يكاد يقع فيه ذكر للقولين في المسألة الواحدة إلا قليلاً، حيث لم يظهر له ترجيحاً لأحدهما، واقتصر في شرحه الصغير على أقرب المسالك على بيان معاني ألفاظه بالأساس، حتى يسهل على المبتدئين فهمه، وشرحه وقراءته، ولخص منهجه في مقدمة شرحه، مبيناً فيه بعض الاصطلاحات المستعملة كإطلاقه للفظ الشيخ والذي يعني به صاحب المختصر(خليل). وقد ألف الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي(ت 1241هـ) حاشية عليه سماها ببلغة السالك لأقرب المسالك، وألف عليه الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل الشيخ مبارك (ت1409هـ) تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. والكتاب مطبوع؛ طبعته دار المعارف- القاهرة، طبعة 1986م، بتخريج وفهرسة د. مصطفى كمال وصفي، وبهامشه حاشية العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي. --------------------------------- اليواقيت الثمينة: 45-46، شجرة النور الزكية: 1/516-517 ، الأعلام للزركلي:1/244 وصف الكتاب يعتبر كتاب « الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » , لصاحبه العلامة الفقيه « أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي (ت1201هـ) » , كتاب عميم النفع عظيم الشأن لابد لطالب العلم من نسخة تزين مسكنه وتحلي عقله وتريه مكامن الزلل في عباداته فتلجمها وتبين الصحيح منها فيا حسرتا على كتاب مالك الصغير فاية الجهد أن تبذل لتصله المخطوطات تنظيما وتنسيقا وعلما . فقد سعى الشيخ الدردير في شرحه هذا على كتابه « أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » جاهداًً إلى تسهيل مباحثه وتبسيطها ، معتمداً في ذلك تجنب ذكر الأقوال الضعاف ، وتقييد ما أطلق من المسائل وضده ، كما اقتصر عند ذكر الاختلاف في حكم معين على القول الراجح لدى أهل العلم ، فلا يكاد يقع فيه ذكر للقولين في المسألة الواحدة إلا قليلاً ، حيث لم يظهر له ترجيحاً لأحدهما . فقد جاء فيه على جميع أبواب المختصر ، مبتدئاً بأبواب الطهارة ، ومنتهياً بأبواب الفرائض ، وختم الكتاب بأبواب في جمل من مسائل شتى وخاتمة حسنة ، يظهر فيها الشيخ الدردير فقيهاً ومربياً . وقد ألف الشيخ « أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت 1241هـ) » , حاشية عليه سماها « بلغة السالك لأقرب المسالك » , وألف عليه الشيخ « أحمد بن عبد العزيز آل الشيخ مبارك (ت1409هـ) » , « تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » . لتحميل الكتاب لا اله الا الله
__________________
|
|
#18
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 17: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي، الأندلسي الإشبيلي المالكي، الحافظ المشهور، من أنفع شروح الموطأ وأشملها، على كثرتها وتوافرها. وأهمية «كتاب القبس» وقيمته العلمية تأتي من إمامة واضعه، وجلالة قدره، فهو الإمام، المفسر، المحدث، الفقيه، الأصولي، اللغوي، المؤرخ، وتسمية ابن العربي شرحه هذا بـ«القَبَس»، بفتحتين، ذات معنى ودلالة، فالقبس يعني شعلة من نار يقتبسها الشخص، ففي التسمية إشارة إلى شدة تعلق هذا الشرح بكتاب الموطأ، وتمكنه منه كتمكن شعلة النار ممن تتعلق به، وإلى كونه صار واضحاً به كما يتضح مَن يكون في ظلمة بشعلة النار التي أتت عليه. وقد أبان الحافظ ابن العربي في كتابه هذا عن علم مالك ومكانته، ومكانة كتابه الموطأ الذي وصفه بأنه أول كتاب ألف في شرائع الإسلام، واعتنى فيه بما قصر فيه غيره، مثل أبي الوليد الباجي الذي لم يهتم بما تضمنه كتاب الموطأ من علوم الحديث، واهتم بمناقشة المسائل الفقهية والأصولية وأظهر أن مالكاً له تقدم وسبق في وضع كثير من المصطلحات الفقهية، وفي كل هذا يقول ابن العربي ـ رحمه الله ـ في مقدمته: «هذا كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب ألف في شرائع الإسلام وهو آخره؛ لأنه لم يؤلف مثله، إذ بناه مالك رضي الله عنه، على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، وسترى ذلك، إن شاء الله، عياناً وتحيط به يقيناً عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى». وبعد المقدمة بدأ ابن العربي في الشرح مباشرة عارضاً المسائل في تقسيم بديع رائع، حيث اختار لها من العناوين البارزة والمعبرة ما يحقق الإفادة من كتابه بطريق سهل متيسر، فقد استعمل عناوين توضيحية مثل قوله: إلحاق، كشف، إيضاح، تفصيل، استلحاق، تفريع، تكملة، تنبيه على مقصد، استدراك، فائدة، نكتة أصولية، تتميم، تحقيق لغوي وتحقيق شرعي، تنبيه على وهم، مسألة أصولية، تأصيل، تعليق، وهم وتنبيه، تفسير، تحديد، تأصيل، ترجمة، تأسيس، عطف، مزلة قدم، عارضة، مزيد إيضاح، توحيد، تأديب، حكمة وحقيقة وتوحيد، بديعة، تبيين مشكلة، توصية، توفية، وهكذا. وسلك ابن العربي في شرح أبواب كتاب الموطأ وما اشتمل عليه منهجا دقيقا، فيستهل بذكر الباب الذي ترجم به مالك، ثم بعد ذلك يقول: «حديث فلان»، ثم يدمج الحديث بالشرح، والتزم في هذا السياق بعدم تكرار المسائل التي سبق أن تناولها، فيكتفي بالإحالة عليها، سواء كانت المسألة في أثناء كتاب القبس أو كتاب آخر من تآليفه، وهذا منهج ينسجم مع مراده من كتابه من جهة الاختصار، والذي نبّه إليه غير ما مرة، يقول مثلا: «وفي تتبع هذه الأوجه كلام طويل لا يليق بهذا القبس» [ القبس 1/108]، إلا أنه منهج قد يفوت على الراغب الكثير من فوائد الشارح ودرر علمه، علما أن ما خطّه في غير هذا الكتاب وأحال عليه في كتاب آخر لن يكون بمقدور كل واحد معرفته والوصول إليه؛ إما لكونه نادرا، أو مخطوطا، أو مفقودا بالمرة. ومن منهجه أيضا عرض ألفاظ المؤلفات الحديثية الأخرى عند الاقتضاء، والنص على الزيادات فيها، والجنوح إلى الصحيح، وبيان الثابت من غيره، سواء في الأحاديث أو الأقوال، واستعمل لهذه الغاية عبارات عدة، مثل: الأصح، الصحيح، المشهور، لا يصح، الضعيف، وغيرها، واعتمد أسلوب الحجاج والمناظر في مناقشة المسائل، فكثيراً ما يسوق آراء المخالفين فيجعل عبارة: «فإن قيل» دالة على قول المخالف، وعبارة:«قلنا» دالة على مناقشته لهم، واستند بقوة ظاهرة إلى علم الأصول، وعلم اللغة؛ استطاع بهما أن يوجه جملة من الأقوال المتعارضة ويرجح بينها، ويقوي ما يذهب إليه من الاستنباطات والتخريجات العلمية. وإن كان ابن العربي لم يُخْف نزعته المالكية في كتابه هذا، كما في أغلب مصنفاته، فإن منهج الإنصاف كان حاضرا عنده فيه، فيجده القارئ يقوي رأيا أو مذهبا معينا على رأي ومذهب المالكية، ويبين في أحيان أخرى أوهامهم وضعف بعض آرائهم، كما يفعل مع بقية أصحاب المذاهب الأخرى، وله ردود على العلماء في مختلف التخصصات العلمية المعروفة، فرد على الفلاسفة والمتكلمين والمحدثين، وغيرهم، كل ذلك في قالب علمي صِرف. وكانت عمدة ابن العربي في وضع هذا الكتاب تراثه العلمي الحافل والمتنوع، فهو يحيل فيه إلى بعض كتبه الأخرى التي سبقت هذا الشرح، خاصة كتب الأصول، وفيه ذكر لبعض الكتب المالكية المعروفة، والأعلام المشهورين، كالمدونة، وأشهب، وابن عبد الحكم، وابن نافع، وابن الماجشون، وعامة علماء المالكية، وغيرهم من أرباب المذاهب الأخرى، كما لشيوخ ابن العربي حضور وذكر في كتابه. وقد أضحى «كتاب القبس» بهذه الميزات التي اختص بها منهلا عذبا، ومصدرا نفيسا لعدد من المصنفين في مختلف ألوان العلوم والفنون، في التفسير، وشروح الحديث، والفقه وأصوله، فمن المفسرين الذي نقلوا منه وصرحوا به القرطبي والثعالبي في تفسيريهما، ومن شراح الحديث ابن حجر في فتح الباري، والسيوطي في تنوير الحوالك، والزرقاني في شرحه، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ومن الفقهاء القرافي في الذخيرة، والمواق في التاج والإكليل، والحطاب في مواهب الجليل، ومن الأصوليين بدر الدين الزركشي في البحر المحيط. طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات، صدر عن دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1992هـ، بتحقيق محمد عبد الله ولد كريم. ------------------------------- الديباج المذهب (2/233-236) وفيات الأعيان (4/296)، طبقات الحفاظ للسيوطي (ص468)، أزهار الرياض (3/62) لتحميل الكتاب لا اله الا الله
__________________
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 20: أحكام القرآن لابن العربي 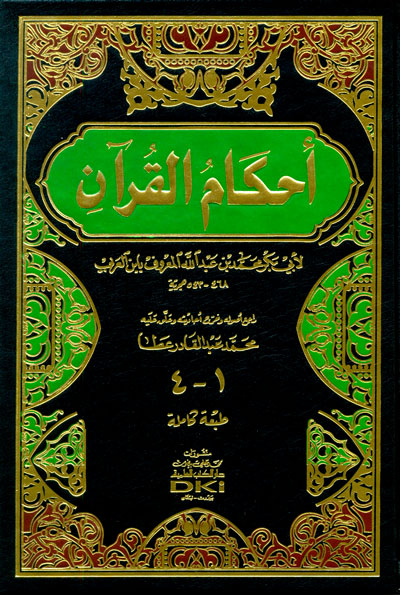 يُعدّ كتاب «أحكام القرآن» أو «الأحكام الكبرى» لأبي بكر بن العربي من أهم مصادر التفسير الفقهي، بل يُعتبر من أمهات كتب المالكية التي تُبيّن أسرار القرآن ومآخذ الأحكام. ومؤلّفه ـ رحمه الله ـ هو الإمام المحدّث، الحَبرُ المفسّر، الأصوليّ، اللغوي، الرُّحلة، أبو بكر محمد ابن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري، نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك... ينتهي نسبه إلى قحطان، وهو معدود ضمن أعيان المالكية في زمانه، أخذ عن أشهر العلماء في المشرق والمغرب، وتلقى عنه أفضل نجباء الزمان، أمثال: القاضي عياض، وابن بشكوال، وغيرهما من الأعلام، يقول عنه تلميذه ابن بشكوال: «وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، متقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، نافذاً في جميعها، حريصاً على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة ولين الكنف، وكثرة الاحتمال وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الوعد»، وترك ـ رحمه الله ـ إرثا زاخرا من المؤلّفات التي أغنت الخزانة الإسلامية، ومن أهمّها كتابنا هذا. وقد ذكر الإمام ابن العربي أسباب تأليفه للكتاب في المقدّمة، ومما يُستغرب له أنّ هذه المقدّمة لم تثبت في جميع طبعات الكتاب ابتداء من النشرة التي صدرت بأمر السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1331هـ، إلى آخر طبعة صدرت ببيروت، وقد وُفّق بعض المتخصّصين إلى الوقوف على نسختي إستانبول وبرلين، ونقل عنهما مقدّمة المؤلّف التي يقول في معرض كلامه عن سبب تأليفه لأحكام القرآن: «وقد نُجز القول في القسم الأوّل من علوم القرآن وهو التوحيد، وفي القسم الثاني وهو النّاسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع، بل غاية لمن أنصف وكفاية؛ بل سَعة لمن سلَّم للحقّ واعترف، فتعيّن الاعتناء بالقسم الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلّفين الشّرعية...»، فبان بهذا أنّ المؤلّف أراد أن يسدّ فجوةً في ما أَلّفه من مصنّفات عن علوم القرآن، وهو القسم الثالث من الكلام في أحكام المكلّفين استنباطاً من نصوص السّور والآيات. واستخرج ابن العربي من سور القرآن آيات الأحكام، وتناول ما تضمنّته من مسائل وفروع فقهية، مستنيراً بمعرفته اللغوية ودرايته الحديثية وتفننه في عدد من العلوم، وجرى في استنباطاته واختياراته على الاستدلال بالكتاب والسنّة والاعتماد على القواعد الفقهية وما تقرر عند الأصوليين. وهو في كلّ ذلك يوازن بين المذاهب، ويؤيد رأيه بالحجّة والمنطق السّليم، وينتصر لمذهب مالك في كثير من الأحيان، وهو شديد النّفرة من الأحاديث الضعيفة، ويبتعد ما وسعه ذلك عن الخوض في الإسرائيليات التي ملأت الكثير من التفاسير. وقد اعتمد ابن العربي في تأليفه على كمّ هائل من المصادر والأمهات، وأكثر ما يمكن أن يقال عن أهمّ مصدر اعتمده هو حافظته الغنية بما تلقّى خلال رحلته الواسعة عن المشايخ والعلماء، وهذا ما ترك أثره الكبير فيمن جاء بعده؛ ودفع العلماء إلى اعتماد كتبه والإكثار من النقل عنها كما هو الشأن بالنسبة إلى كتابه هذا الذي أكثر النّقل عنه جماعة من المفسرين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما، وللأستاذ علال الفاسي تعليقات عليه نشرت في كتاب مفرد بالرباط. وقد طبع أحكام القرآن ـ الذي يبدو أنّه الأحكام الكبرى ـ مراراً، وهو يحتاج إلى طبعة أكثر إتقاناً وضبطاً، ولابن العربي أيضا «الأحكام الصغرى» وهي مطبوعة في مجلّدين بتحقيق سعيد أعراب عن مؤسسة الإسيسكو. --------------------------- الصلة (2/558)، بغية الملتمس (179)، وفيات الأعيان (4/296)، تذكرة الحفاظ (4/1294) لتحميل الكتاب لا اله الا الله
__________________
|
|
#20
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي  تواليف مالكية مهمة 21: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها كثرت الأعمال العلمية حول كتاب المدونة للإمام مالك بن أنس وتنوعت؛ ما بين تقييد، وتعليق، واختصار، وتحشية، وتهذيب، وشرح، ولعل أي كتاب من كتب المذهب لم يحظ بمثل ما حظيت به المدونة، ولا غرو في ذلك؛ إذ هي أصل علم المالكيين، بل ويروى أنه ليس بعد الموطأ ديوان في الفقه أكثر فائدة من المدونة. ويعدُّ كتاب «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها» للإمام العلامة أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، المعروف بابن تامسريت(كان حياً في أواسط القرن القرن7هـ) من أهم شروح المدونة، وأحفلها، وأكثرها بسطاً، وأشدها فائدة ونفعاً. ولا غرابة أن يكون هذا الشرح بهذه الرتبة؛ فمؤلفه أحد كبار فقهاء المغرب في زمانه؛ إذ رغم ندرة المصادر التي ترجمته، نجد العلامة التنبكتي يقول في حقه:«الشيخ الإمام، الفقيه الحافظ، الفروعي، الحاج الفاضل...كان ماهراً في العربية والأصلين». ويرجع الفضل -بعد رب العزة- في تأليف الإمام أبي الحسن الرجراجي لهذا الكتاب إلى بعض طلبته الذين كان يدرسهم المدونة، فقد طلبوا منه أن يجمع لهم ما يتعلق بشرح اصطلاحات المدونة، وتوضيح مشكلاتها وبيان غوامضها، وفي ذلك يقول:« سألني بعض الطلبة المنتمين إلينا والمتعلقين بأذيالنا، الذين طالت صحبتهم معنا أن أجمع لهم بعض ما تعلق عليه اصطلاحنا في مجالس الدرس لمسائل المدونة، ومن وضوح المشكلات وتحصيل وجوه الاحتمالات، وبيان ما وقع فيه من المجملات، فصادف لسانه قلباً منا قريحاً بإتلام حصن الإسلام بموت فقهاء الأمة وسادات الأئمة..»، ثم قال:«والحامل على وضع هذا الكتاب: حميةً على طوائف من المبتدئين، تركوا شمس الضحى واصطلاح المشايخ، وحاولوا الاستضائة بالصبح أول ما يتنفس». والناظر في كتاب مناهج التحصيل يجد الإمام الرجراجي أتى فيه على جميع أبواب المدونة: شرحاً لها، وحلاً لمشكلاتها ومستغلقاتها، فمهّد بمقدمة مفيدة بيّن فيها فضل العلم والتعلم، ثم شرع بعد ذلك بشرح المسائل الفقهية: بادئاً بكتاب الطهارة حتى ختم بكتاب الديّات. ويبلغ مجموع عدد الكتب التي تضمنها تسعة وسبعين كتاباً، تحت كل كتاب جملة من المسائل نثر فيها فوائد غزيرة، وقواعد كثيرة، وفي ذلك يقول:«لخصت فيه من فصول الفوائد، وحصّلت فيه من أمهات القواعد، ما لم يلق في كتب الأولين على هذا الضبط، ولم يصادف في مجالس البحث مما جرى للمتقدمين على ترتيب هذا النمط، وقد يختلف في بعضها فحول المذهب، ونظار المغرب، ولكل واحد منهم فيما اختاره رأي مصيب، والخطب هين في اختلاف الإيراد بعد اتفاق المغزى والمراد قريب، هذا ولم أقصد الطعن في كلام المتقدمين، وتصانيف المتأخرين، بل التمثيل صحيح للسلف الأول وللخلف النظم». وراعى في تحرير مسائل الكتاب حسن السياق، والترتيب، ووجوه التحرير والتهذيب، وتمهيد الدلائل، واستنباط الدليل، مع بيان أسباب الخلاف، وتلفيق ما يمكن تلفيقه من الأقوال، وإزالة الإشكال، واعتنى أيضاً بتلخيص مسائل المدونة، وبيان محل الخلاف فيها، وتحصيل الأقوال، وتنزيلها، وحل مشكلاتها ومحتملاتها بدليل ليشهد بصحتها أو نصوص تقع في المذاهب على وفقها. وبالجملة فإنه لخص في شرحه هذا ما وقع للأئمة من التأويلات، واعتمد على كلام القاضي ابن رشد، والقاضي عياض، وتخريجات أبي الحسن اللخمي. والذي أسعفه رحمه الله في تحقيق هذا المنهج هو ما اتسم به من غزارة العلم وسعة الاطلاع، وكذا شدة اتباعه للدليل، فاستحق أن يكون كتابه عمدة لمن جاء بعده، إذ نقف على نقول مهمة منه في مصادر مالكية عديدة لاسيما: الشرح الكبير لأبي البركات الدردير، وحاشية الدسوقي لمحمد عرفة الدسوقي، الذي أكثر النقل عنه، فيقول مثلا في مسألة السترة1/216):«كما صرح به الرجراجي في مناهج التحصيل وكفى به حجة»، وكذا حاشية العدوي لعلي الصعيدي العدوي، وشرح مختصر خليل للخرشي، ومواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، وبلغة السالك لأحمد الصاوي، ومنح الجليل لمحمد عليش وغيرها.. والكتاب مطبوع في عشرة مجلدات، طبعة دار ابن حزم ( الطبعة الأولى 1428هـ/2007م ) بتحقيق أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي. لتحميل الكتاب لا اله الا الله ----------------------------------- نيل الابتهاج316)، كفاية المحتاج238-239)
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |