|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 2 الى صـــ 10 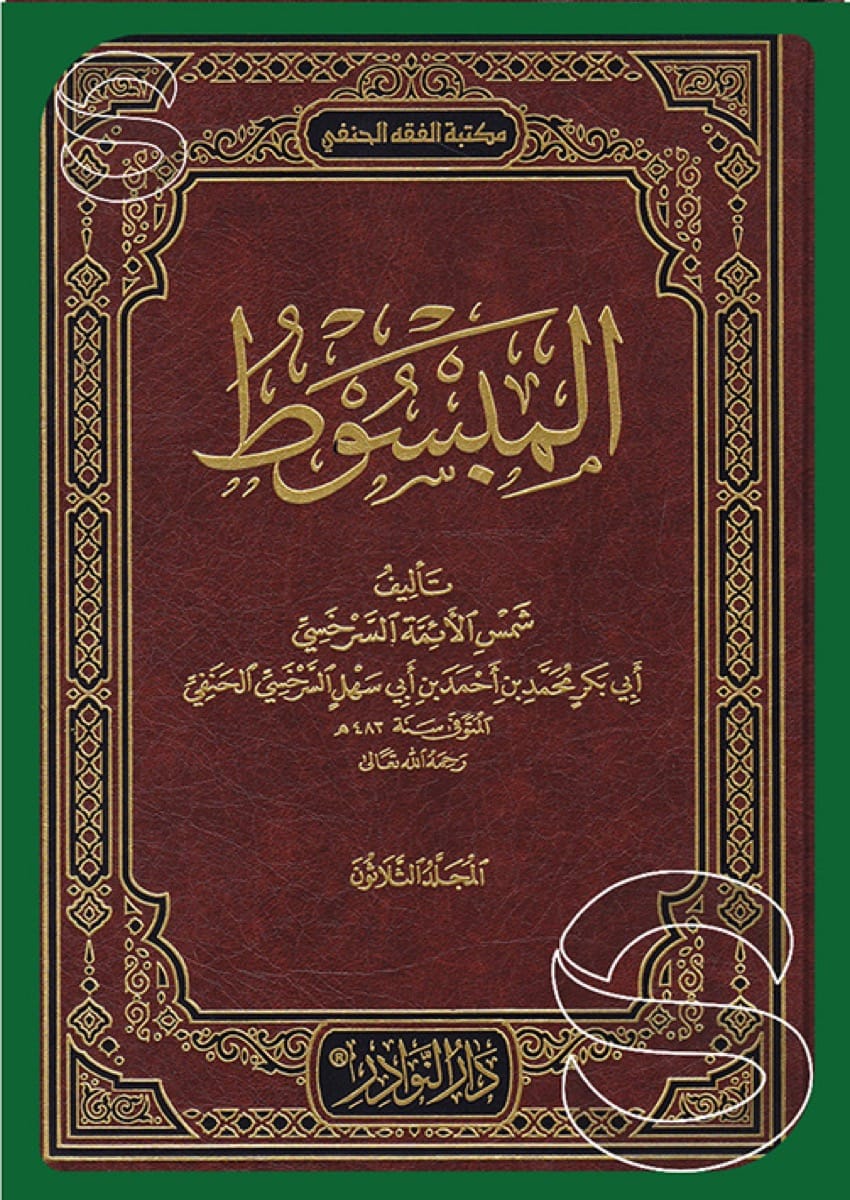 ينكر هذا، ويقول لا يجوز أن يكون شيء من حكم الشرع مشكوكا فيه، ولكن يحتاط فيه فلا يجوز أن يتوضأ به حالة الاختيار، وإذا لم يجد غيره يجمع بينه، وبين التيمم احتياطا فبأيهما بدأ أجزأه إلا على قول زفر فإنه يقول يبدأ بالوضوء فلا يعتبر تيممه مادام معه ماء هو مأمور بالتوضؤ به، ولكن نقول الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب فإن كان طاهرا فقد توضأ به قدم، أو أخر، وإن كان نجسا ففرضه التيمم، وقد أتى به، ولا يقال في هذا ترك الاحتياط من وجه؛ لأنه إن كان نجسا تتنجس به أعضاؤه، وهذا؛ لأن معنى الشك في طهارته لا في كونه طاهرا؛ لأن الحدث يقين فأما العضو، والثوب فطاهر بيقين فلا يتنجس بالشك، والحدث موجود بيقين فالشك وقع في طهارته، واليقين لا يزال بالشك، وهو الصحيح من المذهب. وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في لعاب الحمار إذا أصاب الثوب تجوز الصلاة فيه ما لم يفحش، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أجزأه، وإن فحش، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لو غمس فيه الثوب تجوز الصلاة في ذلك الثوب، وجميع ما بينا في الحمار كذلك في البغل فإن والده غير مأكول اللحم، والصحيح في عرقهما أنه طاهر، وأشار في بعض النسخ إلى جواز الصلاة فيه ما لم يفحش، والأصح هو الأول «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركب حمارا معروريا»، والحر حر تهامة، ولا بد أن يعرق الحمار، ولأن معنى البلوى في عرقه ظاهر لمن يركبه. فأما سؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه مكروه كلحمه وجه ظاهر الرواية، وهو أن السؤر لمعنى البلوى أخف حكما من اللحم كما في الحمار، والبغل، والكراهة التي في اللحم تنعدم في السؤر ليظهر به خفة الحكم. فأما سؤر حشرات البيت كالفأرة، والحية، ونحوهما في القياس فنجس؛ لأنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب من لعابها، ولعابها يتحلب من لحمها، ولحمها حرام، ولكنه استحسن فقال طاهر مكروه؛ لأن البلوى التي، وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة هنا فإنها تسكن البيوت، ولا يمكن صون الأواني عنها. وأما سؤر سباع الطير كالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب، وما لا يؤكل لحمه من الطير في القياس نجس؛ لأن ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير معتبر بما لا يؤكل لحمه من سباع الوحش، ولكنا استحسنا فقلنا بأنه طاهر مكروه؛ لأنها تشرب بمنقارها، ومنقارها عظم جاف بخلاف سباع الوحش فإنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب بلعابها، ولأن في سؤر سباع الطير في الدين» وقال - عليه الصلاة والسلام: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» ولهذا اشتغل به أعلام الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم -. (وأول) من فرع فيه وألف وصنف سراج الأمة أبو حنيفة - رحمة الله عليه - بتوفيق من الله - عز وجل - خصه به، واتفاق من أصحاب اجتمعوا له كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن خنيس الأنصاري - رحمه الله تعالى - المقدم في علم الأخبار، والحسن بن زيادة اللؤلؤي المقدم في السؤال والتفريع، وزفر بن الهذيل - رحمه الله - بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذؤيب بن جذيمة بن عمرو المقدم في القياس، ومحمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله تعالى - المقدم في الفطنة وعلم الإعراب والنحو والحساب. هذا مع أنه ولد في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - ولقي منهم جماعة كأنس بن مالك وعامر بن الطفيل وعبد الله بن خبر الزبيدي - رضوان الله عليهم أجمعين - ونشأ في زمن التابعين - رحمهم الله - وتفقه وأفتى معهم وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ويحلف قبل أن يستحلف». فمن فرع ودون العلم في زمن شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهله بالخير والصدق كان مصيبا مقدما، كيف وقد أقر له الخصوم بذلك؟ حتى قال الشافعي - رضي الله عنه: "الناس كلهم عيال على أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه" . (وبلغ) ابن سريج - رحمه الله - وكان مقدما من أصحاب الشافعي - رحمه الله - أن رجلا يقع في أبي حنيفة - رحمه الله - فدعاه وقال: يا هذا أتقع في رجل سلم له جميع الأمة ثلاثة أرباع العلم وهو لا يسلم لهم الربع. قال: وكيف ذلك؟ قال: الفقه سؤال وجواب وهو الذي تفرد بوضع الأسئلة فسلم له نصف العلم ثم أجاب عن الكل، وخصومه لا يقولون إنه أخطأ في الكل فإذا جعلت ما وافقوه مقابلا بما خالفوه فيه سلم له ثلاثة أرباع العلم وبقي الربع بينه وبين سائر الناس. فتاب الرجل عن مقالته. (ومن) فرغ نفسه لتصنيف ما فرعه أبو حنيفة - رحمه الله - محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - فإنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاءوا أو أبوا إلى أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي - رحمه الله - إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسط في الألفاظ وتكرار في المسائل فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن - رحمه الله - المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائله ترغيبا للمقتبسين ونعم ما صنع. قال الشيخ الإمام) - رحمه الله تعالى - ثم إني رأيت في زماني بعض الإعراض عن الفقه من الطالبين لأسباب: فمنها قصور الهمم لبعضهم حتى اكتفوا بالخلافيات من المسائل الطوال، ومنها ترك النصيحة من بعض المدرسين بالتطويل عليهم بالنكات الطردية التي لا فقه تحتها، ومنها تطويل بعض المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة في شرح معاني الفقه وخلط حدود كلامهم بها. (فرأيت) الصواب في تأليف شرح المختصر لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب، وقد انضم إلى ذلك سؤال بعض الخواص من زمن حبسي، حين ساعدوني لأنسي، أن أملي عليهم ذلك فأجبتهم إليه. (وأسأل) الله - تعالى - التوفيق للصواب، والعصمة عن الخطأ وما يوجب العقاب، وأن يجعل ما نويت فيما أمليت سببا لخلاصي في الدنيا ونجاتي في الآخرة إنه قريب مجيب. [كتاب الصلاة] ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة؛ لأن الصلاة من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله - تعالى - قال الله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة} [التوبة: 5] وقال - عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد الدين» فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد، والصلاة من أعلى معالم الدين ما خلت عنها شريعة المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وقد سمعت شيخنا الإمام الأستاذ شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - يقول في تأويل قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] أي لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل وفي قوله - عز وجل: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] ما يدل على وكادتها، فحين وقعت بها البداية، دل على أنها في القوة بأعلى النهاية، وفي اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية الإيمان فالمصلي في اللغة هو التالي للسابق في الخيل قال القائل ولا بد لي من أن أكون مصليا ... إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق وفي رواية أما كنت ترضى أن أكون مصليا والصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء والثناء قال الله - تعالى: {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] أي دعاءك، وقال القائل: وقابلها الريح في دنها ... وصلى على دنها وارتسم أي دعا وأثنى على دنها وفي الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة كان فيها الدعاء أو لم يكن فالاسم شرعي ليس فيه معنى اللغة، فالدلائل من الكتاب والسنة على فرضيتها مشهورة يكثر تعدادها. [كيفية الوضوء] (ثم بدأ بتعليم الوضوء) فقال: (إذا أراد الرجل الصلاة فليتوضأ) وهذا؛ لأن الوضوء مفتاح الصلاة قال - صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور»، ومن أراد دخول بيت مغلق بدأ بطلب المفتاح، وإنما فعل محمد - رحمه الله - ذلك اقتداء بكتاب الله - تعالى - فإنه إمام المتقين قال الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] فاقتدى بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا، وفي ترك الاستثناء هاهنا وذكره في الحج كما قال الله - تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] ، وفي إضمار الحدث، فإنه مضمر في الكتاب ومعنى قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] من منامكم أو وأنتم محدثون هذا هو المذهب عند جمهور الفقهاء - رحمهم الله -، فأما على قول أصحاب الظواهر فلا إضمار في الآية. والوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ وهذا فاسد لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح أو يوم الخندق صلى الخمس بوضوء واحد فقال له عمر - رضي الله عنه - رأيتك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل. فقال: عمدا فعلت يا عمر كي لا تحرجوا» فقياس مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر، فلا يزال كذلك مشغولا بالوضوء لا يتفرغ للصلاة، وفساد هذا لا يخفى على أحد. قال (وكيفية الوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا) لما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» ولأنه إنما يطهر أعضاءه بيديه، فلا بد من أن يطهرهما أولا بالغسل حتى يحصل بهما التطهير، ثم الوضوء على الوجه الذي ذكره محمد - رحمة الله عليه - في الكتاب رواه حمران عن أبان عن عثمان - رضي الله عنه - أنه توضأ بالمقاعد، ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا وضوءه، وذكر أهل الحديث أنه مسح برأسه وأذنيه ثلاثا (قال) أبو داود في سننه والصحيح من حديث عثمان - رضي الله تعالى عنه - أنه مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة وعلم أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - الناس الوضوء على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصفة ورواه عبد خير عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ في رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر بهذه الصفة، ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلينظر إلى وضوئي هذا. واختلفت الروايات في حديثه في المسح بالرأس فروي ثلاثا وروي مرة فبهذه الآثار أخذ علماؤنا - رحمهم الله -. وقالوا الأفضل أن يتمضمض ثلاثا، ثم يستنشق ثلاثا، (وقال) الشافعي - رضي الله عنه: الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكف ماء واحد لما روي: «عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يتمضمض ويستنشق بكف واحد» وله تأويلان عندنا: أحدهما: أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما فعل في غسل الوجه. والثاني: أنه فعلهما باليد اليمنى فيكون ردا على قول من يقول يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء. قال: (ثم يغسل وجهه ثلاثا) وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى الأذنين؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه، غير أن إدخال الماء في العينين ليس بشرط؛ لأن العين شحم لا يقبل الماء، وفيه حرج أيضا فمن تكلف له من الصحابة - رضوان الله عليهم - كف بصره في آخر عمره كابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -. والرجل الأمرد والملتحي والمرأة في ذلك سواء إلا في رواية أبي يوسف - رحمه الله - قال في حق الملتحي لا يلزمه إيصال الماء إلى البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن هذه العبارة أصح، فإن الشيخ الإمام - رحمه الله - جعل العذار اسما لذلك البياض وليس كذلك بل العذار اسم لموضع نبات الشعر وهو غير البياض الذي بين الأذن، ومنبت الشعر، قال: لأن البشرة التي نبت عليها الشعر لا يجب إيصال الماء إليها فما هو أبعد أولى، لكن الصحيح من المذهب أنه يجب إمرار الماء على ذلك الموضع؛ لأن الموضع الذي نبت عليه الشعر قد استتر بالشعر فانتقل الفرض منه إلى ظاهر الشعر، فأما العذار الذي لم ينبت عليه الشعر فالأمرد والملتحي فيه سواء ويجب إيصال الماء إليه بصفة الغسل، وإنه لا يحصل إلا بتسييل الماء عليه، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أن في المغسولات إذا بله بالماء سقط به الفرض وهذا فاسد؛ لأنه حد المسح، فأما الغسل فهو تسييل الماء على العين وإزالة الدرن عن العين قال القائل: فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها ... وإذ هي تذري دمعها بالأنامل. (ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا)، وإنما لم يقل يديه؛ لأنه في الابتداء قد غسل يديه ثلاثا، وإنما بقي غسل الذراعين إلى المرفقين والمرفق يدخل في فرض الغسل عندنا وكذلك الكعبان وقال زفر - رحمه الله - لا يدخل؛ لأنه غاية في كتاب الله - تعالى - والغاية حد، فلا يدخل تحت المحدود اعتبارا بالممسوحات واستدلالا بقوله - تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] والذي يروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل المرافق» فمحمول على إكمال السنة دون إقامة الفرض ولنا أن من الغايات ما يدخل ويكون حرف "إلى" فيه بمعنى "مع" قال الله - تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] أي مع أموالكم فكان هذا مجملا في كتاب الله بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفعله:، فإنه «توضأ وأدار الماء على مرافقه» ولم ينقل عنه ترك غسل المرافق في شيء من الوضوء فلو كان ذلك جائزا لفعله مرة تعليما للجواز، ثم إن الأصل أن ذكر الغاية متى كان لمد الحكم إلى موضع الغاية لم يدخل فيه الغاية كما في الصوم، فإنه لو قال: "ثم أتموا الصيام" اقتضى صوم ساعة، ومتى كان ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية يبقى موضع الغاية داخلا وها هنا ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية، فإنه لو قال وأيديكم اقتضى غسل اليدين إلى الآباط كما فهمت الصحابة - رضوان الله عليهم - ذلك في آية التيمم في الابتداء فذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية فيبقى المرفق داخلا. (ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة) وتمام السنة في أن يستوعب جميع الرأس بالمسح كما رواه عبد الله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «مسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل بهما وأدبر»، والبداية على ما ذكره هشام عن محمد من الهامة إلى الجبين، ثم منه إلى القفا، والذي عليه عامة العلماء - رحمهم الله - البداية من مقدم الرأس كما في المغسولات البداية من أول العضو، والمسنون في المسح مرة واحدة بماء واحد عندنا، وفي المجرد عن أبي حنيفة - رحمه الله - ثلاث مرات بماء واحد. (وقال) الشافعي - رضي الله تعالى عنه: السنة أن يمسح ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ذكره في شرح المجرد لابن شجاع - رحمه الله - ووجهه الحديث المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فينصرف هذا اللفظ إلى الممسوح والمغسول جميعا ولأنه ركن هو أصل في الطهارة بالماء فيكون التكرار فيه مسنونا كالمغسولات بخلاف المسح بالخف، فإنه ليس بأصل وبخلاف التيمم، فإنه ليس بطهارة بالماء ويلحقه الحرج في تكرار استعمال التراب من حيث تلويث الوجه وذلك الحرج معدوم في الطهارة بالماء. (ولنا): حديث «البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال لأصحابه في مرضه: إني مفارقكم عن قريب، أفلا أعلمكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: نعم. فتوضأ ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة»، وإنما كان ينقل في مثل هذه الحالة ما واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم هذا ممسوح في الطهارة، فلا يكون التكرار فيه مسنونا كالمسح بالخف والتيمم، وتأثيره أن الاستيعاب في الممسوح بالماء ليس بفرض حتى يجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وبالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل إقامة السنة والفريضة، فلا حاجة إلى التكرار بخلاف المغسولات، فإن الاستيعاب فيها فرض، فلا بد من التكرار ليحصل به إقامة السنة، ومعنى الحرج متحقق هاهنا، ففي تكرار بل الرأس بالماء إفساد العمامة ولهذا اكتفى في الرأس بالمسح عن الغسل. ووجه رواية المجرد حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاث مرات بماء واحد»، والكلام في مسح الأذنين مع الرأس يأتي بيانه في موضعه من الكتاب. قال (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا) ومن الناس من قال وظيفة الطهارة في الرجل المسح وقال الحسن البصري - رحمه الله - المضرور يتخير بين المسح والغسل وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال نزل القرآن بغسلين ومسحين يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] ، فإنه معطوف على الرأس وكذلك القراءة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحل، فإن الرأس محله من الإعراب النصب، وإنما صار محفوظا بدخول حرف الجر وهو كقول القائل: معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا (ولنا): «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على غسل الرجلين» وبه أمر من علمه الوضوء «ورأى رجلا يلوح عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار»، وفي رواية «ويل للعراقيب من النار»، وكذلك القراءة بالنصب تنصيص على الأمر بالغسل وأنه عطف على اليد؛ لأن العطف على المحل لا يجوز في موضع يؤدي إلى الالتباس إنما ذلك في موضع لا يؤدي إلى الاشتباه كما في البيت. والقراءة بالخفض عطف على الأيدي أيضا، وإنما صار مخفوضا بالمجاورة كما يقال جحر ضب خرب وماء شن بارد أي خرب وبارد. (فإن قيل علفتها تبنا وماء باردا والماء لا يعلف ولكنه اتباع للمجاورة وكذلك في الإعراب قال جرير فهل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بسطام بن قيس فخاطب أي فخاطب جوز الاتباع مع حرف العطف وهو الفاء. وأما الكعب فهو العظم الناتئ المتصل بعظم الساق وهو المفهوم في اللسان إذا قيل ضرب كعب فلان وقال - عليه الصلاة والسلام: «ألصقوا الكعاب بالكعاب في الصلاة»، وفي قوله: {إلى الكعبين} [المائدة: 6] دليل على هذا؛ لأن ما يوحد من خلق الإنسان يذكر تثنيته بعبارة الجمع كما قال - تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] أي قلباكما وما كان مثنى يذكر تثنيته بعبارة التثنية فلما قال إلى الكعبين عرفنا أنه مثنى في كل رجل، وذلك العظم الناتئ، وروى هشام عن محمد - رحمه الله - أنه قال: المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ووجهه أن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح أي مفاصله والذي في وسط القدم مفصل وهو المتيقن به وهذا سهو من هشام لم يرد محمد - رحمه الله تعالى - تفسير الكعب بهذا في الطهارة، وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين وفسر الكعب بهذا، فأما في الطهارة، فلا شك أنه العظم الناتئ كما فسره في الزيادات فإن توضأ مثنى مثنى أجزأه وإن توضأ مرة سابغة أجزأه وتفسير السبوغ التمام وهو أن يمر الماء على كل جزء من المغسولات جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «توضأ مرة مرة»، والأصل فيه ما رواه ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «توضأ فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه مرتين. وعبد الله بن عمر كان كثيرا ما يتوضأ مرة مرة. وقال هذا وضوء لا يقبل الله - تعالى - الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الله إبراهيم - عليه السلام - فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم»، أي زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها أو زاد على الحد المحدود أو نقص عنه أو زاد على الثلاث معتقدا أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث، فأما إذا زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر، فلا بأس به؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة، وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، ولم يذكر الاستنجاء بالماء هنا؛ لأن مقصوده تعليم الوضوء عند القيام من المنام وليس فيه استنجاء، ولأن الاستنجاء بالماء بعد الإنقاء بالحجر ليس من السنن الراتبة وكان الحسن البصري - رحمه الله - يقول: إن هذا شيء أحدث بعد انقضاء عصر الصحابة - رضوان الله عليهم -، وربما قال هو طهور النساء والمذهب أنه ليس من السنن الراتبة بل لاكتساب زيادة الفضيلة. جاء في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] «قال - عليه الصلاة والسلام: لأهل قباء ما هذه الطهرة التي خصصتم بها فقالوا إنا كنا نتبع الأحجار الماء فقال هو ذاك»، ولم يذكر فيه مسح الرقبة، وبعض مشايخنا يقول إنه ليس من أعمال الوضوء والأصح أنه مستحسن في الوضوء قال ابن عمر - رضي الله عنهما - امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار ولم يذكر تحريك الخاتم ولا نزعه وذكر أبو سليمان عن محمد - رحمه الله - أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء والحاصل أنه إن كان واسعا يدخله الماء، فلا حاجة إلى النزع والتحريك، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته، فلا بد من تحريكه، وفي التيمم لا بد من نزعه ولو لم يفعل لا تجزئه صلاته. ثم سنن الوضوء وآدابه فرقها محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب فنذكر كل فصل في موضعه - إن شاء الله تعالى - تحرزا عن التطويل [كيفية الدخول في الصلاة] قال (إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه) وظن بعض أصحابنا - رحمهم الله - أنه لم يذكر النية وليس كما ظنوا، فإن إرادة الدخول في الصلاة هي النية والنية لا بد منها لقوله - عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، وقال - عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنيات»، والنية معرفة بالقلب أي صلاة يصلي وحكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال مع هذا: في الفرائض يحتاج إلى نية الفرض. وهذا بعيد، فإنه إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض، فالظهر لا يكون إلا فرضا، فإن كان منفردا أو إماما فحاجته إلى نية ماهية الصلاة، وإن كان مقتديا احتاج مع ذلك إلى نية الاقتداء، وإن نوى صلاة الإمام جاز عنهما. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله يحتاج إلى نية الكعبة أيضا، والصحيح أن استقباله إلى جهة الكعبة يغنيه عن نيتها، والأفضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير، فإن نوى قبله حين توضأ ولم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته جاز عندنا وهو محفوظ عن أبي يوسف ومحمد جميعا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله - قال: الحاجة إلى النية ليكون عمله عن عزيمة وإخلاص وذلك عند الشروع فيها. ونحن هكذا نقول ولكن يجوز تقديم النية ويجعل ما قدم من النية إذا لم يقطعه بعمل كالقائم عند الشروع حكما كما في الصوم، وكان محمد بن سليمان البلخي يقول: إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل: أي صلاة يصلي؟ أمكنه أن يجيب على البديهة من غير تفكر فهو نية كاملة تامة، والتكلم بالنية لا معتبر به، فإن الاربعاء الموافق 13/شعبان/1446هـــ
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 28-07-2025 الساعة 10:06 PM. |
|
#2
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 11 الى صـــ 20 فعله ليجتمع عزيمة قلبه فهو حسن. وأما التكبير، فلا بد منه للشروع في الصلاة إلا على قول أبي بكر الأصم وإسماعيل ابن علية، فإنهما يقولان يصير شارعا بمجرد النية، والأذكار عندهما كالتكبير والقراءة، ونية الصلاة ليست من الواجبات قالا: لأن مبنى الصلاة على الأفعال لا على الأذكار ألا ترى أن العاجز عن الأذكار القادر على الأفعال يلزمه الصلاة بخلاف العاجز عن الأفعال القادر على الأذكار؟ ولنا قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] أي ذكر اسم الله - تعالى - عند افتتاح الصلاة، وظاهر قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] يبين أن المقصود ذكر الله - تعالى - على وجه التعظيم فيبعد أن يقال ما هو المقصود لا يكون واجبا وهذا المعنى، فإن الصلاة تعظيم بجميع الأعضاء، وأشرف الأعضاء اللسان، فلا بد من أن يتعلق به شيء من أركان الصلاة. وقال - عليه الصلاة والسلام: «وتحريمها التكبير»، فدل أن بدونه لا يصير شارعا وتحريمة الصلاة تتناول اللسان ألا ترى أن الكلام مفسد للصلاة؟ ولو لم يتناوله التحريم لم يكن مفسدا كالنظر بالعين ومبنى الصلاة على الأفعال دون الكف فكل ما يتناوله التحريم يتعلق به شيء من أركان الصلاة. فأما رفع اليدين عند التكبير فهو سنة؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام: «علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر له رفع اليد»؛ لأنه ذكر الواجبات وواظب على رفع اليد عند التكبير فدل أنه سنة والمروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه ينبغي أن يقرن التكبير برفع اليدين والذي عليه أكثر مشايخنا أنه يرفع يديه أولا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر؛ لأن في فعله وقوله معنى النفي والإثبات، فإنه برفع اليد ينفي الكبرياء عن غير الله - تعالى - وبالتكبير يثبته لله - تعالى - فيكون النفي مقدما على الإثبات كما في كلمة الشهادة. ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند رفع اليد والذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه كبر ناشرا أصابعه»، معناه ناشرا عن طيها بأن لم يجعله مثنيا بضم الأصابع إلى الكف. والمسنون عندنا أن يرفع يديه حتى يحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ورءوس أصابعه فروع أذنيه وهو قول أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - وعند الشافعي - رحمه الله - المسنون أن يرفع يديه إلى منكبيه وهو قول ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - واحتج بحديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أنه كان في عشرة من أصحابه فقال ألا أخبركم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: نعم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه»، ولنا حديث وائل بن حجر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه»، والمصير إلى هذا أولى؛ لأن فيه إثبات الزيادة، وتأويل حديثهم أنه كان عند العذر في زمن البرد حين كانت أيديهم تحت ثيابهم، والمعنى أن خلف الإمام أعمى وأصم فأمر بالجهر بالتكبير ليسمع الأعمى وبرفع اليدين ليرى الأصم فيعلم دخوله في الصلاة وهذا المقصود إنما يحصل إذا رفع يديه إلى أذنيه وكان طاوس - رحمه الله - يرفع يديه فوق رأسه ولا نأخذ بهذا لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا قد شخص ببصره إلى السماء ورفع يديه فوق رأسه فقال له - عليه الصلاة والسلام - غض بصرك، فإنك لن تراه وكف يدك، فإنك لن تناله». ولا يطأطئ رأسه عند التكبير ذكره في كتاب الصلاة للحسن بن زياد - رحمه الله - وقال فيه: التزاوج بين القدمين في القيام أفضل من أن ينصبهما نصبا. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جاء عن الضحاك - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك حين تقوم} [الطور: 48] أنه قول المصلي عند الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وروى هذا الذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم: «أنه كان يقوله عند افتتاح الصلاة»، ولم يذكر وجل ثناؤك؛ لأنه لم ينقل في المشاهير، وذكر محمد - رحمه الله - في كتاب الحجة عن أهل المدينة ويقول المصلي أيضا وجل ثناؤك وعن أبي يوسف في الأمالي قال أحب إلي أن يزيد في الافتتاح: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا»، إلى آخره والشافعي - رضي الله تعالى عنه - يقول بهذا ويزيد عليه أيضا ما رواه علي - رضي الله عنه - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»، وفي بعض الروايات: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أنا بك ولك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك»، فتأويل هذا كله عندنا أنه كان في التهجد بالليل والأمر فيه واسع، فأما في الفرائض، فإنه لا يزيد على ما اشتهر فيه - الأثر. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسه لما روي أن أبا الدرداء - رضي الله تعالى عنه - قام ليصلي فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن»، والذين نقلوا صلاة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ذكروا تعوذه بعد الافتتاح قبل القراءة ولأن من أراد قراءة القرآن ينبغي له أن يتعوذ لقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] وأصحاب الظواهر أخذوا بظاهر الآية وقالوا نتعوذ بعد القراءة؛ لأن الفاء للتعقيب ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن هذه الفاء عندنا للحال كما يقال إذا دخلت على السلطان فتأهب أي إذا أردت الدخول عليه فتأهب فكذا معنى الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، بيانه في حديث الإفك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كشف الرداء عن وجهه فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} [النور: 11] الآيات، وبظاهر الآية قال عطاء الاستعاذة تجب عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وهو مخالف لإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنه سنة وبين القراء اختلاف في صفة التعوذ فاختيار أبي عمرو وعاصم وابن كثير - رحمهم الله - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زاد حفص من طريق هبيرة أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان، واختيار نافع وابن عامر والكسائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، واختيار حمزة الزيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو قول محمد بن سيرين وبكل ذلك ورد الأثر. وإنما يتعوذ المصلي في نفسه إماما كان أو منفردا؛ لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان يجهر به لنقل نقلا مستفيضا والذي روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه جهر بالتعوذ تأويله أنه كان وقع اتفاقا لا قصدا أو قصد تعليم السامعين أن المصلي ينبغي أن يتعوذ كما نقل عنه الجهر بثناء الافتتاح، فأما المقتدي، فلا يتعوذ عند محمد - رحمه الله -؛ لأنه لا يقرأ خلف الإمام، فلا يتعوذ حتى أن المسبوق إذا قام لقضاء ما سبق به حينئذ يتعوذ في إحدى الروايتين عن محمد، وعن أبي يوسف يتعوذ المقتدي، فإن التعوذ عنده بمنزلة الثناء لما يأتي بيانه في باب العيدين، والتعوذ عند افتتاح الصلاة خاصة إلا على قول ابن سيرين - رحمه الله -، فإنه يقول يتعوذ في كل ركعة كما يقرأ وهذا فاسد فإن الصلاة واحدة فكما لا يؤتي لها إلا بتحريمة واحدة فكذا التعوذ والله أعلم. قال (ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح) وقال الشافعي يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ومن الناس من يقول وعند السجود وعند رفع الرأس منه يرفع اليدين أيضا قالوا قد صح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند كل تكبيرة»، فمن ادعى النسخ فعليه إثباته، وفي المسألة حكاية، فإن الأوزاعي لقي أبا حنيفة - رحمهم الله - في المسجد الحرام فقال ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع»، فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم لا يعود». فقال الأوزاعي عجبا من أبي حنيفة أحدثه بحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم عن علقمة فرجح حديثه بعلو إسناده فقال أبو حنيفة أما حماد فكان أفقه من الزهري وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم ولولا سبق ابن عمر - رضي الله عنه - لقلت بأن علقمة أفقه منه وأما عبد الله فرجح حديثه بفقه رواته وهو المذهب؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد فالشافعي اعتمد حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وقال تكبير الركوع يؤتى به حالة القيام فليسن رفع اليد عنده كتكبيرة الافتتاح ألا ترى أنه محسوب من تكبيرات العيد ورفع اليد مسنون في تكبيرات العيد فكذا هذا ولنا أن الآثار لما اختلفت في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحاكم إلى قوله وهو الحديث المشهور: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة، وفي العيدين والقنوت في الوتر»، وذكر أربعة في كتاب المناسك وحين رأى بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يرفعون أيديهم في بعض أحوال الصلاة كره ذلك فقال «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا»، وفي رواية: «قاروا في الصلاة»، والمعنى فيه أن هذه التكبيرة يؤتى بها في حال الانتقال، فلا يسن رفع اليد عنده كتكبيرة السجود وفقهه ما بينا أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلفه وهذا إنما يحتاج إليه في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كالتكبيرات الزوائد في العيدين وتكبير القنوت ولا حاجة إليه فيما يؤتى به في حالة الانتقال، فإن الأصم يراه ينحط للركوع، فلا حاجة إلى الاستدلال برفع اليد. (ثم يفتتح القراءة ويخفي ببسم الله الرحمن الرحيم) فقد أدخل التسمية في القراءة بهذا اللفظ وهذا إشارة إلى أنها من القرآن وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول لا يأتي المصلي بالتسمية لا سرا ولا جهرا لحديث عائشة - رضي الله عنها: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين»، ولنا حديث أنس قال «صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم» وتأويل حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه كان يخفي التسمية وهو مذهبنا وهو قول علي وابن مسعود وقال الشافعي - رحمه الله - يجهر بها الإمام في صلاة الجهر وهو قول ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - وعن عمر فيه روايتان واحتج بحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالتسمية»، ولما صلى معاوية بالمدينة ولم يجهر بالتسمية أنكروا عليه وقالوا أسرقت من الصلاة؟ أين التسمية؟ فدل أن الجهر بها كان معروفا عندهم ولنا حديث عبد الله بن المغفل - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع ابنه يجهر بالتسمية في الصلاة فنهاه عن ذلك فقال يا بني إياك والحدث في الإسلام «، فإني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فكانوا لا يجهرون بالتسمية» وهكذا روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه -. والمسألة في الحقيقة تنبني على أن التسمية ليست بآية من أول الفاتحة ولا من أوائل السور عندنا وهو قول الحسن - رحمه الله -، فإنه كان يعد {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] آية، وقال الشافعي - رحمه الله - التسمية آية من أول الفاتحة قولا واحدا وله في أوائل السور قولان وكان ابن المبارك يقول: التسمية آية من أول كل سورة حتى قال: من ختم القرآن وترك التسمية فكأنما ترك مائة وثلاث عشرة آية أو مائة وأربع عشرة آية. والشافعي - رحمه الله - ربما احتج بحديث أبي الجوزاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم: «قرأ الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ثم قال: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] وعدها آية»، ولأنها مكتوبة في المصاحف بقلم الوحي لمبدأ الفاتحة وكل سورة، وقد أمرنا بتجريد القرآن في المصاحف من النقط والتعاشير ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات ولا تكون سبع آيات إلا بالتسمية وقول من يقول: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] آية {وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] آية ضعيف تشهد المقاطع بخلافه. ولنا حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «قال: يقول الله - تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] يقول الله - تعالى - حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3] قال الله - تعالى - مجدني عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] قال الله - تعالى - أثنى علي عبدي، وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] قال الله - تعالى - هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل»، فالبداءة بقوله الحمد لله رب العالمين دليل على أن التسمية ليست بآية من أول الفاتحة إذ لو كانت آية من أول الفاتحة لم تتحقق المناصفة، فإنه يكون في النصف الأول أربع آيات إلا نصفا، وقد نص على المناصفة والسلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات وهي ثلاث آيات بدون التسمية ولأن أدنى درجات اختلاف الأخبار والعلماء إيراث الشبهة والقرآن لا يثبت مع الشبهة، فإن طريقه طريق اليقين والإحاطة. (وعن) معلى قال قلت لمحمد التسمية آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلم لم تجهر؟ فلم يجبني. فهذا عن محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور لا من أوائل السور ولهذا كتبت بخط على حدة وهو اختيار أبي بكر الرازي - رحمه الله - حتى قال محمد - رحمه الله - يكره للحائض والجنب قراءة التسمية على وجه قراءة القرآن؛ لأن من ضرورة كونها قرآنا حرمة قراءتها على الحائض والجنب وليس من ضرورة كونها قرآنا الجهر بها كالفاتحة في الآخرتين. ودليل هذا ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال لعثمان لم لم تكتب التسمية بين التوبة والأنفال؟ قال: لأن التوبة من آخر ما نزل فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ولم يبين لنا شأنها فرأيت أوائلها يشبه أواخر الأنفال فألحقتها بها فهذا بيان منهما أنها كتبت للفصل بين السور. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمة الله عليهما - أن المصلي يسمي في أول صلاته، ثم لا يعيد؛ لأنها لافتتاح القراءة كالتعوذ. (وروى) المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يؤتى بها في أول كل ركعة، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله -، وهو أقرب إلى الاحتياط لاختلاف العلماء - والآثار في كونها آية من الفاتحة. (وروى) ابن أبي رجاء عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال إذا كان يخفي القراءة يأتي بالتسمية بين السورة والفاتحة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإذا كان يجهر لا يأتي بها بين السورة والفاتحة؛ لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون ذلك سكتة له في وسط القراءة ولم ينقل ذلك مأثورا. ثم قال (ويجهر الإمام في صلاة الجهر ويخافت في صلاة المخافتة) وهي الظهر والعصر وكان ابن عباس - رضي الله عنه - يقول لا قراءة في هاتين الصلاتين لظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام: «صلاة النهار عجماء»، أي ليس فيها قراءة، والدليل على فساد هذا القول قوله - عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بقراءة»، وقيل لخباب بن الأرت - رضي الله تعالى عنه: «بم عرفتم قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته»، وقال قتادة - رضي الله عنه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمعنا الآية والآيتين في صلاة الظهر أحيانا». (وقال) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه: «سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر فظننا أنه قرأ: {الم} [السجدة: 1] {تنزيل} [السجدة: 2] السجدة»: «، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الابتداء يجهر بالقرآن في الصلاة كلها»، وكان المشركون يؤذونه ويسبون من أنزل ومن أنزل عليه فأنزل الله - تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} [الإسراء: 110] فكان يخافت بعد ذلك في صلاة الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين للأذى في هذين الوقتين، ويجهر في صلاة المغرب؛ لأنهم كانوا مشغولين بالأكل، وفي صلاة العشاء والفجر؛ لأنهم كانوا نياما، ولهذا جهر في الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامها بالمدينة وما كان للكفار بها قوة الأذى، وقد صح رجوع ابن عباس - رضي الله عنه - عن هذا القول، فإن رجلا سأله أأقرأ خلف إمامي؟ فقال أما في الظهر والعصر فنعم، وتأويل قوله عجماء أي ليس فيها قراءة مسموعة ونحن نقول به. وحد القراءة في هاتين الصلاتين أن يصحح الحروف بلسانه على وجه يسمع من نفسه أو يسمع منه من قرب أذنه من فيه، فأما ما دون ذلك فيكون تفكرا ومجمجة لا قراءة، فإن كان وحده يخافت في هاتين الصلاتين كالإمام، فأما في صلاة الجهر فيتخير، فإن شاء خافت؛ لأن الجهر لإسماع من خلفه وليس خلفه أحد، وإن شاء جهر، وهو أفضل؛ لأنه يكون مؤديا صلاته على هيئة الصلاة بالجماعة والمنفرد مندوب إلى هذا. وكذلك في التهجد بالليل إن شاء خافت، وإن شاء جهر، وهو أفضل لما روي عن عائشة - رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهجده كان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان»، «ومر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي بكر، وهو يتهجد ويخفي بالقراءة وبعمر، وهو يجهر بالقراءة وببلال، وهو ينتقل من سورة إلى سورة فلما أصبحوا سأل كل واحد منهم عن حاله فقال أبو بكر - رضي الله عنه - كنت أسمع من أناجيه وقال عمر - رضي الله عنه - كنت أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وقال بلال - رضي الله عنه - كنت أنتقل من بستان إلى بستان فقال لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا ولعمر أخفض من صوتك قليلا ولبلال إذا ابتدأت سورة فأتمها»، وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله - يقول يتخير الإمام في التسمية بين الجهر والمخافتة وهذا مذهبه في كل ما اختلف فيه الأثر كرفع اليد عند الركوع وتكبيرات العيد ونحوها يستدل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استجمر فليوتر من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج»، وهذا ضعيف، فإن آخر الفعلين يكون ناسخا لأولهما والقول بالتخيير بين الناسخ والمنسوخ عملا لا يجوز. قال (والقراءة في الركعتين الأوليين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب) ، وإن تركها جاز. والمذهب عندنا أن فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة، وكان الحسن البصري يقول في ركعة واحدة وكان مالك يقول في ثلاث ركعات والشافعي - رضي الله تعالى عنه - يقول في كل ركعة. واستدل الحسن البصري بقوله - عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بقراءة»، وهذا يقتضي فرضية القراءة لا تكرارها، فإن الكل صلاة واحدة وهذا ضعيف، فإنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز، وقد سمى الله - تعالى - الفاتحة مثاني؛ لأنها تثنى في كل صلاة أي تقرأ مرتين. والشافعي - رضي الله عنه - احتج فقال أجمعنا على فرضية القراءة في كل ركعة من التطوع، والفرض أقوى من التطوع فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الأولى، ولأن كل ركعة تشتمل على أركان الصلاة، وسائر الأركان كالقيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذلك ركن القراءة وهكذا قال مالك - رحمه الله - إلا أنه قال: أقيم القراءة في أكثر الركعات مقامها في الجميع تيسيرا. ولنا إجماع الصحابة، فإن أبا بكر كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - على جهة الثناء، وروي أنه قرأ في الأخيرتين: {آمن الرسول} [البقرة: 285] على جهة الثناء، وعمر - رضي الله تعالى عنه - ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر، وعثمان - رضي الله تعالى عنه - ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر، وعن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا في الأخيرتين يسبحان، وسأل رجل عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن قراءة الفاتحة في الأخيرتين فقالت اقرأ ليكون على جهة الثناء وكفى بإجماعهم حجة. قال (ثم القراءة في الأخيرتين ذكر يخافت بها في كل حال) ، فلا تكون ركنا كثناء الافتتاح وتأثيره أن مبنى الأركان على الشهرة والظهور ولو كانت القراءة في الأخيرتين ركنا لما خالف الأوليين في الصفة كسائر الأركان، وكل شفع من التطوع صلاة على حدة بخلاف الفرض حتى أن فساد الشفع الثاني في التطوع لا يوجب فساد الشفع الأول. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأفضل له أن يقرأ الفاتحة في الأخيرتين، وإن ترك ذلك عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا فعليه سجود السهو. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يتخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ولا يلزمه سجود السهو بترك القراءة فيهما ساهيا، وهو الأصح. فسجود السهو يجب بترك الواجبات أو السنن المضافة إلى جميع الصلاة، ووجه رواية الحسن أنه إذا سكت قائما كان سامدا متحيرا، وتفسير السامد المعرض عن القراءة فقد كره ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه فقال: «مالي أراكم سامدين». قال (ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عندنا) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - تتعين حتى لو ترك حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته، واستدل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على قراءتها في كل ركعة. ولنا قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد، ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجب حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص، وهو الآية، ولا يفترض عليه قراءة السورة مع الفاتحة في الأوليين إلا على قول مالك - رحمه الله تعالى - يستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها أو قال وشيء معها»، ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به للأصل الذي قلنا. قال: (وإذا أراد أن يركع كبر) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر حين يهوي إلى الركوع»، ومن الناس من يقول لا يكبر عند الركوع ولا عند السجود، وهو قول ابن عمر وأصحابه، ويروون عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لا يتم التكبير، فأما عمر وعلي وابن مسعود - رضوان الله عليهم - فكانوا يكبرون عند الركوع والسجود حتى روي أن عليا - رضي الله عنه - صلى بأصحابه يوما فقام أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وقال ذكرني هذا الفتى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في كل خفض ورفع، أو قال: عند كل خفض ورفع»، وتأويل حديث عثمان - رضي الله عنه - كان لا يتم التكبير أي جهرا أي يخافت بآخر التكبير كما هو عادة بعض الأئمة. قال: (ووضع يديه على ركبتيه) ، وهو قول عامة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وكان ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وأصحابه يقولون بالتطبيق وصورته أن يضم إحدى الكفين إلى الآخر ويرسلهما بين فخذيه، ورأى سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - ابنا له يطبق فنهاه فقال رأيت عبد الله بن مسعود يفعل هكذا فقال رحم الله ابن أم عبد كنا أمرنا بهذا، ثم نهينا عنه، وفي حديث الأعرابي حين علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: «ثم اركع وضع يديك على ركبتيك»، وهكذا في حديث أنس - رضي الله عنه -. قال: (وفرج بين أصابعه) ولا يندب إلى التفريق بين الأصابع في شيء من أحوال الصلاة إلا هذا ليكون من الأخذ بالركبة، فإن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال يا معشر الناس أمرنا بالركب فخذوا بالركب. قال: (وبسط ظهره) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وعائشة - رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر». قال: (ولا ينكس رأسه ولا يرفعه) ومعناه يسوي رأسه بعجزه، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يذبح المصلي تذبخ الحمار»، يعني إذا شم البول أو أراد أن يتمرغ. قال: (وإذا اطمأن راكعا رفع رأسه) والطمأنينة مذكورة في حديث الأعرابي قال: «ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك»، وكذلك قال في السجود وعند رفع الرأس وهكذا في حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - حين علمه الصلاة قال: «ثم اركع حتى يستقر كل عضو منك»، ثم قال في آخر الحديث: «فإنها من سنتي، ومن تبع سنتي فقد تبعني، ومن تبعني كان معي في الجنة». ثم (يقول سمع الله لمن حمده ويقول من خلفه: ربنا لك الحمد) ولم يقلها الإمام في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويقولها في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد»، وعن علي - رضي الله عنه - قال ثلاث يخفيهن الإمام، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - أربع يخفيهن الإمام، وفي جملته ربنا لك الحمد ولأنا لا نجد شيئا من أذكار الصلاة يأتي به المقتدي دون الإمام فقد يختص الإمام ببعض الأذكار كالقراءة ولأبي حنيفة - رحمه الله - قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد»، فقسم هذين الذكرين بين الإمام والمقتدي ومطلق القسمة يقتضي أن لا يشارك كل واحد منهما صاحبه في قسمه ولأن المقتدي يقول ربنا لك الحمد عند قول الإمام سمع الله لمن حمده فلو قال الإمام ذلك لكانت مقالته بعد مقالة المقتدي وهذا خلاف موضوع الإمامة. وتأويل الحديث المرفوع 
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 21 الى صـــ 30 (3) في التهجد حالة الانفراد وبه نقول، فأما المنفرد على قولهما فيجمع بين الذكرين وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن هكذا، وفي رواية أبي يوسف قال يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهو الأصح؛ لأنه حث لمن خلفه على التحميد وليس خلفه أحد، وعلى قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كل مصل يجمع بين الذكرين وهذا بعيد، فإن الإمام يحث من خلفه على التحميد، فلا معنى لمقابلة القوم إياه بالحث بل ينبغي أن يشتغلوا بالتحميد. والشافعي - رضي الله تعالى عنه - يزيد على هذا ما نقل في حديث علي - رضي الله تعالى عنه: «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد» إلخ، وتأويله عندنا في التهجد. قال: (ثم يكبر ويسجد فإذا اطمأن ساجدا رفع رأسه وكبر فإذا اطمأن قاعدا سجد أخرى وكبر) ، وقد بينا أو تكلموا أن السجود لماذا كان في كل ركعة مثنى والركوع واحد؟ فمذهب الفقهاء أن هذا تعبدي لا يطلب فيه المعنى كأعداد الركعات، وقيل إنما كان السجود مثنى ترغيما للشيطان، فإنه أمر بسجدة فلم يفعل فنحن نسجد مرتين ترغيما له وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - في سجود السهو فقال: «هما ترغيمتان للشيطان»، وقيل إنه في السجدة الأولى يشير إلى أنه خلق من الأرض، وفي الثانية يشير إلى أنه يعاد إليها، قال الله - تعالى: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم} [طه: 55] الآية. (ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه) لحديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله تعالى عنه - قال لما نزل قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوها في ركوعكم»، ولما نزل قوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوها في سجودكم» قال عقبة: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا». وروى ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، ومن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه»، ولم يرد بهذا اللفظ أدنى الجواز، وإنما أراد به أدنى الكمال، فإن الركوع والسجود يجوزان بدون هذا الذكر إلا على قول ابن أبي مطيع البلخي، فإنه كان يقول كل فعل هو ركن يستدعي ذكرا فيه يكون ركنا كالقيام، ولكنا نقول لو شرع في الركوع ذكر هو ركن لكان من القرآن، فإن الركوع مشبه بالقيام وحين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الصلاة لم يذكر له في الركوع والسجود شيئا من الأذكار، وقد بين له الأركان، ولو زاد على الثلاث كان أفضل إلا أنه إذا كان إماما لا ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم؛ لأنه يصير سببا للتنفير وذلك مكروه، فإن معاذا لما طول القراءة «قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ». وكان الثوري - رحمه الله - يقول ينبغي أن يقولها الإمام خمسا ليتمكن المقتدي من أن يقولها ثلاثا، والشافعي - رحمه الله تعالى - يقول بهذا ويزيد في الركوع ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه: «اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وفي السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين»، وهذا محمول وهذا عندنا على التهجد بالليل ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه لحديث وائل بن حجر - رضي الله تعالى عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه»، ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التكبير فكذلك في آخرها والذي روي عن أبي حميد الساعدي - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان إذا سجد وضع يديه حذو منكبيه»، محمول على حالة العذر للكبر أو المرض ويوجه أصابعه نحو القبلة لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة». وفي حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد العبد سجد كل عضو معه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع ويعتمد على راحتيه» لحديث وائل بن حجر، فإنه قال لأصحابه ألا أصف لكم سجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا نعم فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته، ثم قال هكذا كان يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (ويبدي ضبعيه) للحديث المشهور أنه - صلى الله عليه وسلم: «كان إذا سجد أبدى ضبعيه أو أبد ضبعيه» والإبداء والتبديد كل واحد منهما لغة وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه»، وفي رواية: «حتى يرثى له أن يرحم من جهده»، وفي حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت. (ولا يفترش ذراعيه) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش الكلب أو الثعلب»، فذكره هذا المثل دليل على شدة الكراهة وكان مالك يقول في النفل لا بأس بأن يفترش ذراعيه ليكون أيسر عليه ولكن النهي عام يتناول النفل والفرض جميعا وهذا في حق الرجال. فأما المرأة فتحتفز وتنضم وتلصق بطنها بفخذيها وعضديها بجنبيها هكذا عن علي - رضي الله تعالى عنه - في بيان السنة في سجود النساء ولأن مبنى حالها على الستر فما يكون أستر لها فهو أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة مستورة». (وينهض على صدور قدميه حتى يستتم قائما في الركعة الثانية عندنا) وقال الشافعي - رضي الله عنه - الأولى أن يجلس جلسة خفيفة، ثم ينهض، لحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من السجود في السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة، ثم ينهض»، ولأن كل ركعة تشتمل على جميع أركان الصلاة ومن أركانها القعدة فينبغي أن يكون ختم كل ركعة بقعدة قصيرة أو طويلة. ولنا حديث وائل بن حجر - رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من السجود إلى الركعة الثانية نهض على صدور قدميه»، ولأنه لو كان هاهنا قعدة لكان الانتقال إليها ومنها بالتكبير ولكان لها ذكر مسنون كما في الثانية والرابعة وتأويل حديثهم أنه فعل لأجل العذر بسبب الكبر كما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إني امرؤ قد بدنت، فلا تبادروني بركوع ولا سجود»، ومنهم من يروي بدنت، وهو تصحيف، فإن البدانة هي الضخامة ولم ينقل في صفات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي قوله نهض على صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد بيديه على الأرض عند قيامه كما لا يعتمد على جالس بين يديه والمعنى أنه اعتماد من غير حاجة فكان مكروها والذي روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في صلاته شبه العاجز»، تأويله أنه كان عند العذر بسبب الكبر. (ويحذف التكبير حذفا ولا يطوله) لحديث إبراهيم النخعي موقوفا ومرفوعا: «الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم»، ولأن المد في أوله لحن من حيث الدين؛ لأنه ينقلب استفهاما، وفي آخره لحن من حيث اللغة، فإن أفعل لا يحتمل المبالغة. (ويوجه أصابع رجليه في سجوده نحو القبلة) لما روي: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا سجد فتح أصابعه»، أي أمالها إلى القبلة ولقوله - عليه الصلاة والسلام: «فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع». قال: (ويعتمد بيمينه على يساره في قيامه في الصلاة) وأصل الاعتماد سنة إلا على قول الأوزاعي، فإنه كان يقول يتخير المصلي بين الاعتماد والإرسال وكان يقول إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم؛ لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رءوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم. والمذهب عند عامة العلماء أنه سنة واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال - عليه الصلاة والسلام: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ شمائلنا بأيماننا في الصلاة»، وقال علي - رضي الله تعالى عنه - إن من السنة أن يضع المصلي يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ، وفي حديث علي - رضي الله تعالى عنه - لفظ الوضع واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين، فأما موضع الوضع فالأفضل عندنا تحت السرة وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - الأفضل أن يضع يديه على الصدر لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] قيل المراد منه وضع اليمين على الشمال على النحر، وهو الصدر ولأنه موضع نور الإيمان فحفظه بيده في الصلاة أولى من الإشارة إلى العورة بالوضع تحت السرة، وهو أقرب إلى الخشوع والخشوع زينة الصلاة. ولنا حديث علي - رضي الله تعالى عنه - كما روينا والسنة إذا أطلقت تنصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم الوضع تحت السرة أبعد عن التشبه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة فكان أولى. والمراد من قوله وانحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد ولئن كان المراد بالنحر الصدر فمعناه لتضع بالقرب من النحر وذلك تحت السرة، ثم قال في ظاهر المذهب الاعتماد سنة القيام، وروي عن محمد - رحمه الله - أنه سنة القراءة، وإنما يتبين هذا في المصلي، بعد التكبير عند محمد - رحمه الله - يرسل يديه في حالة الثناء فإذا أخذ في القراءة اعتمد، وفي ظاهر الرواية كما فرغ من التكبيرة يعتمد. قال: (وإذا قعد في الثانية أو الرابعة افترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة) وقال مالك في القعدتين جميعا المسنون أن يقعد متوركا وذلك بأن يخرج رجليه من جانب ويفضي بأليتيه إلى الأرض لحديث أبي حميد الساعدي - رضي الله تعالى عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في صلاته قعد متوركا»، والشافعي يقول في القعدة الأولى مثل قولنا؛ لأنها لا تطول، وهو يحتاج إلى القيام والقعود بهذه الصفة أقرب إلى الاستعداد للقيام، وفي القعدة الثانية يقول قول مالك - رحمه الله -؛ لأنها تطول ولا يحتاج إلى القيام بعدها فينبغي أن يكون مستقرا على الأرض. ولنا حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها وصفت قعود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فذكرت أنه: «كان إذا قعد افترش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا» وما روي بخلافه فهو محمول على حالة العذر للكبر ولأن القعود على الوجه الذي بينا أشق على البدن: «وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الأعمال فقال أحمزها»، أي أشقها على البدن ويقول الشافعي - رضي الله عنه - ما كان متكررا من أفعال الصلاة فالثاني لا يخالف الأول في الصفة كسائر الأفعال، فأما المرأة فينبغي لها أن تقعد متوركة لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأتين تصليان فلما فرغتا دعاهما وقال: اسمعان، إذا قعدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض»، ولأن هذا أقرب إلى الستر في حقهن. قال (ويكون منتهى بصره في صلاته حال القيام موضع سجوده) لحديث أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى سما ببصره نحو السماء فلما نزل قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] رمى ببصره إلى موضع سجوده»، ولما نزل قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] قال أبو طلحة - رضي الله عنه - ما الخشوع يا رسول الله قال: «أن يكون منتهى بصر المصلي حال القيام موضع سجوده»، ثم فسر الطحاوي في كتابه فقال في حالة القيام ينبغي أن يكون منتهى بصره موضع سجوده، وفي الركوع على ظهر قدميه، وفي السجود على أرنبة أنفه، وفي القعود على حجره زاد بعضهم وعند التسليمة الأولى على منكبه الأيمن وعند التسليمة الثانية على منكبه الأيسر، فالحاصل أن يترك التكلف في النظر فيكون منتهى بصره ما بينا. قال: (ولا يلتفت في الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لو علم المصلي من يناجي ما التفت»، ولما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة قال: «تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم»، وحد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه ووجهه على وجه يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة الكعبة، فأما إذا نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه، فلا يكون مكروها لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤخر عينيه». (ولا يعبث في الصلاة بشيء من جسده وثيابه) لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: «إن الله - تعالى - كره لكم ثلاثا الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر»، ولما «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي، وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»، فجعل فعله دليل نفاقه قال الطحاوي تأويله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف بطريق الوحي أن الرجل منافق مستهزئ، فأما أن يكون هذا الفعل من علامات النفاق فلا؛ لأن المصلي قلما ينجو منه. ألا ترى أنه «قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ذلك؟ قال ليكن في الفريضة»، إذا فالحاصل أن كل عمل هو مفيد للمصلي، فلا بأس أن يأتي به أصله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه عرق ليلة في صلاته فسلت العرق عن جبينه»؛ لأنه يؤذيه فكان مفيدا: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الصيف إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة»؛ لأنه كان مفيدا حتى لا يبقي صورة، فأما ما ليس بمفيد فيكره للمصلي أن يشتغل به، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة لشغلا»، والعبث غير مفيد له شيئا، فلا يشتغل به. (ولا يقلب الحصى)؛ لأنه نوع عبث غير مفيد والنهي عن تقليب الحصى يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جابر وأبو ذر ومعيقيب بن أبي فاطمة وأبو هريرة حتى قال في بعضها: «وإن تتركها فهو خير لك من مائة ناقة سود الحدقة تكون لك»، فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود، فلا بأس بأن يسويه مرة واحدة وتركه أحب إلي: «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر يا أبا ذر مرة أو ذر» ولأن هذا عمل مفيد له ليتمكن من وضع الجبهة والأنف على الأرض، فلا بأس به بعد أن يكون قليلا لا يزيد على مرة وتركه أقرب إلى الخشوع فهو أولى. قال: (ولا يفرقع أصابعه) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الفرقعة في الصلاة»، «ومر بمولى له، وهو يصلي ويفرقع أصابعه فقال أتفرقع أصابعك وأنت تصلي؟، لا أم لك»، وكان - عليه الصلاة والسلام: «ينهى المنتظر للصلاة أن يفرقع أصابعه في تلك الحالة»، ففي الصلاة أولى، وهو نوع عبث غير مفيد. قال: (ولا يضع يديه على خاصرته) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن التخصر في الصلاة»، وقيل: إنه استراحة أهل النار ولا راحة لهم، وإن الشيطان أهبط متخصرا ولأنه فعل المصاب وحال الصلاة حال يناجي فيه العبد ربه - تعالى - فهو حال الافتخار لا حال إظهار المصيبة ولأنه فعل أهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم. قال: (ولا يقعي إقعاء) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يقعي المصلي إقعاء الكلب»، وفي تفسير الإقعاء وجهان: أحدهما: أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود ويضع أليتيه على عقبيه، وهو معنى: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عقب الشيطان». الثاني: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا وهذا أصح؛ لأن إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره. قال: (ولا يتربع من غير عذر) ، لما روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - رأى ابنه يتربع في الصلاة فنهاه عن ذلك فقال رأيتك تفعله يا أبت فقال إن رجلي لا تحملاني، ومن مشايخنا من غلل فيه فقال التربع جلوس الجبابرة فلهذا كره في الصلاة وهذا ليس بقوي، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله»، حتى روي أنه: «كان يأكل يوما متربعا فنزل عليه الوحي كل كما تأكل العبيد»، وهو كان منزها عن أخلاق الجبابرة وكذلك عامة جلوس عمر - رضي الله عنه - في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان متربعا ولكن العبارة الصحيحة أن يقال الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع فهو أولى في حال الصلاة إلا عند العذر. قال: (لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به) ؛ لأنه عمل مفيد، فإن التصاق التراب بجبهته نوع مثلة فربما كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه، فلا بأس به ولو مسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به، فأما قبل ذلك، فلا بأس به في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف قال أحب إلي أن يدعه؛ لأنه يتترب ثانيا وثالثا، فلا يكون مفيدا ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيرا، ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من الصلاة وجعلوا القول قول محمد - رحمه الله - في الكتاب لا مفصولا عن قوله أكرهه، فإنه قال في الكتاب قلت لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال لا أكرهه يعني لا تفعل، فإني أكرهه لحديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه: «أربع من الجفاء أن تبول قائما وأن تسمع النداء فلم تجبه وأن تنفخ في صلاتك وأن تمسح جبهتك في صلاتك»، وتأويله، عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة. قال: (والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ، وهو تشهد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - والمختار عند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - تشهد ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - وصفته أن يقول التحيات المباركات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو يقول بأن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - كان من فتيان الصحابة - رضوان الله عليهم -، فإنما يختارون ما استقر عليه الأمر آخرا، فأما ابن مسعود فهو من الشيوخ ينقل ما كان في الابتداء كما نقل التطبيق وغيره ولأن تشهد ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أقرب إلى موافقة القرآن قال الله - تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة [النور: 61] والسلام بغير الألف واللام أكثر في القرآن قال الله - تعالى: {سلام عليكم طبتم} [الزمر: 73] : {سلام عليكم بما صبرتم} [الرعد: 24] ومالك - رحمه الله - يأخذ بتشهد عمر - رضي الله تعالى عنه - وصورته التحيات الناميات الزاكيات المباركات الطيبات لله وقال: إن عمر - رضي الله تعالى عنه - علم الناس التشهد بهذه الصفة على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الناس من اختار تشهد أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - وهو أن يقول التحيات لله الطيبات والصلوات لله والباقي كتشهد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وفيه حكاية، فإن أعرابيا دخل على أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في المسجد فقال أبواو أم بواوين؟ فقال: بواوين. فقال: بارك الله فيك كما بارك في لا ولا، ثم ولى فتحير أصحابه وسألوه عن ذلك فقال إن هذا سألني عن التشهد أبواوين كتشهد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أم بواو كتشهد أبي موسى؟ قلت: بواوين. قال: بارك الله فيك كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وإنما أخذنا بتشهد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - لحسن ضبطه ونقله من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أبا حنيفة قال أخذ حماد بيدي وقال حماد أخذ إبراهيم بيدي وقال إبراهيم أخذ علقمة بيدي وقال علقمة أخذ عبد الله بن مسعود بيدي وقال ابن مسعود: «أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني السورة من القرآن وكان يأخذ علينا بالواو والألف»، وقال علي بن المديني لم يصح من التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود وأهل البصرة عن أبي موسى، وعن خصيف قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقلت كثر الاختلاف في التشهد فبماذا تأمرني أن آخذ قال بتشهد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - ولأن تشهد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أبلغ في الثناء، فإن الواوات تجعل كل لفظ ثناء بنفسه. (والسلام بالألف واللام ليكون أبلغ منه بغير الألف واللام) وترجيح الشافعي - رحمه الله تعالى - بعيد، فإنه يؤدي إلى تقديم الأحداث على المهاجرين الأولين وأحد لا يقول به وترجيح مالك ليس بقوي أيضا، فإن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - علم الناس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كما هو تشهد ابن مسعود فدل أن الأخذ به أولى. (ويكره أن يزيد في التشهد شيئا أو يبتدئ قبله بشيء) ومراده ما نقل شاذا في أول التشهد باسم الله وبالله أو باسم الله خير الأسماء، وفي آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات وابن مسعود يقول وكان يأخذ علينا بالواو والألف فذلك تنصيص على أنه لا تجوز الزيادة عليه بخلاف التطوعات، فإنها غير محصورة بالنص فجوزنا الزيادة عليه ولا يزيد في الفرائض على التشهد في القعدة الأولى عندنا وقال الشافعي يزيد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستدل بحديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل ركعتين تشهد وسلام على المرسلين، ومن تبعهم من عباد الله الصالحين». ولنا حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى»، وروي أنه كان يقعد في القعدة الأولى كأنه على الرضف يعني الحجارة المحماة يحكي الراوي بهذا سرعة قيامه فدل أنه كان لا يزيد على التشهد، وتأويل حديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - في التطوعات، فإن كل شفع من التطوع صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد، فأما في الرابعة فيدعو بعده ويسأل حاجته ولم يذكر الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأورد الطحاوي في مختصره أن بعد التشهد يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو حاجته ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، وهو الصحيح، فإن التشهد ثناء على الله - تعالى -. ويعقبه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في التحميد المعهود، وهو مروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وكان إبراهيم النخعي يقول يجزئ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله السلام عليك أيها النبي، ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ليست من جملة الأركان عندنا وقال الشافعي هي من جملة أركان الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بها. وفي الصلاة على آله وجهان، واستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته»، ولأن الله - تعالى - أمرنا بالصلاة عليه ومطلق الأمر للإيجاب ولا تجب في غير الصلاة فدل أنها تجب في الصلاة. ولنا حديث كعب بن عجرة - رضي الله تعالى عنه - قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد»، فهو لم يعلمهم حتى سألوه ولو كان من أركان الصلاة لبينه لهم قبل السؤال وحين علم الأعرابي أركان الصلاة لم يذكر الصلاة عليه ولأنه صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون من أركان الصلاة كالصلاة على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. وتأويل الحديث نقول أراد به نفي الكمال كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، وبه نقول والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر مرة، فإن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار وبه نقول وكان الطحاوي يقول كلما سمع ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - من غيره أو ذكره بنفسه يجب عليه أن يصلي، وهو قول مخالف للإجماع فعامة العلماء على أن ذلك مستحب وليس بواجب. (ثم يدعو بحاجته) لقوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب} [الشرح: 7] {وإلى ربك فارغب} [الشرح: 8] قيل معناه إذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء وارغب إلى الله - تعالى - بالإجابة: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر صلاته يتعوذ بالله من المغرم والمأثم ومن فتنة المحيا والممات»، ولما علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود - رضي الله عنه - التشهد قال له: «وإذا قلت هذا فاختر من الدعاء أعجبه»، وكان ابن مسعود يدعو بكلمات منهن: "اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم" . قال: (ثم يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله والأخرى عن يساره مثل ذلك) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وتحليلها السلام»، وقد جاء أوان التحليل. ومن تحرم للصلاة فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا يكلمونه وعند التحليل يصير كأنه رجع إليهم فيسلم. والتسليمتان قول جمهور العلماء وكبار الصحابة عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وهكذا روت عائشة وسهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأخذ برواية كبار الصحابة أولى، فإنهم كانوا يلون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال: «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى»، فأما عائشة - رضي الله تعالى عنها - فكانت تقف في صف النساء وسهل بن سعد كان من جملة الصبيان فيحتمل أنهما لم يسمعا التسليمة الثانية على ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين الثانية أخفض من الأولى». (ثم في التسليمة الأولى يحول وجهه على يمينه، وفي الثانية على يساره) لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحول وجهه في التسليمة الأولى حتى يرى بياض خده الأيمن أو قال الأيسر»، يحكي الراوي بهذا شدة التفاته. قال: (وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة والرجال وبالتسليمة الثانية من عن يساره منهم) ؛ لأنه يستقبلهم بوجهه ويخاطبهم بلسانه فينويهم بقلبه، فإن الكلام إنما يصير عزيمة بالنية قال - عليه الصلاة والسلام: «إن الله - تعالى - وراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤ ما يقول»، وقد ذكر الحفظة هنا وأخر في الجامع الصغير حتى ظن بعض أصحابنا أن ما ذكر هنا بناء على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة على البشر وما ذكر في الجامع الصغير بناء على قوله الآخر في تفضيل البشر على الملائكة وليس 
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 31 الى صـــ 40 (4) كما ظنوا، فإن الواو لا توجب الترتيب، ومن سلم على جماعة لا يمكنه أن يرتب بالنية فيقدم الرجال على الصبيان ولكن مراده تعميم الفريقين بالنية وأكثر مشايخنا على أنه يخص بهذه النية من يشاركه في الصلاة من الرجال والنساء، فأما الحاكم الشهيد - رحمه الله - فكان يقول ينوي جميع الرجال والنساء من يشاركه، ومن لا يشاركه وهذا عندنا في سلام التشهد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح من أهل السماء والأرض»، فأما في سلام التحليل فيخاطب من بحضرته فيخصه بالنية والمقتدي ينوي كذلك فكان ابن سيرين يقول المقتدي يسلم ثلاث تسليمات إحداهن لرد سلام الإمام وهذا ضعيف، فإن مقصود الرد حاصل بالتسليمتين إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول عليكم السلام وبين قوله السلام عليكم، فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم، وإن كان في الجانب الأيسر نواه فيهم، وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أبي يوسف؛ لأنه لما استوى الجانبان في حقه ترجح الجانب الأيمن وقال محمد ينويه في التسليمتين؛ لأن له حظا من الجانبين. [مكروهات الصلاة] قال: (ويكره في الصلاة تغطية الفم) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يغطي المصلي فاه»، ولأنه إن غطاه بيده فقد قال كفوا أيديكم في الصلاة، وإن غطاه بثوب فقد نهى عن التلثم في الصلاة، وفيه تشبه بالمجوس في عبادتهم النار. قال: (ويكره أن يصلي، وهو معتجر) : «لنهي الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن الاعتجار في الصلاة»، وتفسيره أن يشد العمامة حول رأسه ويبدي هامته مكشوفا كما يفعله الشطار وقيل أن يشد بعض العمامة على رأسه وبعضها على بدنه وعن محمد قال لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب، وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعجر للنساء، وهو أن يلفه حول وجهه. قال: (ويكره أن يصلي، وهو عاقص) لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص»، وإن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - كان يصلي، وهو عاقص شعره فقام أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى جنبه فحله فنظر إليه شبه المغضب فقال أقبل على صلاتك يا ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عن هذا. والعقص في اللغة الإحكام في الشد حتى قيل في تفسيره أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بخرقة أو بصمغ ليتلبد وقيل أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض أحوالهن. قال: (ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه إذا انحط للسجود) وقال ابن سيرين يضع يديه قبل ركبتيه لحديث أبي حميد أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يضع يديه قبل ركبتيه»،. ولنا حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يضع يديه قبل ركبتيه». وروى الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يبرك المصلي بروك الإبل وقال ليضع ركبتيه قبل يديه»، يعني أن الإبل في بروكها تبدأ باليد فينبغي أن يبدأ المصلي بالرجل ولأنه يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه، وفي الرفع يرفع أولا ما كان أبعد عن الأرض فيرفع وجهه، ثم يديه، ثم ركبتيه. قال: (ويخفي الإمام التعوذ والتسمية والتشهد وآمين وربنا لك الحمد) أما التعوذ والتسمية فقد بينا والتشهد كذلك، فإنه لم ينقل الجهر بالتشهد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس توارثوا الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، والتوارث كالتواتر. وأما قوله: "اللهم ربنا لك الحمد" فقد طعنوا فيه وقالوا من مذهب أبي حنيفة أن الإمام لا يقولها أصلا فكيف يستقيم جوابه أنه يخفي بها ولكنا نقول عرف أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - أن بعض الأئمة لا يأخذون بقوله لحرمة قول علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - ففرع على قولهما أنه يخفي بها إذا كان يقولها كما فرع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها، فأما "آمين" فالإمام يقولها بعد الفراغ من الفاتحة إلا على قول مالك - رحمه الله -، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين»، والقسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها. ولنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي الحديث الذي رووا زيادة، فإنه قال: «فقولوا آمين»، فإن الإمام يقولها وهذا اللفظ دليل على أن الإمام لا يجهر بها، وهو قول علمائنا ومذهب علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما -. وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يجهر بها، وهو قول ابن الزبير وأبي هريرة، واستدل بحديث وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان إذا فرغ من الفاتحة في الصلاة قال آمين ومد بها صوته»، ولكنا نستدل بحديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «قال في صلاته آمين وخفض بها صوته»، وتأويل حديثهم أنه قال اتفاقا لا قصدا أو كان لتعليم الناس أن الإمام يؤمن كما يؤمن القوم، فإنه دعاء، فإن معناه على ما قال الحسن اللهم أجب، وفي قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما [يونس: 89] ما يدل عليه، فإن موسى - عليه السلام - كان يدعو وهارون كان يؤمن. والإخفاء في الدعاء أولى قال الله - تعالى: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] وقال - عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء الخفي وخير الرزق ما يكفي»، وفي التأمين لغتان أمين بالقصر وآمين بالمد والمد يدل على ياء النداء معناه يا آمين كما يقال في الكلام أزيد يعني يا زيد. وما كان من النفخ غير مسموع فهو تنفس لا بد للحي منه، فلا يفسد الصلاة، وإن كان مسموعا أفسدها في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولم يفسدها في قول أبي يوسف إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع وقال صلاته تامة، وإن أراد به التأفيف، واستدل بما روي: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صلاة الكسوف أف أف ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم»، ولأن هذا تنفس وليس بكلام فالكلام ما يجري في مخاطبات الناس وله معنى مفهوم ولهذا قال في قوله الأول إذا أراد به التأفيف، وهو في اللغة أفف يؤفف تأفيفا كان قطعا، ثم رجع فقال عينه ليس بكلام فلو بطلت صلاته إنما تبطل بمجرد النية وذلك لا يجوز وقاسه بالتنحنح والعطاس، فإنه لا يكون قطعا، وإن سمع فيه حروف مهجاة، وهو أصوب. (ولنا) حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - مر بمولى له يقال له رباح، وهو ينفخ التراب من موضع سجوده فقال: أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم»، ولأن قوله "أف" من جنس كلام الناس؛ لأنه حروف مهجاة وله معنى مفهوم يذكر لمقصود قال الله - تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] فجعله من القول والقائل يقول أفا وتفا لمن مودته ... إن غبت عنه سويعة زالت وإن مالت الريح هكذا وكذا ... مال مع الريح أينما مالت. والكلام مفسد للصلاة بخلاف التنحنح، فإنه لإصلاح الحلق ليتمكن به من القراءة. والعطاس مما لا يمكنه الامتناع منه فكان عفوا بخلاف التأفيف، فإنه بمنزلة ما لو قال في الصلاة هر ونحوه وتأويل حديث الكسوف أنه كان في وقت كان الكلام في الصلاة مباحا، ثم انتسخ. ولا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به لما روي في حديث أم هانئ - رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد متوشحا به»، وسأل ثوبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد: «فقال يا ثوبان أولكلكم ثوبان أو قال أوكلكم يجد ثوبين». (وصفة) التوشح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة إذا لف الكرباس على نفسه، جاء في الحديث: «إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به، وإن كان ضيقا فاتزر به»، وإنما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة، وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة، فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد. (وذكر) ابن شجاع - رحمه الله تعالى - أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته، وإن كان ملتحفا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته والحاصل أنه تكره الصلاة في إزار واحد لحديث: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء»، وسأل رجل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد؟ فقال: لا. فقال: الله أحق أن تتزين له. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء، وفي ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام. (ويكره للمصلي أن يرفع ثيابه أو يكفها أو يرفع شعره) لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا»: وقال «إذا طول أحدكم شعره فليدعه يسجد معه»، قال ابن مسعود - رضي الله عنه - له أجر بكل شعرة، ثم كفه الثوب والشعر لكي لا يتترب نوع تجبر ويكره للمصلي ما هو من أخلاق الجبابرة. ويسجد على جبهته وأنفه واظب على هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه تمام السجود، فإن سجد على الجبهة دون الأنف جاز عندنا وعند الشافعي لا يجوز، وإن سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويكره ولم يجز عند أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - وهو رواية أسيد بن عمرو عن أبي حنيفة - رحمه الله -. أما الشافعي استدل بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يمس أنفه الأرض في سجوده كما يمس جبهته، فلا سجود له»، والمراد بهذا عندنا نفي الكمال لا نفي الجواز. واستدل أبو يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «السجود على الجبهة فريضة وعلى الأنف تطوع» فإذا ترك ما هو الفرض لا يجزئه، ثم الأنف تبع للجبهة في السجود كما أن الأذن تبع للرأس في المسح، ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لا يجزئه فهذا مثله وأبو حنيفة احتج بقول ابن عمر - رضي الله عنه: فإن زيد بن ركانة كان يصلي وعليه برنس فكان إذا سجد سقط على جبهته فناداه ابن عمر رضي الله عنهما - إذا أمسست أنفك الأرض أجزأك، ولأن المأمور به السجود على الوجه كما فسر الأعضاء السبعة في الحديث المعروف الوجه واليدان والركبتان والقدمان. ووسط الوجه الأنف فبالسجود عليه يكون ممتثلا للأمر، وهو أحد أطراف الجبهة، فإن عظم الجبهة مثلث والسجود على أحد أطرافه كالسجود على الطرف الآخر، ولأن الأنف مسجد حتى إذا كان بجبهته عذر يلزمه السجود على الأنف وما ليس بمسجد لا يصير مسجدا بالعذر في المسجد كالخد والذقن، وإذا ثبت أنه مسجد فبالسجود عليه يحصل امتثال الأمر وقال الله - تعالى: {يخرون للأذقان سجدا} [الإسراء: 107] والمراد ما يقرب من الذقن، والأنف أقرب إلى الذقن من الجبهة، فهو أولى بأن يكون مسجدا، والله أعلم. [باب افتتاح الصلاة] قال: (وإذا انتهى الرجل إلى الإمام، وقد سبقه بركعتين، وهو قاعد - يكبر تكبيرة الافتتاح ليدخل بها في صلاته، ثم كبر أخرى ويقعد بها) ؛ لأنه التزم متابعة الإمام، وهو قاعد والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبيرة، والحاصل أنه يبدأ بما أدرك مع الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم بالسكينة والوقار ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، وكان الحكم في الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته حتى أن معاذا - رضي الله عنه - جاء يوما، وقد سبقه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض الصلاة فتابعه فيما بقي، ثم قضى ما فاته فقال - عليه الصلاة والسلام: «ما حملك على ما صنعت يا معاذ؟ فقال: وجدتك على حال فكرهت أن أخالفك عليه فقال - عليه الصلاة والسلام - سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا بها»، ثم لا خلاف أن المسبوق يتابع الإمام في التشهد ولا يقوم للقضاء حتى يسلم الإمام وتكلموا أن بعد الفراغ من التشهد ماذا يصنع؟ فكان ابن شجاع - رحمه الله - يقول يكرر التشهد وأبو بكر الرازي يقول يسكت؛ لأن الدعاء مؤخر إلى آخر الصلاة والأصح أنه يأتي بالدعاء متابعة للإمام؛ لأن المصلي إنما لا يشتغل بالدعاء في خلال الصلاة لما فيه من تأخير الأركان وهذا المعنى لا يوجد هنا؛ لأنه لا يمكنه أن يقوم قبل سلام الإمام. ويجوز افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل والتحميد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - إذا كان يحسن التكبير ويعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير لا يصير شارعا بغيره، وإن كان لا يحسنه أجزأه، وألفاظ التكبير عنده أربعة: الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله كبير. وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يصير شارعا إلا بلفظتي الله أكبر، الله الأكبر. وعند مالك - رحمه الله - لا يصير شارعا إلا بقوله الله أكبر، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر»، وبهذا احتج الشافعي ولكنه يقول الله الأكبر أبلغ في الثناء بإدخال الألف واللام فيه فهو أولى وأبو يوسف استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم: «وتحريمها التكبير»، فلا بد من لفظة التكبير، وفي العبادات البدنية يعتبر المنصوص عليه ولا يشتغل بالتعليل حتى لا يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف والأذان لا ينادى بغير لفظ التكبير فالتحريم للصلاة أولى وأبو حنيفة - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - استدلا بحديث مجاهد - رضي الله عنه - قال: «كان الأنبياء - صلوات الله عليهم - يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله»، ولأن الركن ذكر الله - تعالى - على سبيل التعظيم، وهو الثابت بالنص قال الله - تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] ، وإذا قال الله أعظم أو الله أجل فقد وجد ما هو الركن، فأما لفظ التكبير وردت به الأخبار فيوجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه ولكن الركن ما هو الثابت بالنص، ثم من قال الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال الله تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} [الإسراء: 110] الآية. والتكبير بمعنى التعظيم قال الله تعالى: {فلما رأينه أكبرنه} [يوسف: 31] أي عظمنه: {وربك فكبر} [المدثر: 3] أي فعظم والتعظيم حصل بقوله الله أعظم. (فأما) الأذان فالمقصود منه الإعلام وبتغيير اللفظ يفوت ما هو المقصود، فإن الناس لا يعلمون أنه أذان، فإن قال الله لا يصير شارعا بهذا اللفظ عند محمد - رحمه الله -؛ لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يصير شارعا؛ لأن في هذا الاسم معنى التعظيم، فإنه مشتق من التأله، وهو التحير، وإن قال اللهم اغفر لي لا يصير شارعا؛ لأن هذا سؤال والسؤال غير الذكر «قال - عليه الصلاة والسلام - فيما يؤثر عن ربه - عز وجل - من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»، فإن قال اللهم فالبصريون من أهل النحو قالوا الميم بدل عن ياء النداء فهو كقولك يا الله فيصير شارعا عند أبي حنيفة والكوفيون قالوا الميم بمعنى السؤال أي يا الله آمنا بخير، فلا يصير شارعا به. ولو كبر بالفارسية جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - بناء على أصله أن المقصود هو الذكر وذلك حاصل بكل لسان ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أن لا يحسن العربية فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه ومحمد فرق فقال للعربية من الفضيلة ما ليس لغيرها من الألسنة فإذا عبر إلى لفظ آخر من العربية جاز، وإذا عبر إلى الفارسية لا يجوز. وأصل هذه المسألة إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويكره، وعندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية، وإذا كان لا يحسنها يجوز وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا تجوز القراءة بالفارسية بحال ولكنه إن كان لا يحسن العربية، وهو أمي يصلي بغير قراءة. وكذلك الخلاف فيما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الإمام يوم الجمعة بالفارسية فالشافعي - رحمه الله - يقول إن الفارسية غير القرآن قال الله - تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3] وقال الله - تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا} [فصلت: 44] الآية فالواجب قراءة القرآن، فلا يتأدى بغيره بالفارسية، والفارسية من كلام الناس فتفسد الصلاة وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا القرآن معجز والإعجاز في النظم والمعنى فإذا قدر عليهما، فلا يتأدى الواجب إلا بهما، وإذا عجز عن النظم أتى بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء وأبو حنيفة - رحمه الله - استدل بما روي أن الفرس كتبوا إلى سلمان - رضي الله عنه - أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرءون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية، ثم الواجب عليه قراءة المعجز والإعجاز في المعنى، فإن القرآن حجة على الناس كافة وعجز الفرس عن الإتيان بمثله إنما يظهر بلسانهم والقرآن كلام الله - تعالى - غير مخلوق ولا محدث واللغات كلها محدثة فعرفنا أنه لا يجوز أن يقال إنه قرآن بلسان مخصوص، كيف وقد قال الله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] وقد كان بلسانهم. ولو آمن بالفارسية كان مؤمنا وكذلك لو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبى بالفارسية فكذلك إذا كبر وقرأ بالفارسية. (وروى الحسن) عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه إذا أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز، وإن كانوا لا يعلمون ذلك لم يجز لأن المقصود الإعلام ولم يحصل به، ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - إنما يجوز إذا قرأ بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معنى العربية. فأما إذا صلى بتفسير القرآن لا يجوز؛ لأنه غير مقطوع به. إذا افتتح الصلاة قبل الإمام، ثم كبر الإمام فصلى الرجل بصلاته لا يجزئه لقوله - عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»، والائتمام لا يتحقق إذا لم يكبر الإمام. وقد اختلف عليه حين كبر قبله، فلا يجزئه إلا أن يجدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول في صلاته وحينئذ يصير قاطعا لما كان فيه شارعا في صلاة الإمام والتكبيرة الواحدة تعمل هذين العملين كمن كان في النافلة فكبر ينوي الفريضة. ومن غير هذا الباب إذا باع بألف ثم جدد بيعا بألفين كان فسخا للأول وانعقاد عقد آخر وأشار في الكتاب إلى أنه قبل تكبير الإمام يصير شارعا في الصلاة؛ لأنه قال تكبيرة الثاني قطع لما كان فيه فقيل تأويله إن لم يكن نوى الاقتداء وقيل إن نوى الاقتداء صار شارعا في صلاة نفسه. وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - وعند محمد - رحمه الله - لا يصير شارعا في الصلاة بناء على أصل، وهو أن الجهة إذا فسدت يبقى أصل الصلاة عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند محمد لا يبقى وعن أبي حنيفة - رحمه الله - فيه روايتان يأتي بيانه في موضعه، ثم الأفضل عند أبي حنيفة أن يكبر المقتدي مع الإمام؛ لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة وعندهما الأفضل أن يكبر بعد تكبيرة الإمام؛ لأنه تبع للإمام وظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام: «إذا كبر الإمام فكبروا»، يشهد لهذا وكذلك سائر الأفعال. وفي التسليم روايتان عن أبي حنيفة - رحمه الله: إحداهما: أنه يسلم بعد الإمام ليكون تحلله بعد تحلل الإمام. والأخرى: أنه يسلم مع الإمام كسائر الأفعال، وإذا سلم الإمام ففي الفجر والعصر يقعد في مكانه ليشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوع بعدهما ولكنه ينبغي أن يستقبل القوم بوجهه ولا يجلس كما هو مستقبل القبلة، وإن كان خير المجالس ما استقبلت به القبلة للأثر المروي: «جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة» «وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر استقبل أصحابه بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا فيه بشرى بفتح مكة»، ولأنه يفتتن الداخل بجلوسه مستقبل القبلة؛ لأنه يظنه في الصلاة فيقتدي به، وإنما يستقبلهم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق يصلي، فإن كان فلينحرف يمنة أو يسرة؛ لأن استقبال المصلي بوجهه مكروه، لحديث عمر - رضي الله تعالى عنه - فإنه رأى رجلا يصلي إلى وجه رجل فعلاهما بالدرة وقال للمصلي أتستقبل الصورة؟ وقال للآخر أتستقبل المصلي بوجهك؟ فأما في صلاة الظهر والعشاء والمغرب يكره له المكث قاعدا؛ لأنه مندوب إلى التنفل بعد هذه الصلوات، والسنن لجبر نقصان ما يمكن في الفرائض فيشتغل بها وكراهية القعود في مكانه مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - ولا يشتغل بالتطوع في مكان الفريضة للحديث المروي: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر بسبحته أي بنافلته»، ولأنه يفتن به الداخل أي يظنه في الفريضة فيقتدي به ولكنه يتحول إلى مكان آخر للتطوع استكثارا من شهوده، فإن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة والأولى أن يتقدم المقتدي ويتأخر الإمام ليكون حالهما في التطوع خلاف حالهما في الفريضة، فإن كان الإمام مع القوم في المسجد، فإني أحب لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام والقوم جميعا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن أخروا التكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة جاز وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وقال زفر إذا قال المؤذن مرة قد قامت الصلاة قاموا في الصف، وإذا قال ثانيا كبروا وقال: لأن الإقامة تباين الأذان بهاتين الكلمتين فتقام الصلاة عندها وأبو يوسف، احتج بحديث عمر - رضي الله تعالى عنه - فإنه بعد فراغ المؤذن من الإقامة كان يقوم في المحراب ويبعث رجالا يمنة ويسرة ليسووا الصفوف فإذا نادوا استوت كبر ولأنه لو كبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة فات المؤذن تكبيرة الافتتاح فيؤدي إلى تقليل رغائب الناس في هذه الأمانة، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله استدلا بحديث بلال حيث قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مهما سبقتني بالتكبير، فلا تسبقني بالتأمين». فدل على أنه كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن المؤذن بقوله قد قامت الصلاة يخبر بأن الصلاة قد أقيمت، وهو أمين فإذا لم يكبر كان كاذبا في هذا الإخبار فينبغي أن يحققوا خبره بفعلهم لتحقق أمانته وهذا إذا كان المؤذن غير الإمام، فإن كان هو الإمام لم يقوموا حتى يفرغ من الإقامة؛ لأنهم تبع للإمام وإمامهم الآن قائم للإقامة لا للصلاة وكذلك بعد فراغه من الإقامة ما لم يدخل المسجد لا يقومون فإذا اختلط بالصفوف قام كل صف جاوزهم حتى ينتهي إلى المحراب وكذلك إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد يكره لهم أن يقوموا في الصف حتى يدخل الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام: «لا تقوموا في الصف حتى تروني خرجت»، وإن عليا - رضي الله تعالى عنه - دخل المسجد فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال مالي أراكم سامدين أي واقفين متحيرين. ومن تثاءب في الصلاة ينبغي له أن يغطي فاه لقوله - عليه الصلاة والسلام: «إذا تثاءب أحدكم في صلاته فليغط فاه، فإن الشيطان يدخل فيه»، أو قال فمه ولأن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب ففي مناجاة الرب أولى. قال: (وأكره أن يكون الإمام على الدكان والقوم على الأرض) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نزل عن المنبر لصلاة الجمعة»، فلو لم يكره كون الإمام على الدكان لصلى على المنبر ليكون أشهر، وإن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - عنه قام على دكان يصلي لأصحابه فجذبه سلمان حتى أنزله فلما فرغ قال: أما علمت أن أصحابك يكرهون ذلك؟ قال فلهذا اتبعتك حين جذبتني، (وروي) «أن عمار بن ياسر - رضي الله تعالى عنه - قام بالمدائن على دكان يصلي بأصحابه فجذبه حذيفة - رضي الله تعالى عنه - فلما فرغ قال: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن هذا؟» قال لقد تذكرت ذلك حين جذبتني، وفي قيامه على الدكان تشبه باليهود وإظهار التكبر على القوم وذلك مكروه، فإن كان الإمام على الأرض والقوم على الدكان فذلك مكروه في رواية الأصل؛ لأن فيه استخفافا من القوم لأئمتهم، وفي رواية الطحاوي هذا لا يكره؛ لأنه مخالف لأهل الكتاب وكذلك إن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره ولم يبين في الأصل حد ارتفاع الدكان (وذكر) الطحاوي أنه ما لم يجاوز القامة لا يكره؛ لأن القليل من الارتفاع عفو ففي الأرض هبوط وصعود، والكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل أن يجاوز القامة؛ لأن القوم حينئذ يحتاجون إلى التكلف للنظر إلى الإمام وربما يشتبه عليهم حاله. قال (ويجوز إمامة الأعمى والأعرابي والعبد وولد الزنا والفاسق. وغيرهم أحب إلي) والأصل فيه أن مكان الإمامة ميراث من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أول من تقدم للإمامة فيختار له من يكون أشبه به خلقا وخلقا، ثم هو مكان استنبط منه الخلافة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما «أمر أبا بكر أن يصلي بالناس»، قالت الصحابة بعد موته إنه اختار أبا بكر لأمر دينكم فهو المختار لأمر دنياكم، فإنما يختار لهذا المكان من هو أعظم في الناس. (وتكثير الجماعة مندوب إليه) قال - عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل مع اثنين خير من صلاته وحده وصلاته مع الثلاثة خير من صلاته مع اثنين وكلما كثرت الجماعة فهو عند الله أفضل»، وفي تقديم المعظم تكثير الجماعة فكان أولى. إذا ثبت هذا فنقول تقديم الفاسق للإمامة جائز عندنا ويكره وقال مالك - رضي الله تعالى عنه - عنه: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق؛ لأنه لما ظهرت منه الخيانة في الأمور الدينية، فلا يؤتمن في أهم الأمور. ألا ترى أن الشرع أسقط شهادته لكونها أمانة؟،. (ولنا) حديث مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجهاد مع كل أمير والصلاة خلف كل إمام والصلاة على كل ميت»، وقال - صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر»، ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمنعون من الاقتداء بالحجاج في صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى قال الحسن - رحمه الله تعالى - لو جاء كل أمة بخبيثاتها ونحن جئنا بأبي محمد لغلبناهم، وإنما يكره لأن في تقديمه تقليل الجماعة وقلما يرغب الناس في الاقتداء به، وقال أبو يوسف: في 
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 41 الى صـــ 50 (5) الأمالي أكره أن يكون الإمام صاحب هوى أو بدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به. وإنما جاز إمامة الأعمى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم: «استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرة وعتبان بن مالك مرة وكانا أعميين»، والبصير أولى؛ لأنه قيل لابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - بعد ما كف بصره ألا تؤمهم؟ قال: كيف أؤمهم وهم يسوونني إلى القبلة؟ ولأن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات فالبصير أولى بالإمامة. وأما جواز إمامة الأعرابي، فإن الله - تعالى - أثنى على بعض الأعراب بقوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله} [التوبة: 99] الآية وغيره أولى؛ لأن الجهل عليهم غالب والتقوى فيهم نادرة، وقد ذم الله - تعالى - بعض الأعراب بقوله - تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا} [التوبة: 97] ، وأما العبد فجواز إمامته، لحديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال عرست وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو ذر فحضرت الصلاة فقدموني فصليت بهم وغيره أولى؛ لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء بالعبيد والجهل عليهم غالب لاشتغالهم بخدمة المولى عن تعلم الأحكام، والتقوى فيهم نادرة وكذلك ولد الزنا، فإنه لم يكن له أب يفقهه فالجهل عليه غالب والذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولد الزنا شر الثلاثة»، فقد روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - هذا الحديث وقالت كيف يصح هذا، وقد قال الله - تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] . ثم المراد شر الثلاثة نسبا أو قاله في ولد زنا بعينه نشأ مرتدا، فأما من كان منهم مؤمنا فالاقتداء به صحيح. قال: (ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأكبرهم سنا) لحديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله - تعالى - فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا وأفضلهم ورعا»، وزاد في حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها: «فإن كانوا سواء فأحسنهم وجها»، فبعض مشايخنا اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا من يكون أقرأ لكتاب الله - تعالى - يقدم في الإمامة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ به وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يعلم من القرآن مقدار ما تجوز به الصلاة فهو أولى؛ لأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة والخطأ المفسد للصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم، وإنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتعلمون القرآن بأحكامه على ما روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - حفظ سورة البقرة في ثنتي عشرة سنة، فالأقرأ منهم يكون أعلم، فأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا في القرآن ولا حظ له في العلم فالأعلم بالسنة أولى إلا أن يكون ممن يطعن عليه في دينه فحينئذ لا يقدم؛ لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به. (فإن استووا في العلم بالسنة فأفضلهم ورعا) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي»، (وقال) - صلى الله عليه وسلم: «ملاك دينكم الورع»، وفي الحديث: «يقدم أقدمهم هجرة»؛ لأنها كانت فريضة يومئذ، ثم انتسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح» ولأن أقدمهم هجرة يكون أعلمهم بالسنة لأنهم كانوا يهاجرون لتعلم الأحكام، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا لقوله - صلى الله عليه وسلم: «الكبر الكبر»، ولأن أكبرهم سنا يكون أعظمهم حرمة عادة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر، والذي قال في حديث عائشة - رضي الله عنها: «فإن كانوا سواء فأحسنهم وجها»، قيل معناه أكثرهم خبرة بالأمور كما يقال وجه هذا الأمر كذا، وإن حمل على ظاهره فالمراد منه أكثرهم صلاة بالليل جاء في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». قال ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»، ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشيرته وأقاربه وذلك لا يليق بحسن الخلق إلا أن يكون الضيف سلطانا فحق الإمامة له حيث يكون وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه، وإذا كان مع الإمام رجلان، فإنه يتقدم الإمام ويصلي بهما؛ لأن للمثنى حكم الجماعة قال - صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة». وكذلك معنى الجمع من الاجتماع وذلك حاصل بالمثنى والذي روي، أن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - صلى بعلقمة والأسود في بيت واحد فقام في وسطهما قال إبراهيم النخعي - رحمه الله - كان ذلك لضيق البيت والأصح أن هذا كان مذهب ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - ولهذا قال في الكتاب: وإن لم يتقدم الإمام وصلى بهما فصلاتهم تامة؛ لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد، وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة والتقدم للإمامة من سنة الجماعة ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - في صلاة الجمعة النصاب ثلاثة سوى الإمام. (وإن كان القوم كثيرا فقام الإمام وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميسرة الصف فقد أساء الإمام وصلاتهم تامة). أما جواز الصلاة فلأن المفسد تقدم القوم على الإمام ولم يوجد وأما الكراهة فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم: «تقدم للإمامة بأصحابه - رضوان الله عليهم - وواظب على ذلك»، والإعراض عن سنته مكروه ولأن مقام الإمام في وسط الصف يشبه جماعة النساء ويكره للرجال التشبه بهن. (وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به إلا على قول مالك - رحمه الله تعالى -، فإنه يقول الواجب عليه المتابعة في الأفعال فإذا أتى به لم يضره قيامه قدام الإمام). (ولنا) الحديث ليس مع الإمام من يقدمه، ولأنه إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فلهذا لا يجوز،. فإن كان مع الإمام واحد وقف على يمين الإمام لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال بت عند خالتي ميمونة - رضي الله تعالى عنها - لأراقب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل فانتبه فقال: «نامت العيون وغارت النجوم وبقي الحي القيوم، ثم قرأ آخر سورة آل عمران: {إن في خلق السماوات والأرض} [البقرة: 164] إلى آخر الآية، ثم قام إلى شن ماء معلق فتوضأ وافتتح الصلاة فقمت وتوضأت ووقفت على يساره فأخذ بأذني وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه فعدت إلى مكاني فأعادني ثانيا وثالثا فلما فرغ قال ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك قلت: أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك في الموقف فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»، فإعادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه إلى الجانب الأيمن دليل على أنه هو المختار إذا كان مع الإمام رجل واحد. (وفي ظاهر الرواية لا يتأخر المقتدي عن الإمام وعن محمد - رحمه الله تعالى - قال ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام) . وإن كان المقتدي أطول فكان سجوده قدام الإمام لم يضره؛ لأن العبرة بموضع الوقوف لا بموضع السجود كما لو وقف في الصف ووقع في سجوده أمام الإمام لطوله. وإن صلى خلفه امرأة جازت صلاته لحديث أنس - رضي الله عنه: «أن جدته مليكة - رضي الله تعالى عنها - دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام فقال قوموا لأصلي بكم فأقامني واليتيم من ورائه وأمي أم سليم وراءنا وصلاة الصبي تخلق فبقي أنس - رضي الله تعالى عنه - واقفا خلفه وحده وأم سليم وقفت خلف الصبي وحدها»، وفي الحديث دليل على أنه إذا كان مع الإمام اثنان يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه. (قال) وكذلك إن وقف على يسار الإمام لأن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وقف في الابتداء عن يساره واقتدى به، ثم جواز اقتدائه به، وفي الإدارة حصل خلفه فدل أن شيئا من ذلك غير مفسد قال: (وهو مسيء. من أصحابنا من قال هذه الإساءة إذا وقف عن يسار الإمام لا خلفه) ؛ لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه، فلا يتم إعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره. (والأصح أن جواب الإساءة في الفصلين جميعا؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر بقوله وكذلك) والله - سبحانه وتعالى - أعلم. [باب الوضوء والغسل] قال (يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه) ، هكذا روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأنس وميمونة - رضي الله تعالى عنهما - اغتسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكملها حديث ميمونة - رضي الله تعالى عنها - قالت «وضعت غسلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل به من الجنابة فأخذ الإناء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه». وفي ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا يمسح؛ لأنه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل ويبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة؛ لأنه إن لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة بإسالة الماء، والبداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء ليس بواجب عندنا، ومن العلماء من قال هو واجب، ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر فقال: إذا كان محدثا يلزمه الوضوء؛ لأنه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء والغسل فلا يسقط بالجنابة. (ولنا) قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] والاطهار يحصل بغسل جميع البدن ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل. (ألا ترى) أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد؟ ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء وقد روي إنكار ذلك عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - وسئل ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن ذلك فقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك والأصل فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت». (والدلك في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول مالك) يقيسه بغسل النجاسة العينية. (ولنا) أن الواجب بالنص الأطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك لمقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك. وإنما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء لأن رجليه في مستنقع الماء المستعمل حتى لو كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسل القدمين. فالحاصل أن إمرار الماء على جميع البدن فرض لقوله - صلى الله عليه وسلم - «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة». وبإفاضة الماء ثلاثا يتضاعف الثواب وبتقديم الوضوء تتم السنة وهو نظير لمراتب الوضوء على ما بينا. وأدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع وفي الوضوء مد لحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له إن لم يكفنا فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا» وهذا التقدير ليس بتقدير لازم فإنه لو أسبغ الوضوء بدون المد أجزأه لحديث عبد الرحمن بن زيد - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بثلثي مد»، وإن لم يكفه المد في الوضوء يزيد إلا أنه لا يسرف في صب الماء لحديث «سعيد - رضي الله عنه - حين مر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ ويصب الماء صبا فاحشا فقال إياك والسرف قال: أوفي الوضوء سرف؟ قال نعم ولو كنت على ضفة نهر جار». ثم التقدير بالصاع لماء الإفاضة فإذا أراد تقديم الوضوء زاد مدا له والتقدير بالمد في الوضوء إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فإن احتاج إلى ذلك استنجى برطل وتوضأ بمد، وإن كان لابسا للخف وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء يكفيه رطل. كل هذا غير لازم لاختلاف طباع الناس وأحوالهم. وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الاطهار، قال الله - تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] وإن لم تنقض رأسها إلا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - «فإنها قالت يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال لا. يكفيك أن تفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا» وبلغ عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت لقد كلفهن شططا ألا أمرهن بجز نواصيهن؟، وقال: إنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون رأسك. واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب فقال بعضهم: تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة. والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج. وظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» يشهد للقول الأول. (جنب) اغتسل فانتضح من غسله في إنائه لم يفسد عليه الماء لقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ومن يملك سيل الماء. ولما سئل الحسن عن هذا فقال إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا، أشار إلى أن ما لا يستطاع الامتناع منه يكون عفوا فإن كان ذلك الماء يسيل في إنائه لم يجز الاغتسال بذلك الماء يريد به أن الكثير يمكن التحرز عنه فلا يجعل عفوا، والحد الفاصل بين القليل، والكثير إن كان يستبين مواقع القطر في الإناء يكون كثيرا. قال: (ولا يجوز التوضؤ بماء مستعمل في وضوء، أو غسل شيء من البدن) ، وقال مالك - رحمه الله: يجوز؛ لأن بدن الجنب، والمحدث طاهر حتى لو عرق في ثوبه، أو لبس ثوبا مبلولا لم يفسد الثوب،، واستعمال الماء في محل طاهر لا يغير صفته كما لو غسل به إناء طاهر. (ولنا) قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة» فالتسوية بينهما تدل على أن الاغتسال يفسد الماء، وقال علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في مسافر معه ماء يحتاج إليه لشربه إنه يتيمم، ويمسك الماء لعطشه فلو لم يتغير الماء بالاستعمال لأمرا بالتوضؤ في إناء، ثم بالإمساك للشرب، والعادة جرت بصب الغسالة في السفر، والحضر مع عزة الماء في السفر فذلك دليل ظاهر على تغير الماء بالاستعمال. ثم اختلفوا في صفة الماء المستعمل فقال أبو يوسف - رحمه الله - هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش، وهو روايته عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم، وقال محمد - رحمه الله تعالى - هو طاهر غير طهور، وهو رواية زفر، وعافية القاضي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. وجه قول أبي يوسف أن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية، ثم إزالة النجاسة العينية بالماء تنجسه فإزالة الحدث الحكمي به أولى، ولهذا قال في رواية الحسن - رحمه الله: التقدير فيه بالدرهم كما في النجاسة العينية، ولكنه بعيد فإن للبلوى تأثيرا في تخفيف النجاسة،، ومعنى البلوى في الماء المستعمل ظاهر فإن صون الثياب عنه غير ممكن، وهو مختلف في نجاسته فلذلك خف حكمه. وجه قول محمد - رحمه الله - ما روي «الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمسحون به أعضاءهم، ومن لم يصبه أخذ بللا من كف صاحبه»، والتبرك بالنجس لا يكون، والمعنى أن أعضاء المحدث طاهرة، ولكنه ممنوع من إقامة القربة فإذا استعمل الماء تحول ذلك المنع إلى الماء فصارت صفة الماء كصفة العضو قبل الاستعمال فيكون طاهرا غير طهور بخلاف ما إذا أزال النجاسة بالماء فالنجاسة هناك تتحول إلى الماء (وروى) المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله - أن المتوضئ بالماء إن كان محدثا يصير الماء نجسا، وإن كان طاهرا لا يصير الماء نجسا، ولكن باستعمال الطاهر يصير الماء مستعملا إلا على قول زفر والشافعي - رحمهما الله تعالى - فإنهما يقولان إذا لم يحصل إزالة حدث، أو نجاسة بالماء لا يصير الماء مستعملا كما لو غسل به ثوبا طاهرا (ولنا) أن إقامة القربة حصل بهذا الاستعمال قال - عليه الصلاة والسلام - «الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة» فنزل ذلك منزلة إزالة الحدث به بخلاف غسل الثوب، والإناء الطاهر فإنه ليس فيه إقامة القربة (وذكر) الطحاوي - رحمه الله - أنه إذا تبرد بالماء صار الماء مستعملا، وهذا غلط منه إلا أن يكون تأويله إن كان محدثا فيزول الحدث باستعمال الماء. وإن كان قصده التبرد فحينئذ يصير مستعملا. قال (، وسؤر الآدمي طاهر) لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بعس من لبن فشرب بعضه، وناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشربه، ثم ناوله أبا بكر - رضي الله عنه - فشربه»، ولأن عين الآدمي طاهر، وإنما لا يؤكل لكرامته لا لنجاسته، وسؤره متحلب من عينه، وعينه طاهر فكذلك سؤره. وكذلك سؤر الحائض لما روي «أن عائشة - رضي الله عنها - شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمه على موضع فيها، وشرب» «، ولما قال لها ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال حيضتك ليست في يدك». إذا ثبت هذا في اليد فكذلك في الفم. وكذلك سؤر الجنب لما روي «أن حذيفة - رضي الله عنه - استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراد أن يصافحه فحبس يده، وقال إني جنب فقال - عليه الصلاة والسلام - إن المؤمن لا ينجس». وكذلك سؤر المشرك عندنا، وبعض أصحاب الظواهر يكرهون ذلك لقوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] ، ولكنا نقول: المراد منه خبث الاعتقاد بدليل ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزل وفد ثقيف في المسجد، وكانوا مشركين»، ولو كان عين المشرك نجسا لما أنزلهم في المسجد. وكذلك سؤر ما يؤكل لحمه من الدواب، والطيور لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بسؤر بعير، أو شاة، وقال ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر» ما خلا الدجاجة المخلاة فإن سؤرها مكروه؛ لأنها تفتش الجيف، والأقذار فمنقارها لا يخلو عن النجاسة، ولكن مع هذا لو توضأ به جاز؛ لأنه على يقين من طهارة منقارها. وفي شك من النجاسة، والشك لا يعارض اليقين فإن كانت الدجاجة محبوسة فسؤرها طاهر؛ لأن منقارها عظم جاف ليس بنجس، ولأن عينها طاهر مأكول فكذلك ما يتحلب منه، والذي روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول بحرمة الدجاجة شاذ غير معمول به فقد صح في الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل لحم الدجاجة». وصفة المحبوسة أن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فإنه إذا كان يصل ربما تفتش ما يكون منها فهي، والمخلاة سواء، والذي بينا في سؤر هؤلاء فكذلك في اللعاب، والعرق إذا أصاب لعاب ما يؤكل لحمه، أو عرقه ثوب إنسان تجوز الصلاة فيه؛ لأن ذلك متحلب من عينه فكان طاهرا كلبنه. قال (ولا يصح التطهر بسؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب، والسباع، ولعابه يفسد الماء، وهنا مسائل) : أحداها سؤر الخنزير فإنه نجس بالاتفاق؛ لأن عينه نجس قال الله تعالى {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] والرجس، والنجس سواء. (والثانية) سؤر الكلب فإنه نجس إلا على قول مالك - رحمه الله - بناء على مذهبه في تناول لحمه، وكان يقول الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب كان تعبدا لا للنجاسة كما أمر المحدث بغسل أعضائه تعبدا، أو كان ذلك عقوبة عليهم، والكلاب فيهم كانت تؤذي الغرباء فنهوا عن اقتنائها، وأمروا بغسل الإناء من ولوغها عقوبة عليهم. (ولنا) حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «طهور إناء أحدكم إذا، ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا». وفي بعض الروايات قال «سبعا، وتعفر الثامنة بالتراب» فقوله طهور إناء أحدكم دليل على تنجس الإناء بولوغه، وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد فإن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات، والزيادة في العدد، والتعفير بالتراب دليل على غلظ النجاسة، والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس، وإليه يشير محمد - رحمه الله - في الكتاب في قوله، وليس الميت بأنجس من الكلب، والخنزير، وبعض مشايخنا يقول عين الكلب ليس بنجس، ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ، وسنقرره من بعد. وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد، والفهد، والنمر عندنا نجس.، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - طاهر لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقيل أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم، وبما أفضلت السباع كلها»، وفي حديث جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة، والمدينة، وما ينوبها من السباع فقال لها ما ولغت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب، وطهور»، ولأن عينها طاهرة بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار، وجواز بيعها فيكون سؤرها طاهرا كسؤر الهرة. (ولنا) ما روي أن ابن عمر وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، وردا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا فقال ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - يا صاحب الحوض لا تخبرنا. فلولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله لما نهاه عن ذلك، والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث غير طيب فسؤرها كذلك كالكلب، والخنزير، وهذا؛ لأن سؤرها يتحلب من عينها كلبنها، ثم لبنها حرام غير مأكول فكذلك سؤرها، وهو القياس في الهرة أيضا لكن تركنا ذلك بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة «ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم، والطوافات» أشار إلى العلة، وهي كثرة البلوى لقربها من الناس، وهذا لا يوجد في السباع فإنها تكون في المفاوز لا تقرب من الناس اختيارا، وتأويل الحديثين أنه كان ذلك في الابتداء قبل تحريم لحم السباع، أو السؤال وقع عن الحياض الكبار، وبه نقول إن مثلها لا ينجس بورود السباع. فأما سؤر الحمار فطاهر عند الشافعي - رحمه الله تعالى -، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه كان يقول الحمار يعلف القت، والتبن فسؤره طاهر، وعندنا مشكوك فيه غير متيقن بطهارته، ولا بنجاسته فإن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول إنه رجس فيتعارض قوله، وقول ابن عباس - رضي الله عنهما -، وكذلك الأخبار تعارضت في أكل لحمه فروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»، وروي أن أبجر بن غالب - رضي الله عنه - قال لم يبق لي من مالي إلا حميرات فقال - عليه الصلاة والسلام - «كل من سمين مالك»، وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته، واعتباره بلبنه يدل على نجاسته، ولأن الأصل الذي أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة موجود في الحمار؛ لأنه يخالط الناس لكنه دون ما في الهرة فإنه لا يدخل المضايق فلوجود أصل البلوى لا نقول بنجاسته، ولكون البلوى فيه متقاعدا لا نقول بطهارته فيبقى مشكوكا فيه، وأدلة الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض، والحكم فيها الوقف، وكان أبو طاهر الدباس - رحمه الله - ينكر هذا، ويقول لا يجوز أن يكون شيء من حكم الشرع مشكوكا فيه، ولكن يحتاط فيه فلا يجوز أن يتوضأ به حالة الاختيار، وإذا لم يجد غيره يجمع بينه، وبين التيمم احتياطا فبأيهما بدأ أجزأه إلا على قول زفر فإنه يقول يبدأ بالوضوء فلا يعتبر تيممه مادام معه ماء هو مأمور بالتوضؤ به، ولكن نقول الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب فإن كان طاهرا فقد توضأ به قدم، أو أخر، وإن كان نجسا ففرضه التيمم، وقد أتى به، ولا يقال في هذا ترك الاحتياط من وجه؛ لأنه إن كان نجسا تتنجس به أعضاؤه، وهذا؛ لأن معنى الشك في طهارته لا في كونه طاهرا؛ لأن الحدث يقين فأما العضو، والثوب فطاهر بيقين فلا يتنجس بالشك، والحدث موجود بيقين فالشك وقع في طهارته، واليقين لا يزال بالشك، وهو الصحيح من المذهب. وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في لعاب الحمار إذا أصاب الثوب تجوز الصلاة فيه ما لم يفحش، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أجزأه، وإن فحش، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لو غمس فيه الثوب تجوز الصلاة في ذلك الثوب، وجميع ما بينا في الحمار كذلك في البغل فإن والده غير مأكول اللحم، والصحيح في عرقهما أنه طاهر، وأشار في بعض النسخ إلى جواز الصلاة فيه ما لم يفحش، والأصح هو الأول «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركب حمارا معروريا»، والحر حر تهامة، ولا بد أن يعرق الحمار، ولأن معنى البلوى في عرقه ظاهر لمن يركبه. فأما سؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه مكروه كلحمه وجه ظاهر الرواية، وهو أن السؤر لمعنى البلوى أخف حكما من اللحم كما في الحمار، والبغل، والكراهة التي في اللحم تنعدم في السؤر ليظهر به خفة الحكم. فأما سؤر حشرات البيت كالفأرة، والحية، ونحوهما في القياس فنجس؛ لأنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب من لعابها، ولعابها يتحلب من لحمها، ولحمها حرام، ولكنه استحسن فقال طاهر مكروه؛ لأن البلوى التي، وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة هنا فإنها تسكن البيوت، ولا يمكن صون الأواني عنها. وأما سؤر سباع الطير كالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب، وما لا يؤكل لحمه من الطير في القياس نجس؛ لأن ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير معتبر بما لا يؤكل لحمه من سباع الوحش، ولكنا استحسنا فقلنا بأنه طاهر مكروه؛ لأنها تشرب بمنقارها، ومنقارها عظم جاف بخلاف سباع الوحش فإنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب بلعابها، ولأن في سؤر سباع الطير 
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 51 الى صـــ 60 (6) تتحقق البلوى فإنها تنقض من الهواء فلا يمكن صون الأواني عنها خصوصا في الصحاري بخلاف سباع الوحش.، وعن أبي يوسف - رحمه الله - قال ما يقع على الجيف من سباع الطير فسؤره نجس؛ لأن منقاره لا يخلو عن نجاسة عادة. وأما سؤر السنور ففي كتاب الصلاة قال، وإن توضأ بغيره أحب إلي وفي الجامع الصغير قال هو مكروه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا بأس بسؤره لحديث عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصغي الإناء لهرة حتى تشرب، ثم يتوضأ بالباقي». (ولنا) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة»، وهو إشارة إلى الكراهة، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الهرة سبع»، وهي من السباع التي لا يؤكل لحمها فهذا الحديث يدل على النجاسة، وحديث عائشة - رضي الله عنها - يدل على الطهارة فأثبتنا حكم الكراهة عملا بهما جميعا، وكان الطحاوي - رحمه الله - يقول: كراهة سؤره لحرمة لحمه، وهذا يدل على أنه إلى التحريم أقرب، وقال الكرخي - رحمه الله - كراهة سؤره؛ لأنه يتناول الجيف فلا يخلو فمه عن النجاسة عادة، وهذا يدل على أن الكراهة كراهة تنزيه، وهو الأصح، والأقرب إلى موافقة الأثر. قال (وإن مات في الإناء ذباب، أو عقرب، أو غير ذلك مما ليس له دم سائل لم يفسده عندنا) ، وقال الشافعي - رضي الله عنه - يفسده إلا ما خلق منه كدود الخل يموت فيه، وسوس الثمار يموت في الثمار، واستدل بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] فهو تنصيص على نجاسة كل ميتة، وإذا تنجس بالموت تنجس ما مات فيه إلا أن فيما خلق منه ضرورة، ولا يمكن التحرز عنه فصار عفوا لهذا. (ولنا) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، ثم امقلوه، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه سما، وفي الآخر شفاء»، وإنه ليقدم السم على الشفاء، ومعلوم أن الذباب إذا مقل مرارا في الطعام الحار يموت فلو كان مفسدا لما أمر بمقله، وفي حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما ليس له دم سائل إذا مات في الإناء فهو الحلال أكله، وشربه، والوضوء به»، ولأن الحيوان إذا مات فإنما يتنجس لما فيه من الدم المسفوح حتى لو ذكي فسال الدم منه كان طاهرا، وهذا؛ لأن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] فما ليس له دم سائل لا يتناوله نص التحريم فلا ينجس ما مات فيه قياسا على ما خلق منه. قال (وإن وقع فيه دم، أو خمر، أو عذرة، أو بول أفسده عندنا) ، وقال مالك - رحمه الله - لا يفسده إلا أن يتغير به أحد أوصافه من لون، أو ريح، أو طعم، واحتج بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ من بئر، وهي بضاعة، وهي بئر يلقى فيه الجيف، ومحايض النساء فلما ذكر له ذلك قال خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه». (ولنا) قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة» فلو لم يكن ذلك مفسدا للماء ما كان للنهي عنه معنى، وفائدة، وفيه طريقتان إحداهما أن الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ لأن صفة الماء تتغير بما يلقى فيه حتى يضاف إليه كماء الزعفران، وماء الباقلا، والثانية أن الماء لا ينجس، ولكن يتعذر استعماله لمجاورة الفاسد؛ لأن النجاسة تتفرق في أجزاء الماء فلا يمكن استعمال جزء من الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة، واستعمال النجاسة حرام، وأما الحديث فقد قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤه جاريا يسقى منه خمس بساتين، وعندنا الماء الجاري لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه. وقيل إنما كان يلقى فيه الجيف في الجاهلية فإن في الإسلام نهوا عن مثل هذا، وكان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التنزه، والتقذر ما يمنعه من التوضؤ، والشرب من بئر يلقى فيه ذلك في وقته، وإنما أشكل عليهم أن ما كان في الجاهلية هل يسقط اعتباره بتطهير البئر في الإسلام فأزال إشكالهم بما قال. (وإن بزق في الماء، أو امتخط لم يفسده؛ لأنه طاهر لاقى طاهرا)، والدليل على طهارة البزاق «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان في محو بعض الكتابة به»، والدليل على المخاط «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتخط في صلاته فأخذه بثوبه، ودلكه»، ثم المخاط، والنخامة سواء، ولما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمار بن ياسر - رضي الله عنه - يغسل ثوبه من النخامة قال «ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء». (وإن أدخل جنب، أو حائض، أو محدث يده في الإناء قبل أن يغسلها، وليس عليها قذر لم يفسد الماء استحسانا)، وكان ينبغي في القياس أن يفسده؛ لأن الحدث زال عن يده بإدخاله في الإناء فيصير الماء مستعملا كالماء الذي غسل به يده، وجه الاستحسان ما روي أن المهراس كان يوضع على باب مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيها ماء فكان أصحاب الصفة - رضوان الله عليهم - يغترفون منه للوضوء بأيديهم، ولأن فيه بلوى، وضرورة فقد لا يجد شيئا يغترف به الماء من الإناء العظيم فيجعل يده لأجل الحاجة كالمغرفة، وإذا ثبت هذا في المحدث فكذلك في الجنب، والحائض لما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت «كنت أغتسل أنا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فربما بدأت أنا، وربما بدأ هو، وكنت أقول أبق لي، وهو يقول بق لي»، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي قال إذا أدخل الجنب يده، أو رجله في البئر لم يفسده، وإن أدخل رجله في الإناء أفسده، وهذا لمعنى الحاجة ففي البئر الحاجة إلى إدخال الرجل لطلب الدلو فجعل عفوا، وفي الإناء الحاجة إلى إدخال اليد فلا تجعل الرجل عفوا فيه، وإن أدخل في البئر بعض جسده سوى اليد، والرجل أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه. وقال في الأصل إذا اغتسل الطاهر في البئر أفسده، وهو بناء على ما تقدم أن المستعمل للماء على قصد التقرب، وإن كان طاهرا فالماء بفعله يصير مستعملا فإذا اغتسل في البئر صار الماء مستعملا، وقوله أفسده دليل على أن الصحيح من قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الماء المستعمل نجس؛ لأن الفاسد من الماء هو النجس، وإذا انغمس فيه لطلب دلو، وليس على بدنه قذر لم يفسد الماء؛ لأنه لم يوجد فيه إزالة الحدث، ولا إقامة القربة لما لم يغتسل فيه، وإن انغمس في جب يطلب دلوا لم يفسد الماء، ولم يجزئه من الغسل في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا يفسد الماء، ويجزئه من الغسل، وعن أبي يوسف في الأمالي أن الماء يفسد، ولا يجزئه من الغسل. من أصحابنا من قال هذا الخلاف ينبني على أصل، وهو أن عند أبي يوسف الماء يصير مستعملا بأحد شيئين إما بإزالة الحدث، أو بإقامة القربة فلو زال الحدث هنا صار الماء مستعملا فلا يجزئه من الاغتسال فلهذا قال الرجل بحاله، والماء بحاله، ومن أصل محمد أن الماء لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة، والاغتسال يتحصل بغير نية فكان الرجل طاهرا، والماء غير مستعمل لعدم القصد منه إلى إقامة القربة، وهذا ليس بقوي فإن هذا المذهب غير محفوظ عن محمد نصا، ولكن الصحيح أن إزالة الحدث بالماء مفسد للماء إلا عند الضرورة كما بينا في الجنب يدخل يده في الإناء، وفي البئر معنى الضرورة موجود فإنهم إذا جاءوا بغواص لطلب دلوهم لا يمكنهم أن يكلفوه الاغتسال أولا فلهذا لا يصير الماء مستعملا، ولكن الرجل يطهر؛ لأن الماء مطهر من غير قصد. وجه رواية الإملاء أنه كما أدخل بعض أعضائه في البئر صار الماء مستعملا فبعد ذلك سواء اغتسل، أو لم يغتسل لم يطهره الماء المستعمل. قال (وإن وقع في البئر بول ما يؤكل لحمه أفسده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، ولا يفسده في قول محمد، ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه). وأصل المسألة أن بول ما يؤكل لحمه نجس عندهما طاهر عند محمد - رحمه الله تعالى -، واحتج بحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - «أن قوما من عرنة جاءوا إلى المدينة فأسلموا فاجتووا المدينة فاصفرت ألوانهم، وانتفخت بطونهم فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها، وألبانها» الحديث، فلو لم يكن طاهرا لما أمرهم بشربه، والعادة الظاهرة من أهل الحرمين بيع أبوال الإبل في القوارير من غير نكير دليل ظاهر على طهارتها، ولهما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»، ولما ابتلي سعد بن معاذ - رضي الله تعالى عنه - بضغطة القبر «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سببه فقال إنه كان لا يستنزه من البول»، ولم يرد به بول نفسه فإن من لا يستنزه منه لا تجوز صلاته، وإنما أراد أبوال الإبل عند معالجتها، والمعنى أنه مستحيل من أحد الغذاءين إلى نتن، وفساد فكان نجسا كالبعر. فأما حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - فقد ذكر قتادة عن أنس - رضي الله تعالى عنه - «أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل»، ولم يذكر الأبوال، وإنما ذكره في حديث حميد عن أنس - رضي الله تعالى عنهما -، والحديث حكاية حال فإذا دار بين أن يكون حجة، أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج به، ثم نقول خصهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه، ولا يوجد مثله في زماننا، وهو كما «خص الزبير - رضي الله تعالى عنه - بلبس الحرير لحكة كانت به»، وهي مجاز عن القمل فإنه كان كثير القمل، أو؛ لأنهم كانوا كفارا في علم الله تعالى، ورسوله علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر في النجس. إذا عرفنا هذا فنقول: إذا وقع في الماء فعند محمد - رحمه الله - هو طاهر فلا يفسد الماء حتى يجوز شربه، ولكن إذا غلب على الماء لم يتوضأ به كسائر الطاهرات إذا غلبت على الماء، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هو نجس فكان مفسدا للماء، والبئر، والإناء فيه سواء، وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز شربه للتداوي، وغيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، وعند محمد يجوز شربه للتداوي، وغيره؛ لأنه طاهر عنده، وعند أبي يوسف يجوز شربه للتداوي لا غير عملا بحديث العرنيين، ولا يجوز لغيره، ولو أصاب الثوب لم ينجسه عند محمد - رحمه الله تعالى - حتى تجوز الصلاة فيه، وإن امتلأ الثوب منه، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ينجس الثوب إلا أنه يجوز الصلاة فيه ما لم يكن كثيرا فاحشا؛ لأنه مختلف في نجاسته، وفيه بلوى لمن يعالجها فخفت نجاسته لهذين المعنيين فكان التقدير بالكثير الفاحش، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - الكثير الفاحش في الثوب الربع فصاعدا قيل أراد به ربع الموضع الذي أصابه من ذيل، أو غيره، وقيل أراد به ربع جميع الثوب، وهو الصحيح، وهذا؛ لأن الربع ينزل منزلة الكمال بدليل أن المسح بربع الرأس كالمسح بجميعه، وعن أبي يوسف في روايته الكثير الفاحش شبر في شبر، وفي رواية ذراع في ذراع، وعن محمد - رحمه الله تعالى - فيما يقدر الكثير الفاحش على قوله كالأرواث، وغيره أنه قدر موضع القدمين، وهذا قريب من شبر في شبر. (ويستحب للرجل حين يبتدئ الوضوء أن يقول بسم الله، وإن لم يقل أجزأه)، وعلى قول أصحاب الظواهر التسمية من الأركان لا يجوز الوضوء إلا بها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وضوء لمن لم يسم»، وعندنا التسمية من سنن الوضوء لا من أركانه فإن الله تعالى بين أركان الوضوء بقوله {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية، ولم يذكر التسمية «، وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الوضوء، ولم يذكر التسمية» فتبين بهذا أن المراد من قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وضوء لمن لم يسم» نفي الكمال لا نفي الجواز كما قال في حديث آخر «من توضأ، وسمى كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ، ولم يسم كان طهورا لأعضاء وضوئه»، وفي الحديث المعروف «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع» أي ناقص غير كامل، وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة فإنا أمرنا بها إظهارا لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح فكان الترك مفسدا، وهنا أمرنا بالتسمية تكميلا للثواب لا مخالفة للمشركين فإنهم كانوا لا يتوضئون فلم يكن الترك مفسدا لهذا. قال (وإن بدأ في وضوئه بذراعيه قبل وجهه، أو رجليه قبل رأسه أجزأه عندنا) ، ولم يجزه عند الشافعي - رضي الله عنه - فإن الترتيب في الوضوء عندنا سنة، وعنده من الأركان، واستدل بقوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية، والفاء للوصل، والترتيب فظاهره يقتضي أنه يلزمه، وصل غسل الوجه بالقيام إلى الصلاة، ولا يجوز تقديم غيره عليه، ثم إن الله تعالى عطف البعض على البعض بحرف الواو، وذلك موجب للترتيب كما في قوله تعالى {اركعوا، واسجدوا} [الحج: 77] ، ولما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السعي بين الصفا، والمروة بأيهما نبدأ فقال «ابدءوا بما بدأ الله تعالى به». فدل على أن الواو للترتيب، وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل، وجهه ثم يديه»، ولا شك أن حرف ثم للترتيب. (ولنا) ما ذكره أبو داود - رحمه الله تعالى - في سننه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم فبدأ بذراعيه، ثم بوجهه»، والخلاف فيهما واحد، وروي «أنه - صلى الله عليه وسلم - نسي مسح رأسه في وضوئه فتذكر بعد فراغه فمسحه ببلل في كفه»، ولأن الركن تطهير الأعضاء، وذلك حاصل بدون الترتيب. (ألا ترى) أنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزأه، ولم يوجد الترتيب، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الترتيب في الوضوء لا تدل على أنه ركن فقد كان يواظب على السنن كما واظب على المضمضة، والاستنشاق، وأهل اللغة اتفقوا على أن الواو للعطف مطلقا من غير أن تقتضي جمعا، ولا ترتيبا فإن الرجل إذا قال جاءني زيد، وعمرو كان إخبارا عن مجيئهما من غير ترتيب في المجيء قال الله تعالى {واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران: 43] فلا يدل ذلك على ترتيب الركوع على السجود، وكذلك في الآية أمر بغسل الأعضاء لا بالترتيب في الغسل. (ألا ترى) أن ثبوت الحدث في الأعضاء لا يكون مرتبا فكذلك زواله، والحديث محمول على صفة الكمال، وبه نقول. (وإن غسل بعض أعضائه، وترك البعض حتى جف ما قد غسل أجزأه؛ لأن الموالاة سنة عندنا)، وقال مالك - رحمه الله تعالى -، وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى - الموالاة ركن فلا يجزئه تركه «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واظب على الموالاة» فلو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز.، وقال ابن أبي ليلى إن كان في طلب الماء أجزأه؛ لأن ذلك من عمل الوضوء فإن كان أخذ في عمل آخر غير ذلك، وجف وجب علينا إعادة ما جف، وجعله قياس أعمال الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آخر. (ولنا) ما بينا أن المقصود تطهير الأعضاء، وذلك حاصل بدون الموالاة، والمنصوص عليه في الكتاب غسل الأعضاء فلو شرطنا الموالاة كان زيادة على النص، وقد بينا أن مواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تكون لبيان السنة، وأفعال الصلاة تؤدى بناء على التحريمة، والاشتغال بعمل آخر مبطل للتحريمة فكان مفسدا بخلاف الوضوء فإن أركان الوضوء لا تنبني على التحريمة حتى لم يكن الكلام في الوضوء مفسدا له، والله أعلم. قال (، ولا يفسد خرء الحمام، والعصفور الماء فإنه طاهر عندنا) ، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نجس يفسد الماء، والثوب، والقياس ما قال؛ لأنه مستحيل من غذاء الحيوان إلى فساد لكن استحسنه علماؤنا - رحمهم الله تعالى - لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - أنه خرئت عليه حمامة فمسحه بأصبعه وابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ذرق عليه طائر فمسحه بحصاة، وصلى، ولم يغسله، ولأن الحمام تركت في المساجد حتى في المسجد الحرام مع علم الناس بما يكون منها، وأصله حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شكر الحمامة، وقال إنها، أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها» فهو دليل على طهارة ما يكون منها. . قال (وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور ذكر في الجامع الصغير أنه تجوز الصلاة فيه، وإن كان أكثر من قدر الدرهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز بمنزلة خرء ما لا يؤكل لحمه من السباع) ، والمعنى أنه مستحيل من غذائه إلى فساد. واختلف مشايخنا - رحمهم الله - على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - فمنهم من قال هو نجس عندهما لكن التقدير فيه بالكثير الفاحش لمعنى البلوى، والأصح أنه طاهر عندهما فإن الخرء لا فرق فيه بين مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم في النجاسة، ثم خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر فكذلك ما لا يؤكل لحمه. قال (، وبول الخفافيش لا يفسد الماء؛ لأنه لا يستطاع الامتناع منه، ولا يستقذره الناس عادة) ، ويفسده خرء الدجاج؛ لأنه أشبه الأشياء بالعذرة لونا، ورائحة فكان نجسا نجاسة غليظة. قال (، وموت الضفدع، والسمك، والسرطان في الماء لا يفسده) لوجهين.: أحدهما أن الماء معدنه، والشيء إذا مات في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة كمن صلى، وفي كمه بيضة مذرة حال محها دما تجوز صلاته، وهذا؛ لأن التحرز عن موته في الماء غير ممكن والثاني أنه ليس لهذه الحيوانات دم سائل فإن ما يسيل منها إذا شمس ابيض، والدم إذا شمس اسود، وهذا الحرف أصح؛ لأنه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل، والعصير، ويستوي إن تقطع، أو لم يتقطع إلا على قول أبي يوسف - رحمه الله - فإنه يقول إذا تقطع في الماء أفسده بناء على قوله أن دمه نجس، وهو ضعيف فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آجن، ولو كان فيه دم فهو مأكول فلا يكون نجسا كالكبد، والطحال. وأشار الطحاوي - رحمه الله - إلى أن الطافي من السمك يفسد الماء، وهو غلط منه فليس في الطافي أكثر من أنه غير مأكول فهو كالضفدع، والسرطان، وعن محمد - رحمه الله تعالى - قال الضفدع إذا تفتت في الماء كرهت شربه لا لنجاسته، ولكن لأن أجزاء الضفدع فيه، والضفدع غير مأكول. (وإذا ماتت الفأرة في البئر فاستخرجت حين ماتت نزح من البئر عشرون دلوا، وإن ماتت في جب أريق الماء، وغسل الجب؛ لأنه تنجس بموت الفأرة فيه) والقياس في البئر أحد شيئين أما ما قاله بشر - رحمه الله - أنه يطم رأس البئر، ويحفر في موضع آخر؛ لأنه، وإن نزح ما فيها من الماء يبقى الطين، والحجارة نجسا، ولا يمكن كبه ليغسل فيطم. وأما ما نقل عن محمد - رحمه الله تعالى - قال اجتمع رأيي، ورأي أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن ماء البئر في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله، ويؤخذ من أعلاه فلا يتنجس بوقوع النجاسة فيه كحوض الحمام إذا كان يصب فيه من جانب، ويؤخذ من جانب لم يتنجس بإدخال يد نجسة فيه. ثم قلنا، وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء، ولا نخالف السلف، وتركنا القياس لحديث، علي - رضي الله تعالى عنه - قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها دلاء، وفي رواية سبع دلاء. ، وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال في الدجاجة تموت في البئر ينزح منها أربعون دلوا. (ولنا) حديث النخعي والشعبي في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا، وروي عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا»، ولكنه شاذ، وعن ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - في الزنجي الذي وقع في بئر زمزم فمات أنهما أمرا بنزح جميع الماء. ثم في الأصل جعله على ثلاث مراتب في الفأرة عشرون دلوا، وفي السنور، والدجاجة أربعون دلوا، وفي الشاة، والآدمي جميع الماء.، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - جعله على خمس درجات في الجلة، والفأرة الصغيرة عشر دلاء، وفي الفأرة الكبيرة عشرون دلوا، وفي الحمامة ثلاثون دلوا، وفي الدجاجة أربعون دلوا، وفي الشاة، والآدمي جميع الماء، وهذا؛ لأنه إنما يتنجس من الماء ما جاوز النجاسة، والفأرة تكون في وجه الماء فإذا نزح عشرون دلوا فالظاهر أنه نزح جميع ما جاوز الفأرة فما بقي يبقى طاهرا، والدجاجة تغوص في الماء أكثر مما تغوص الفأرة فيتضاعف النزح لهذا، والشاة، والآدمي يغوص إلى قعر الماء فيموت، ثم يطفو فلهذا نزح جميع الماء، وهذا إذا لم يتفسخ شيء من هذه الحيوانات فإن انتفخ، أو تفسخ نزح جميع الماء. الفأرة، وغيرها فيه سواء؛ لأنه ينفصل منها بلة نجسة، وتلك البلة نجاسة مائعة بمنزلة قطرة من خمر، أو بول تقع في البئر. ولهذا قال محمد - رحمه الله تعالى - إذا، وقع في البئر ذنب فأرة ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع فيه لا ينفك عن نجاسة مائعة بخلاف الفأرة فإن غلبهم الماء في موضع، وجب نزح جميع الماء فالمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه إذا نزح منها مائة دلو يكفي، وهو بناء على آبار الكوفة لقلة الماء فيها. وعن محمد - رحمه الله تعالى - في النوادر أنه ينزح منها ثلاثمائة دلو، أو مائتا دلو، وإنما أجاب بهذا بناء على كثرة الماء في آبار بغداد، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - ينزح قدر ما كان فيها من الماء قيل معناه أنه ينظر إلى عمق البئر، وعرضه فيحفر حفيرة مثلها، ويصب ما ينزح فيها فإذا امتلأت فقد نزح ما كان فيها. وقيل يرسل قصبة في الماء، ويجعل على مبلغه علامة، ثم ينزح عشر دلاء، ثم يرسل القصبة ثانيا فينظر كم انتقص فإن انتقص العشر علم أن البئر مائة دلو، والأصح أنه ينظر إليها رجلان لهما بصر في الماء فبأي مقدار قالا في البئر ينزح ذلك القدر، وهذا أشبه بالفقه فإن كان توضأ رجل منها بعد ما ماتت الفأرة فيها فعليه إعادة الوضوء، والصلوات جميعا؛ لأنه تبين أنه توضأ بالماء النجس، وإن كان لا يدري متى وقع فيها، وقد كان وضوءه من ذلك البئر فإن كانت منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام، ولياليها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - احتياطا، وإن كانت غير منتفخة يعيد صلاة يوم، وليلة. وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ليس عليه أن يعيد شيئا من صلاته ما لم يعلم أنه توضأ منها، وهو فيها، والقياس ما قالا؛ لأنه على يقين من طهارة البئر فيما مضى، وفي شك من نجاسته، واليقين لا يزال بالشك كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات لهذا، وكان أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول أولا بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى رأى طائرا في منقاره فأرة ميتة، وألقاها في بئر فرجع إلى هذا القول، وقال لا يعيد شيئا من الصلاة بالشك وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: ظهر لموت الفأرة سبب، وهو وقوعها في البئر فيحال موتها عليه كمن جرح إنسانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات يحال موته على تلك الحالة؛ لأنه هو الظاهر من السبب، ثم الانتفاخ دليل تقادم العهد، وأدنى حد التقادم ثلاثة أيام. (ألا ترى) أن من دفن قبل أن يصلى عليه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام، ولا يصلى بعد ذلك؛ لأنه يتفسخ في هذه المدة، وقولهما: إن في نجاسة البئر فيما مضى شكا قلنا يؤيد هذا الشك تيقن النجاسة في الحال فوجب اعتباره، والقول به للاحتياط فيه، وفي مسألة الثوب قال معلى: الخلاف فيهما، واحد، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - إن كانت النجاسة بالية يعيد صلاة ثلاثة أيام، ولياليها، وإن كانت طرية يعيد صلاة يوم، وليلة، ومن سلم فرق بينهما لأبي حنيفة - رحمه الله - فقال الثوب كان يقع بصره عليه في كل، وقت فلو كانت فيه نجاسة فيما مضى لرآها فأما البئر فمغيب عن بصره، والموضع موضع الاحتياط فإن كانت غير منتفخة قال أبو حنيفة - رحمه الله - يعيد صلاة يوم، وليلة؛ لأنه لما وجب عليه إعادة الصلاة أمرناه بإعادة صلاة يوم، وليلة احتياطا. (وإذا صلى، وفي ثوبه من الروث، أو السرقين، أو بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب، أو خرء الدجاجة أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته)، والأصل في هذا أن القليل من النجاسة في الثوب لا يمنع جواز الصلاة فيه عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله - إذا كان بحيث يقع بصره عليه يمنع جواز الصلاة قال؛ لأن الطهارة عن النجاسة العينية شرط جواز الصلاة كالطهارة عن الحدث الحكمي فكما أن الشرط ينعدم بالقليل من الحدث، وكثيره فكذلك ينعدم بالقليل من النجاسة، وكثيرها. وحجتنا ما روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إن كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، ولأن القليل من النجاسة لا يمكن التحرز عنه؛ فإن الذباب يقعن على النجاسات، ثم يقعن على ثياب المصلي، ولا بد من أن يكون على أجنحتهن، وأرجلهن نجاسة فجعل القليل عفوا لهذا بخلاف الحدث فإنه لا بلوى في القليل منه، والكثير. ثم إن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار، وقلما يتطيبون بالماء، والاستنجاء بالحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده في الماء القليل نجسه فاكتفاؤهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو، ولهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث هكذا قال النخعي - رحمه الله تعالى -، واستقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم.، وكان النخعي يقول إذا بلغ مقدار الدرهم منع جواز الصلاة.، وكان الشعبي يقول لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم، وأخذنا بهذا لأنه أوسع، ولأنه قد كان في الصحابة - رضوان الله عليهم - من هو مبطون، ولوث المبطون أكثر، ومع هذا كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار، والدرهم أكبر ما يكون من النقد المعروف فأما المنقطع من النقود كالسهيلي، وغيره فقد قيل إنه يعتبر به، وهو ضعيف، والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته كالخمر، والبول، وخرء الدجاج، وفي الخرء إذا كان أكثر من وزن مثقال، ولا عرض له يمنع جواز الصلاة أيضا. فأما الروث، والسرقين فنقول: روث ما لا يؤكل سواء، وهو نجس عندنا، وقال مالك - رحمه الله - روث ما يؤكل لحمه طاهر لما روي أن الشبان من الصحابة في منازلهم في 
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 61 الى صـــ 70 (7) السفر كانوا يترامون بالجلة فلو كانت نجسة لم يمسوها، وقال؛ لأنه وقود أهل المدينة يستعملونه استعمال الحطب. (ولنا) ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب من ابن مسعود أحجارا للاستنجاء ليلة الجن فأتاه بحجرين، وروثة فأخذ الحجرين، ورمى بالروثة، وقال أنها ركس أي نجس». وقيل لمحمد - رحمه الله - لم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه، ولم تقل بطهارة روثه قال: لما قلت بطهارته أجزت شربه فلو قلت بطهارة روثه لأجزت أكله، وأحد لا يقول بهذا، ثم التقدير فيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - بالدرهم، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - بالكثير الفاحش، وقال زفر في روث ما يؤكل لحمه ما لم يكن كثيرا فاحشا لم يمنع، وفي روث ما لا يؤكل لحمه الجواب ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -، واعتبر الروث بالبول فقال في بول ما يؤكل لحمه التقدير بالكثير الفاحش لكونه مختلفا في نجاسته فكذلك في روثه وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا في الأرواث بلوى، وضرورة خصوصا لسائر الدواب، وللبلوى تأثير في تخفيف حكم النجاسة فكان التقدير فيه بالكثير الفاحش وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: الروث منصوص على نجاسته كما روينا في حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فتتغلظ نجاسته، ولا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم كالخمر، والبلوى لا تعتبر في موضع النص فإن البلوى للآدمي في بوله أكثر، وكذا في بول الحمار فإنه يترشش فيصيب الثياب، ومع ذلك لا يعفى عنه من قدر الدرهم لأنه منصوص على نجاسته، وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - قال في الروث، وإن كان فاحشا لا يمنع جواز الصلاة، وهذا آخر أقاويله حين كان بالري، وكان الخليفة بها فرأى الطرق، والخانات مملوءة من الأرواث، وللناس فيه بلوى عظيمة فاختار هذا القول لهذا. قال (، وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البئر، والبالوعة خمسة أذرع في رواية أبي سليمان، والنوادر، والأمالي) ، وفي رواية أبي حفص سبعة أذرع، والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة، والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة، والرخاوة ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما خمسة أذرع فوجد في الماء ريح البول، أو طعمه فلا خير فيه، وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به، وإن كان بينهما أقل من خمسة أذرع فعرفنا أن المعتبر هو الخلوص. (ولا بأس بأن يغتسل الرجل، والمرأة في إناء، واحد) لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -، وقد رويناه فإذا جاز أن يفعلا معا فكذلك أحدهما بعد الآخر. جاء في الحديث أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت من إناء فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت إني كنت جنبا فقال - عليه الصلاة والسلام - «الماء لا يجنب»، والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل» شاذ فيما تعم به البلوى فلا يكون حجة. (وإذا نسي المضمضة، والاستنشاق في الجنابة حتى صلى لم يجزه)، وهو عندنا المضمضة، والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - سنتان فيهما، وقال أهل الحديث فرضان فيهما، ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة، واستدلوا بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها في الوضوء، ولكنا نقول كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال كما يواظب على الأركان. وفي كتاب الله تعالى أمر بتطهير أعضاء مخصوصة، والزيادة على النص لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ، وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الوضوء، ولم يذكرهما فيه. والشافعي - رحمه الله تعالى - استدل بقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ، والإطهار إمرار الطهور على الظواهر من البدن، والفم في حكم الباطن بدليل أن الصائم إذا ابتلع بزاقه لم يضره، وبدليل الوضوء فالفم، والأنف موضعهما الوجه، والغسل فرض فيهما. وبدليل غسل الميت فإنه ليس فيه مضمضة، ولا استنشاق، وإمامنا في المسألة ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه قال: هما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء، وقال - صلى الله عليه وسلم - «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة»، وفي الفم بشرة. قال ابن الأعرابي البشرة الجلدة التي تقي اللحم من الأذى، وقال - صلى الله عليه وسلم - «من ترك موضع شعرة في الجنابة عذبه الله بالنار» كذا قال علي - رضي الله تعالى عنه - فمن ثم عاديت شعري، وفي الأنف شعرات، والمعنى أن للفم حكمين حكم الظاهر من وجه حتى إذا أخذ الصائم الماء بفيه لم يضره، وحكم الباطن من وجه كما قال ففيما يعم جميع الظاهر ألحقناه بالظاهر، وفيما يخص بعضه ألحقناه بالباطن؛ لأنه لما جعل بعض ما هو ظاهر من كل وجه عفوا فما هو باطن من وجه أولى، ولأن الجنابة تحل الفم، والأنف بدليل أن الجنب ممنوع عن قراءة القرآن. والحدث لا يحلهما بدليل أن المحدث لا يمنع من قراءة القرآن، وفي غسل الميت سقوط المضمضة، والاستنشاق للتعذر؛ لأنه لا يمكنه كبه حتى يخرج الماء من فيه، وبدونه يكون سقيا لا مضمضة. إذا ثبت هذا فنقول في كل موضع ترك شيئا من الفرائض لم يصح شروعه في الصلاة حتى إذا قهقه لا يلزمه إعادة الوضوء لأنه لم يصادف حرمة الصلاة في كل موضع ترك شيئا من المسنون صح شروعه في الصلاة فإذا قهقه فعليه إعادة الوضوء، وإن كان متنقلا فعليه إعادة الصلاة، وإن مسح رأسه بماء أخذه من لحيته لم يجزه؛ لأنه مسح بالماء المستعمل فإن الماء إذا فارق عضوه يصير مستعملا، وذلك مروي عن علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الماء من لحيته، واستعمله في لمعة رآها» تأويله في الجنابة، وجميع البدن في الجنابة كعضو، واحد، وإن كان في كفه بلل فمسحه به أجزأه؛ لأن الماء الذي بقي في كفه غير مستعمل فهو كالباقي في إنائه، وقال الحاكم، وهذا إذا لم يكن استعمله في شيء من أعضائه، وهو غلط منه فإنه إذا استعمله في شيء من المغسولات لم يضره؛ لأن فرض الغسل تأدى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية في كفه إلا أن يكون استعمله في المسح بالخف، وحينئذ الأمر على ما قاله الحاكم؛ لأن فرض المسح يتأدى بالبلة. قال، ولا يجزئ مسح الرأس بأصبع، ولا بأصبعين، ويجزئه بثلاثة أصابع، والكلام هنا في فصول: أحدهما في قدر المفروض من مسح الرأس ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع، وفي موضع الناصية، وفي موضع ربع الرأس، وقال الشافعي - رحمه الله - أدنى ما يتناوله الاسم، ولو ثلاث شعرات، وقال مالك - رحمه الله تعالى - المفروض مسح جميع الرأس. وقال الحسن - رحمه الله تعالى - أكثر الرأس، واستدل مالك «بفعل رسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه مسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل بهما، وأدبر»، وبه استدل الحسن - رضي الله تعالى عنه - إلا أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل، وقد بينا أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الركنية فقد يكون ذلك لإكمال الفريضة، واعتبر الممسوح بالمغسول، وهو فاسد فإن المسح بني على التخفيف، وفي كتاب الله تعالى ما يدل على التبعيض في المسح، وهو حرف الباء في قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] فهو إشارة إلى البعض كما يقال كتبت بالقلم، وضربت بالسيف أي بطرف منه. ولهذا قال الشافعي يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم، ولكنا نقول: من مسح ثلاث شعرات لا يقال إنه مسح برأسه عادة، وفي الآية ما يدل على البعض، وهو مجمل في مقدار ذلك البعض بيانه في فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما رواه المغيرة - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته»، وذلك الربع فإن الرأس ناصية، وقذال، وفودان، ولأن الربع بمنزلة الكمال فإن من رأى وجه إنسان يستجيز له أن يقول رأيت فلانا، وإنما رأى أحد جوانبه الأربعة. إذا عرفنا هذا فنقول: ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة أصابع، ولم يمرها جاز في قول محمد - رحمه الله تعالى - في الرأس والخف، ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - حتى يمرها بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس فهما اعتبرا الممسوح عليه ومحمد - رحمه الله تعالى - اعتبر الممسوح به، وهو عشرة أصابع، وربعها أصبعان، ونصف إلا أن الأصبع الواحد لا يتجزأ فجعل المفروض ثلاثة أصابع لهذا، وإن مسح بأصبع، أو بأصبعين لم يجزه عندنا. وقال زفر - رحمه الله تعالى - يجوز إذا مسح به مقدار ربع الرأس قال؛ لأن المعتبر إصابة البلة دون الأصابع حتى لو أصاب رأسه ماء المطر أجزأه عن المسح. (ولنا) أنه كلما وضع الأصابع صار مستعملا فلا يجوز إقامة الفرض به بالإمرار فإن قيل إذا وضع ثلاثة أصابع، ومسح بها جميع رأسه جاز، وكما لا يجوز إقامة الفرض بالماء المستعمل فكذلك إقامة السنة بالممسوح. قلنا: الرأس تفارق المغسولات في المفروض دون المسنون. (ألا ترى) أن في المسنون يستوعب الحكم جميع الرأس كما في المغسولات فكما أن في المغسولات الماء في العضو لا يصير مستعملا فكذلك في حكم إقامة السنة في الممسوح، إلى هذا الطريق يشير محمد - رحمه الله تعالى - حتى قال في نوادر ابن رستم لو أعاد الأصبع إلى الماء ثلاث مرات يجوز، وهكذا قال محمد بن سلمة - رحمه الله تعالى - لو مسح بأصبعه بجوانبه الأربعة يجوز، والأصح عندي أنه لا يجوز، وأن الطريقة غير هذا فقد ذكر في التيمم أنه إذا مسح بأصبع، أو بأصبعين لا يجوز فالاستيعاب هناك فرض، وليس هناك شيء يصير مستعملا، ولكن الوجه الصحيح أن المفروض هو المسح باليد فأكثر الأصابع يقوم مقام الكل فإذا استعمل في مسح الرأس، أو الخف، أو التيمم ثلاثة أصابع كان كالماسح بجميع يده فيجوز، وإلا فلا. وإن كان شعره طويلا فمسح ما تحت أذنيه لم يجزه، وإن مسح ما فوقهما أجزأه؛ لأن المسح على الشعر بمنزلة المسح على البشرة التي تحته، وما تحت الأذنين عنق، وما فوقهما رأس، والأفضل أن يمسح ما أقبل من أذنيه، وما أدبر مع الرأس، وإن غسل ما أقبل منهما مع الوجه جاز؛ لأن في الغسل مسحا، وزيادة، ولكن الأول أفضل؛ لأن الأذنين من الرأس، والفرض في الرأس المسح بالنص، وإنما قلنا إنهما من الرأس؛ لأنهما على الرأس، واعتبرا بآذان الكلاب، والسنانير، والفيل، ومن فغر فاه فيزول عظم اللحيين عن عظم الرأس، وتبقى الأذن مع الرأس، وعلى هذا قلنا لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يأخذ لأذنيه ماء جديدا.، واستدل بما روى أبو أمامة الباهلي - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وأخذ لأذنيه ماء جديدا»، وقال؛ لأن الأذن مع الرأس كالفم، والأنف مع الوجه، ثم يأخذ للمضمضة، والاستنشاق ماء جديدا سوى ما يقيم به فرض غسل الوجه فهذا مثله. (ولنا) حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه، وأذنيه بماء واحد، وقال الأذنان من الرأس». فإما أن يكون المراد بيان الحقيقة، وهو مشاهد لا يحتاج فيه إلى بيانه، أو يكون المراد أنهما ممسوحان كالرأس، وهذا بعيد فاتفاق العضوين في الفرض لا يوجب إضافة أحدهما إلى الآخر فعرفنا أن المراد أنهما ممسوحان بالماء الذي مسح به الرأس، وتأويل ما رواه أنه لم يبق في كفه بلة فلهذا أخذ في أذنيه ماء جديدا. وذكر الحاكم - رحمه الله - في المنتقى إذا أخذ غرفة من الماء فتمضمض بها، وغسل وجهه أجزأه، وبعد التسليم قلنا: المضمضة، والاستنشاق مقدمان على غسل الوجه فإذا أقامهما بماء، واحد كان المفروض تبعا للمسنون، وذلك لا يجوز، وها هنا إذا أقامهما بماء، واحد يكون المسنون تبعا للمفروض، وذلك مستقيم. قال (وإن مسح أذنيه دون رأسه لم يجزه) ؛ لأنه ترك المفروض، والمسنون لا يقوم مقام المفروض (فإن قيل) لكم أين ذهب قولكم الأذنان من الرأس (قلنا) هما من الرأس، وليسا برأس كالثمار من الشجرة، وليست بشجرة، والواحد من العشرة، وليس بعشرة، والفقه فيه أن فرض المسح بالرأس ثابت بالنص، وكون الآذان من الرأس ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما يثبت بالنص كمن استقبل الحطيم بالصلاة فلا تجزئه، وإن كان الحطيم من البيت؛ لأن فرضية استقبال الكعبة ثابت بالنص، وكون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما ثبت بالنص. (ومن توضأ، ومسح رأسه، ثم جز شعره، أو نتف إبطيه، أو قلم أظفاره، أو أخذ من شاربه لم يكن عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء، ولا أن يجدد وضوءه)، وكان ابن جرير - رحمه الله تعالى - يقول عليه أن يتوضأ، وكان إبراهيم - رحمه الله تعالى - يقول يجب عليه إمرار الماء على ذلك الموضع، وهو فاسد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا وضوء إلا من حدث»، وفعله هذا تطهير فكيف يكون حدثا، وإليه أشار علي - رضي الله تعالى عنه - لما سئل عن هذا فقال ما ازداد إلا طهرا، ونظافة. قال (ثم المسح على الشعر مثل المسح على البشرة التي تحته) لا أنه بدل عنه بدليل أن الأصبع إذا مسح على الشعر جاز، ولا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على الأصل فكان جز الشعر بعد المسح كتقشير الجلد عن العضو المغسول بعد الغسل فكما لا يلزمه إمرار الماء ثمة فكذلك هنا بخلاف الماسح على الخفين إذا نزعهما فإن المسح لم يكن بمنزلة الغسل، ولكن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم بدليل أنه لو كان رجله باديا، وقت الحدث لم يجزه المسح فبخلع الخف يسري الحدث إلى القدم. قال (وكذلك إن مس ذكره بعد الوضوء فلا وضوء عليه، وهذا عندنا) ، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - إذا مس بباطن كفه من غير حائل فعليه الوضوء، والرجل، والمرأة في مس الفرج سواء عنده لحديث بسرة بنت صفوان - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من مس ذكره فليتوضأ»، وسئلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن امرأة مست فرجها فقالت: إن كانت ترى ماء هنالك فلتتوضأ، ولأن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل به كالممذي كما أن التقاء الختانين لما كان سببا لاستطلاق وكاء المني جعل به كالممني، وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي أصل في الشرع. (ولنا) حديث «قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن مس ذكره هل عليه أن يتوضأ فقال لا هل هو إلا بضعة منك، أو قال جذوة منك». وعن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - مثل قولنا حتى قال بعضهم إن كان شيء منك نجسا فاقطعه (وقال) بعضهم ما أبالي أمسسته أم أنفي، وهو المعنى فإنه عضو من أعضائه فإما أن يكون طاهرا، أو نجسا، وليس في مس شيء من الطاهرات، ولا من النجاسات وضوء، ولو مس ما يخرج منه لم ينتقض به وضوءه، وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على الخفي، وذلك غير موجود هنا فإن المذي يرى، ويشاهد، وهو فاسد على أصله فإن من مس ذكره غيره عنده يجب الوضوء على الماس دون الممسوس ذكره، واستطلاق وكاء المذي هنا ينبغي في حق الممسوس ذكره، وحديث بسرة لا يكاد يصح فقد قال يحيى بن معين ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها هذا، وما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم، وإنما قاله بين يدي بسرة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من العذراء في خدرها، ولو ثبت فتأويله: من بال، فجعل مس الذكر عن البول؛ لأن من يبول يمس ذكره عادة كقوله تعالى {، أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] ، والغائط هو المطمئن من الأرض كنى به عن الحدث؛ لأنه يكون في مثل هذه المواضع عادة، أو المراد بالوضوء غسل اليد استحبابا كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم»، والمراد منه غسل اليد (قال) ، وكذلك إذا نظر إلى فرج امرأة لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - الوضوء مما خرج، وبمجرد النظر لا يخرج منه شيء فهو، والتفكير سواء. . قال (وفي المني الغسل) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الماء من الماء» يعني الاغتسال من المني، ومراده إذا خرج على وجه الدفق، والشهوة فإن خرج لا على هذه الصفة لحمله شيئا ثقيلا، أو سقوطه على ظهره يلزمه الاغتسال عند الشافعي - رحمه الله تعالى - لعموم الحديث، ولا يلزمه عندنا؛ لأن خروجه بصفة خروج المذي فحكمه حكم المذي في إيجاب الوضوء، ثم المعتبر عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله تعالى - مفارقة المني عن مكانه على وجه الشهوة، والدفق، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - المعتبر ظهوره. بيانه في فصلين.: أحدهما أن من احتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته، ثم سال منه المني فعليه الغسل عندهما، ولا غسل عليه عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -.، والثاني أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول، ثم سال منه بقية المني فعليه الاغتسال عندهما ثانيا، وليس عليه ذلك عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. قال (، وفي المذي الوضوء) لحديث «علي - رضي الله تعالى عنه - قال كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود حتى سأله فقال كل فحل يمذي، وفيه الوضوء» وكذلك الودي فإنه الغليظ من البول فهو كالرقيق منه، ثم فسر هذه المياه فقال (المني خائر أبيض ينكسر منه الذكر) ، وذكر الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في كتابه أن له رائحة الطلع (، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، والودي رقيق يخرج منه بعد البول) ، وتفسير هذه المياه مروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - بهذه الصفة. قال (ولا يجب الوضوء من القبلة، ومس المرأة بشهوة، أو غير شهوة) ، وهو قول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يجب الوضوء من ذلك، وهو قول عمر وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما -، وهو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل ينبغي لمن يؤم الناس أن يحتاط فيه، وقال مالك - رحمه الله - إن كان عن شهوة يجب، وإلا فلا فالشافعي - رحمه الله - استدل بقوله تعالى {، أو لامستم النساء} [النساء: 43] ، وحقيقة المس باليد قال الله تعالى {فلمسوه بأيديهم} [الأنعام: 7] ، ولا يعارض القراءة. (ألا ترى) قوله {أو لامستم} [النساء: 43] فأكثر ما في الباب أن يثبت أن المراد بتلك القراءة الجماع فيعمل بهما جميعا، والمعنى ما ذكرنا أن التقبيل، والمس سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقام خروج المذي حقيقة في إيجاب الوضوء أخذا بالاحتياط في باب العبادة كما فعله أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في المباشرة الفاحشة. (ولنا) حديث عائشة، وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ»، وعن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه انصرف يوما من صلاته فلما فرغ الناس رأوه يصلي في آخر الصفوف فقال إني توضأت فمرت بي جاريتي رومية فقبلتها فلما افتتحت الصلاة، وجدت مذيا فقلت أمضي في صلاتي حياء منكم قلت لأن أراقب الله تعالى خير لي من أن أراقبكم فانصرفت، وتوضأت فهذا دليل رجوع عمر - رضي الله تعالى عنه -؛ لأنه افتتح الصلاة بعد التقبيل حتى إذا أحس بالمذي انصرف، وتوضأ، ولأن عين المس ليس بحدث بدليل مس ذوات المحارم فبقي الحدث ما يخرج عند المس، وذلك ظاهر يوقف عليه فلا حاجة إلى إقامة السبب الظاهر مقامه، وأما الآية فقد قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - المراد بالمس الجماع إلا أن الله تعالى حيي يكني بالحسن عن القبيح كما كنى بالمس عن الجماع، وهو نظير قوله تعالى {، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] ، والمراد الجماع، وهذا؛ لأنه لو حمل على الجماع كان ذكرا للحدث الكبرى بعد ذكر الحدث الصغرى بقوله تعالى {، أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] فأما إذا حمل على المس باليد كان تكرارا محضا. قال (فإن باشرها، وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - استحسانا، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا وضوء عليه، وهو القياس لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - الوضوء مما خرج، وقد تيقن أنه لم يخرج منه شيء فهو كالتقبيل، ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - أن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة فيجعل كالممذي بناء للحكم على الغالب دون النادر كمن نام مضطجعا انتقض وضوءه، وإن تيقن بأنه لم يخرج منه شيء، وكذلك من عدم الماء في المصر لا يجزئه التيمم بناء على الغالب أن الماء في المصر لا يعدم، وفسر الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - المباشرة الفاحشة بأن يعانقها، وهما متجردان، ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها. قال (وإذا التقى الختانان، وغابت الحشفة، وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل) ، وهو قول المهاجرين عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - فأما الأنصار كأبي سعيد وحذيفة، وزيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله تعالى عنهم - قالوا لا يجب الاغتسال بالإكسال ما لم ينزل، وبه أخذ سليمان الأعمش - رضي الله تعالى عنه - لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الماء من الماء». (ولنا) حديث شاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل»، وهو قول المهاجرين عمر وعلي وابن مسعود والأصح «أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يسوغ للأنصار هذا الاجتهاد حتى قال لزيد أي عدو نفسك ما هذه الفتوى التي تقشعت عنك فقال سمعت عمومتي من الأنصار يقلن ذلك فجمعهن عمر، وسألهن فقلن كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نغتسل فقال عمر، أو كان يعلم به رسول الله؟ - صلى الله عليه وسلم - فقلن: لا، فقال: ليس بشيء، وبعث إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها - فسألها فقالت فعلت ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - لزيد لئن عدت إلى هذا لأذيتك»، والمعنى أن هذا الفعل سبب لاستطلاق وكاء المني عادة فقام مقام خروج المني احتياطا؛ لأنه مغيب عن بصره فربما لم يقف عليه لما خرج لقلته فالموضع موضع الاحتياط من هذا الوجه. قال (ولا يجب الغسل بالجماع فيما دون الفرج ما لم ينزل) ؛ لأن ما دون الفرج ليس نظير الفرج في استطلاق وكاء المني بمسه. والدليل عليه حكم الحد، وإليه أشار علي - رضي الله تعالى عنه - في الإكسال فقال يوجب فيه الحد، ولا يوجب فيه صاعا من ماء. قال (ومن احتلم، ولم ير شيئا فلا غسل عليه) ؛ لأنه تفكر في النوم فهو كالتفكر في اليقظة إذا لم يتصل به الإنزال (قال) فإن علم أنه لم يحتلم، ولكنه استيقظ فوجد على فخذه، أو فراشه مذيا فعليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - احتياطا (وقال) أبو يوسف لا غسل عليه؛ لأنه بات طاهرا بيقين فلا يصبح جنبا بالشك ، وخروج المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال.، وحجتهما في ذلك ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أصبح فوجد ماء، ولم يتذكر شيئا فليغتسل، ومن احتلم، ثم أصبح على جفاف فلا غسل عليه»، ولسنا نوجب الاغتسال بخروج المذي إنما نوجبه بخروج المني، ولكن من طبع المني أن يرق بإصابة الهواء فالظاهر أن هذا الخارج كان منيا قد رق قبل أن يستيقظ، ومراد محمد - رحمه الله تعالى - من قوله فوجد مذيا ما يكون صورته صورة المذي لا حقيقة المذي. ثم إن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة، ومسألة المباشرة الفاحشة، ومسألة الفأرة المنتفخة أخذ بالاحتياط وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - وافقه في الاحتياط في مسألة المباشرة لوجود فعل من جهته هو سبب خروج المذي، وخالفه في الفصلين الآخرين لانعدام الفعل منه ومحمد - رحمه الله - وافقه في الاحتياط في مسألة النائم؛ لأنه غافل عن نفسه فلا يحس بما يخرج منه فكان الموضع موضع الاحتياط بخلاف الفصلين الآخرين فإن المباشر ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه. قال (، والمرأة كالرجل في الاحتلام) لحديث «أم سليم حين سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال إن كان منها مثل ما يكون من الرجل فلتغتسل»، وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - أن المرأة إذا تذكرت الاحتلام، والتلذذ، ولم تر شيئا فعليها الغسل؛ لأن منيها يتدفق في رحمها فلا يظهر، وهو ضعيف فإن وجوب الغسل متعلق بخروج المني، والمني يخرج منها عند المواقعة كما يخرج من الرجل. قال (وإذا احتلمت المرأة، ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت، وإن شاءت أخرت حتى تطهر من الحيض) ؛ لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة، وهذا لا يتحقق من الحائض قبل انقطاع الدم، وإن شاءت اغتسلت؛ لأن استعمال الماء يعين على درور الدم (وكان مالك) - رحمه الله تعالى - يقول عليها أن تغتسل بناء على أصله أن الجنب ممنوع عن قراءة القرآن، والحائض لا تمنع. قال (وإذا عرق الجنب، أو الحائض في ثوب لم يضره) لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر الحائض من نسائه بالاتزار، ثم كان يعانقها طول الليل، والحر حر الحجاز فكانا يعرقان لا محالة، ولم يتحرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرقها»، ولأنه ليس على بدن الإنسان الجنب، والحائض نجاسة عينية فهو وأعضاء المحدث سواء. قال (وإذا وقعت الجيفة، أو النجاسة في الحوض فإن كان صغيرا فهو قياس الأواني والجباب يتنجس، والأصل فيه الحديث «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا»، وإن كان الحوض كبيرا فهو قياس البحر لا يتنجس) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته». والفصل بين الصغير، والكبير يعرف بالخلوص فإذا كان بحال لو ألقى فيه الصبغ يظهر أثره في الجانب الآخر فهو صغير؛ لأنا علمنا أن النجاسة تخلص إلى الجانب الآخر كما خلص اللون هكذا حكي عن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير - رحمه الله تعالى -، والمذهب الظاهر في تفسير الخلوص أنه إذا كان بحال لو حرك جانب منه يتحرك الجانب الآخر فهو صغير، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر فهو كبير. وصفة التحريك المروي فيه عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه اعتبر تحريك المتوضئ وأبو يوسف - رحمه الله - اعتبر تحريك 
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 71 الى صـــ 80 (8) المنغمس فرواية أبي حنيفة، أوسع، ثم قال بعض مشايخنا في الحوض الكبير أنه لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه؛ لأنه كالماء الجاري، والأصح أن الموضع الذي وقع فيه النجاسة يتنجس، وإليه أشار في الكتاب، وقال لا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى، ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير، ثم يتوضأ؛ لأن النجاسة لا تخلص إلى ما وراء ذلك هو مفسر في الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وعلى هذا قالوا: من استنجى في موضع من حوض لا يجزئه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء. وأما التقدير بالمساحة فقد قال أبو عصمة كان محمد - رحمه الله تعالى - يقدر في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقال: لا أقدر فيه شيئا، والمشهور عن محمد - رحمه الله - أنه لما سئل عن هذا فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو كبير فلما قام مسحوا مسجده فروي أنه كان ثمانيا في ثمان، وروي أنه اثنا عشر في اثني عشر فكان من روى ثمانيا في ثمان مسح المسجد من داخل، ومن روى اثني عشر مسحه من خارج، ولا عبرة بعمق الماء حتى قالوا إذا كان بحيث لا ينحسر بالاغتراف فهذا القدر يكفي. هذا كله في بيان مذهبنا (وقال الشافعي) إذا كان الماء بقدر القلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه حتى يتغير أحد أوصافه، والقلة اسم لجرة تحمل من اليمن تسع فيها قربتين وشيئا فالقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين، وخمسين منا. واستدل بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا» (قلنا) هذا ضعيف فقد قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتابه بلغني بإسناد لم يحضرني من ذكره «إذا بلغ الماء قلتين» الحديث، ومثل هذا دون المرسل، ثم قيل معناه ليس لهذا القدر من القوة ما يحتمل النجاسة فيتنجس به كما يقال: مال فلان لا يحتمل السرف لقلته. وقد تكلم الناس في القلة فقيل إنها القامة، وقيل إنه رأس الجبل فيكون معناه إذا بلغ ماء الوادي قامتين، أو رأس الجبلين، ومثل هذا يكون معناه بحرا، وبه نقول (وكان) مالك - رحمه الله تعالى - يقول القليل، والكثير سواء لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه، وقد بينا مذهبه. قال (ويتوضأ الرجل من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر، ولا يستيقنه قبل أن يسأل عنه) ؛ لأن الأصل في الماء الطهارة فعليه التمسك به حتى يتبين له غيره، وخوفه بناء على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وليس عليه أن يسأل عنه؛ لأن السؤال للحاجة عند عدم الدليل، وأصل الطهارة دليل مطلق له الاستعمال فلا حاجة إلى السؤال. (ألا ترى) أن ابن عمر - رضي الله عنه - أنكر على عمرو بن العاص سؤاله بقوله يا صاحب الحوض بقوله لا تخبرنا، وكذلك إن أنتن من غير أن يكون فيه جيفة لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى على بئر رومة فوجد ماءها منتنا فأخذه بفيه، ثم مجه في البئر فعاد الماء طيبا»، ولأن تغير اللون قد يكون بوقوع الطاهر كالأوراق، وغيرها، وتغير الرائحة يكون بطول المكث كما قيل الماء إذا سكن منتنه تحرك نتنه، وإذا طال مكثه ظهر خبثه فلا يزول أصل الطهارة بهذا المحتمل فلهذا لا ندع التوضؤ به. قال (وإذا نسي المتوضئ مسح رأسه فأصابه ماء المطر مقدار ثلاثة أصابع فمسحه بيده، أو لم يمسحه أجزأه عن مسح الرأس) ، وكذلك الجنب إذا وقف في المطر الشديد حتى غسله، وقد أنقى فرجه، وتمضمض، واستنشق، وكذلك المحدث إذا جرى الماء على أعضاء وضوئه؛ لأن الماء مطهر بنفسه قال الله تعالى {، وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] ، والطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره فلا يتوقف حصول التطهر به على فعل يكون منه كالنار فإنه لا يتوقف حصول الاحتراق بها على فعل يكون من العبد، وإذا ثبت هذا في المغسول ثبت في الممسوح بطريق الأولى؛ لأنه دون المغسول، والمعتبر فيه إصابة البلة، وعلى هذا الأصل قلنا بجواز الوضوء، والغسل من الجنابة بدون النية. (وقال الشافعي - رحمه الله -): لا يجوز إلا بالنية لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى»، ولأنها طهارة هي عبادة فلا تتأدى بدون النية كالتيمم، وهذا؛ لأن معنى العبادة لا يتحقق إلا بقصد، وعزيمة من العبد بخلاف غسل النجاسة فإنه ليس بعبادة. (ولنا) آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل، والمسح، وذلك يتحقق بدون النية فاشتراط النية يكون زيادة على النص إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس بخلاف التيمم فإنه عبارة عن القصد لغة قال الله تعالى {، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية فيه، ولأنها طهارة بالماء فكانت كغسل النجاسة، وتأثير ما قلنا أن الماء مطهر في نفسه، والحدث الحكمي دون النجاسة العينية فإذا عمل الماء في إزالة النجاسة العينية بدون النية ففي إزالة الحدث الحكمي أولى، ونحن نسلم أن الوضوء بغير نية لا يكون عبادة، ولكن معنى العبادة فيها تبع غير مقصود إنما المقصود إزالة الحدث، وزوال الحدث يحصل باستعمال الماء فوجد شرط جواز الصلاة، وهو القيام إليها طاهرا بين يدي الله تعالى فيجوز كما لو لم يكن محدثا في الابتداء، وبه نجيب عن استدلاله بالحديث فإن المراد أن ثواب العمل بحسب النية، وبه نقول، وعن التيمم فإن التراب غير مزيل للحدث أصلا، ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثا بالحدث السابق فلم يبق فيه إلا معنى التعبد، وذلك لا يحصل بدون النية. يوضح الفرق أن النية تقترن بالفعل، ولا بد من الفعل في التيمم حتى إذا أصاب الغبار وجهه، وذراعيه لا يجزئه عن التيمم. وفي الوضوء، والاغتسال لا معتبر بالفعل حتى إذا سال ماء المطر على أعضائه زال به الحدث فكذلك بدون النية. قال (ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء، والغسل) لحديث قيس بن سعد - رضي الله تعالى عنه - قال «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم شديد الحر فوضعنا له ماء فاغتسل، والتحف بملحفة ورسية حتى أثر الورس في عكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، ولأنه لا بأس بأن يلبس ثيابه فإن من اغتسل في ليلة باردة لا يأمره أحد بالمكث عريانا حتى يجف فلعله يموت قبله، ولا فرق بين التمسح بثيابه، أو بمنديل، ولأن المستعمل ما زايل العضو فأما البلة الباقية غير مستعملة حتى لو جف كان طاهرا فلا بأس بأن يمسح ذلك بالمنديل. قال (ولا بأس للجنب أن ينام، أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ) لحديث الأسود عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصيب من أهله، ثم ينام من غير أن يمس ماء فإذا انتبه ربما عاود، وربما قام فاغتسل»، وفي حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد فكنا نتحدث بذلك فيما بيننا، ونقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطي قوة أربعين رجلا». قال (وإن توضأ قبل أن ينام فهو أفضل) لحديث عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصاب من أهله فتوضأ، ثم نام»، وهذا؛ لأن الاغتسال، والوضوء محتاج إليه للصلاة لا للنوم، والمعاودة إلا أنه إذا توضأ ازداد نظافة فكان أفضل. (فإن أراد أن يأكل فالمستحب له أن يغسل يديه، ويتمضمض، ثم يأكل) لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجنب أيأكل، ويشرب قال نعم إذا توضأ»، والمراد غسل اليد؛ لأن يده لا تخلو عن نجاسة عادة فالمستحب إزالتها بالماء، وكذلك لو لم يتوضأ حتى شرب كان من وجه شاربا للماء المستعمل فإن ترك ذلك لم يضره؛ لأن طهارة يده أصل، وفي النجاسة شك. قال (وإن كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء مسح عليها) ، والأصل فيه ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شج وجهه يوم أحد فداواه بعظم بال، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة»، «ولما كسرت إحدى زندي علي - رضي الله تعالى عنه - يوم حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي - صلى الله عليه وسلم - اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها». والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار، أو بارد فعليه أن يغسله، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه؛ لأن الغسل أقوى من المسح، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح، وإن كان لا يضره المسح مسح عليها؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح، وهو لا يضره قال في الأصل - لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يجزئه، وقيل هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما. وجه قولهما أنه لو ترك الغسل، وهو لا يضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قال لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه، وبه فارق الخف. قال (وإن مسح على الجبائر، ثم دخل في الصلاة، ثم سقطت الجبائر عنه مضى على صلاته) ، وهذا إذا كان سقوطها عن غير برء فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع، واستقبال الصلاة لزوال العذر فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية، ولهذا لا يتوقف بخلاف المسح بالخف. قال (وإن كانت الجراحة في جانب رأسه لم يجزه إلا أن يمسح على الجانب الآخر مقدار المسح) ؛ لأن المفروض من المسح مقدار ربع الرأس، وقد وجد هذا القدر من المحل صحيحا فلا حاجة به إلى المسح على الجبائر، والعراقيون يقولون في مثل هذا: إن ذهب عير فعير في الرباط. قال (وإذا قلس أقل من ملء فيه فلا وضوء عليه) إلا على قول زفر - رحمه الله تعالى - فإنه يقول ثبت من أصلنا أن القلس حدث فلا فرق بين قليله، وكثيره كالخارج من السبيلين. (ولنا) قول علي - رضي الله تعالى عنه - حين عد الأحداث فقال أو دسعة تملأ الفم، ولأن القياس أن القلس لا يكون حدثا؛ لأن الحدث خارج نجس بقوة نفسه، والقلس مخرج لا خارج فإن من طبع الأشياء السيالة أنها لا تسيل من فوق إلى فوق إلا بدافع دفعها، أو جاذب جذبها فهو كالدم إذا ظهر على رأس الجرح فمسحه، ولكنا تركنا القياس عند ملء الفم - بالآثار فبقي ما دونه على أصل القياس، ولأن في القليل منه بلوى فإن من يملأ من الطعام إذا ركع في الصلاة يعلو شيء إلى حلقه فللبلوى جعلنا القليل عفوا، والدليل عليه إذا تجشأ لم ينتقض وضوءه، وهو لا يخلو عن قليل شيء، ولهذا خبث ريحه، وبهذا فارق الخارج من السبيلين فإن الفساء جعل حدثا، وحد ملء الفم أن يعمه، أو يمنعه من الكلام، وقيل أن يزيد على نصف الفم، وعلى هذا حكاية عابد ببلخ يقال علي بن يونس أن ابنته سألته فقالت إن خرج من حلقي شيء فقال لها إذا وجدت طعمه في حلقك فأعيدي الوضوء، ثم رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقال لا يا علي حتى يملأ الفم فجعلت على نفسي أن لا أفتي بعد هذا أبدا. (فإن قاء ملء الفم مرة، أو طعاما، أو ماء فعليه الوضوء) لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم»، وعلى قول الشافعي القيء ليس بحدث بناء على قوله في الخارج من غير السبيلين على ما نبينه، وقال الحسن - رحمه الله تعالى - إذا شرب الماء، وقاء من ساعته لا يخالطه شيء لا ينتقض وضوءه، وجعله قياس خروج الدمع، والعرق، والبزاق، وهذا فاسد فإنه بالوصول إلى المعدة يتنجس فإنما يخرج، وهو نجس فكان كالمرة، والطعام سواء. (وإن قاء بلغما، أو بزاقا لم ينتقض وضوءه) أما البزاق طاهر، وبخروج الطاهر من البدن لا ينتقض الوضوء، والبلغم كذلك في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - هو نجس ينقض الوضوء إذا ملأ الفم قيل إنما أجاب أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فيما يعلو من جوفه، وهما فيما ينحدر من رأسه. وهذا ضعيف فالمنحدر من رأسه طاهر بالاتفاق سواء خرج من جانب الفم، أو الأنف؛ لأن الرأس ليس بموضع للنجاسات، وإنما الخلاف فيما يعلو من الجوف فأبو يوسف - رحمه الله - يقول: البلغم إحدى الطبائع الأربعة فكان نجسا كالمرة، والصفراء، ولأن خروجه من موضع النجاسات فكان نجسا بالمجاورة وأبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا: البلغم بزاق، والبزاق طاهر. ومعنى هذا أن الرطوبة في أعلى الحلق ترق فتكون بزاقا، وفي أسفله تثخن فيكون بلغما، وبهذا تبين أن خروجه ليس من المعدة بل من أسفل الحلق، وهو ليس بموضع للنجاسة فالبلغم هو النخامة «، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعمار - رضي الله تعالى عنه - ما نخامتك، ودموع عينك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء». (قال)، وإن قاء دما فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ينتقض وضوءه بقليله، وكثيره، وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا ينتقض وضوءه حتى يملأ الفم؛ لأنه أحد أنواع القيء فيعتبر بسائر الأنواع، واحتجا بأن المعدة ليس بموضع الدم فخروج الدم من فرجه في الجوف فإذا سال بقوة نفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير كان ناقضا للوضوء كالسائل من جرح في الظاهر (وروى) الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال هذا إذا قاء دما رقيقا فإن كان شبه العلق لم ينتقض الوضوء حتى يملأ الفم؛ لأنه ليس بدم في الحقيقة إنما هو سوداء محترق. قال (وإن خرج من جرحه دم، أو صديد، أو قيح فسال عن رأس الجرح نقض الوضوء عندنا) ، وهو قول علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما -، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا ينتقض الوضوء، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهما -، واحتج الشافعي - رحمه الله تعالى - بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء إلا من حدث، قيل وما الحدث؟ قال: صوت، أو ريح»، وهذا إشارة إلى موضع الحدث لا عينيه فدل أن الحدث ما يكون من السبيل المعتاد، والمعنى فيه أن قليل الخارج من غير السبيل ليس بحدث بالاتفاق، وما يكون حدثا فالقليل منه، والكثير سواء كالخارج من السبيل، والدليل عليه الريح إذا خرج من الجرح لم يكن حدثا بخلاف ما إذا خرج من السبيل، وهذا؛ لأن الشرع أقام المخرج مقام الخارج في ثبوت حكم الحدث فما لا يخرج منه إلا النجاسة جعل الخارج منه حدثا، ونجسا، وما يختلف الخارج منه لم يكن حدثا، وإن خرج منه ما هو نجس تيسيرا للأمر. (ولنا) حديث زيد بن علي - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الوضوء من كل دم سائل»، وقال سلمان - رضي الله تعالى عنه - «مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدم يسيل من أنفي فقال أحدث لما حدث بك وضوء»، والمعنى فيه أنه خارج نجس، وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير فكان حدثا كالخارج من السبيل، وهذا؛ لأن الحكم للخارج دون المخرج حتى الواجب باختلاف الخارج فخروج المني يوجب الغسل، وخروج المذي يوجب الوضوء، والمخرج واحد، وهو بخلاف القليل الذي لم يسل؛ لأنه ما صار خارجا إنما تقشر عنه الجلد فظهر ما هو في موضعه، والشيء لا يعطى له حكم النجاسة، وفي السبيل، وإن قل ما ظهر فقد فارق مكانه، وكذلك الريح إذا خرج من السبيل، ومعه قليل شيء، وذلك كاف في انتقاض الطهارة بخلاف الخارج من غير السبيل. يقرر ما قلنا أنه وجب عليه غسل ذلك الموضع لمعنى من بدنه فيكون حدثا كالخارج من السبيل بخلاف ما إذا لم يسل فإنه لم يلزمه غسل ذلك الموضع، وبخلاف ما إذا أصابته نجاسة؛ لأن وجوب غسله لم يكن لمعنى من بدنه فلا تتغير صفة طهارة بدنه، ثم حاصل المذهب أن الدم سال بقوة نفسه حتى انحدر انتقض به الوضوء، وإن لم ينحدر، ولكنه علا فصار أكثر من رأس الجرح لم تنتقض به الطهارة إلا في رواية شاذة عن محمد - رحمه الله تعالى - فإنه إن مسحه قبل أن يسيل فإن كان بحال لو ترك لسال فعليه الوضوء، وإن كان بحال لو تركه لم يسل فلا وضوء عليه لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال في الدم إذ سال عن رأس الجرح فهو حدث، وإلا فلا. قال (فإن بزق فخرج من بزاقه دم فإن كان البزاق هو الغالب فلا وضوء عليه) ؛ لأن الدم ما خرج بقوة نفسه، وإنما أخرجه البزاق، والحكم للغالب (وإن كان الدم هو الغالب فعليه الوضوء) ؛ لأنه خارج بقوة نفسه. وإن كانا سواء ففي القياس لا وضوء عليه؛ لأنه تيقن بصفة الطهارة، وهو في شك من الحدث، ولكنه استحسن فقال البزاق سائل بقوة نفسه فما ساواه يكون سائلا بقوة نفسه أيضا. ثم اعتبار أحد الجانبين يوجب الوضوء، واعتبار الجانب الآخر لا يوجب الوضوء فالأخذ بالاحتياط أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما اجتمع الحلال، والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال». وفي الكتاب قال أحب إلي أن يعيد الوضوء، وهو إشارة إلى أنه غير واجب، وهو اختيار محمد بن إبراهيم الميداني - رحمه الله تعالى -، وأكثر المشايخ على أنه يجب الوضوء لما بينا. قال (والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، والتبسم لا ينقضه) أما التبسم فلحديث جرير بن عبد الله البجلي قال «ما رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تبسم، ولو في الصلاة»، وروي «أنه - صلى الله عليه وسلم - تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل - عليه الصلاة والسلام - فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا» فدل أن التبسم لا يضر المصلي فأما القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء قياسا، وهو قول الشافعي - رحمه الله -؛ لأن انتقاض الوضوء يكون بالخارج النجس، ولم يوجد، ولو كان هذا حدثا لم يفترق الحال فيه بين الصلاة، وغيرها كسائر الأحداث، وقاس بالقهقهة في صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، واستحسن علماؤنا - رحمهم الله - لحديث زيد بن خالد الجهني قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه - رضوان الله عليهم - إذ أقبل أعمى فوقع في بئر، أو ركية هناك فضحك بعض القوم فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته قال من ضحك منكم فليعد الوضوء، والصلاة». وفي حديث جابر - رضي الله عنه - قال قال قال (ولا ينقض النوم الوضوء ما دام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، وينقضه مضطجعا، أو متكئا، أو على إحدى أليتيه) أما نوم المضطجع ناقض للوضوء، وفيه وجهان: أحدهما أن عينه حدث بالسنة المروية فيه؛ لأن كونه طاهرا ثابت بيقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وخروج شيء منه ليس بيقين فعرفنا أن عينه حدث، والثاني، وهو: أن الحدث ما لا يخلو عنه النائم عادة فيجعل كالموجود حكما فإن نوم المضطجع يستحكم فتسترخي مفاصله، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله «العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء». وهو ثابت عادة كالمتيقن به، وكان أبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - يقول: لا ينتقض الوضوء بالنوم مضطجعا حتى يعلم بخروج شيء منه، وكان إذا نام أجلس عنده من يحفظه فإذا انتبه سأله فإن أخبر بظهور شيء منه أعاد الوضوء، والمتكئ كالمضطجع؛ لأن مقعده زائل عن الأرض فأما القاعد إذا نام لم ينتقض وضوءه، وقال مالك - رحمه الله - إن طال النوم قاعدا انتقض وضوءه، وحجتنا حديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال «نمت قاعدا في المسجد حتى وقع ذقني على صدري فوجدت برد كف على ظهري فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت أعلي في هذا وضوء؟ فقال: لا حتى تضطجع»، ولأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شيء منه فلا ينتقض وضوءه كما لو لم يطل نومه. فأما إذا نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا لم ينتقض وضوءه عندنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - ينتقض وضوءه لحديث صفوان بن عسال المرادي قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليها إلا من جنابة لكن من بول، أو غائط، أو نوم» فهذا دليل على أن النوم حدث إلا أنا خصصنا نوم القاعد من هذا العموم بدليل الإجماع فبقي ما سواه على أصل القياس، ولأن مقعده زائل عن الأرض في حال نومه فهو كالمضطجع. (ولنا) حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء على من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله»، وهو المعنى فإن الاستمساك باق مع النوم في هذه الأحوال بدليل أنه لم يسقط، وبقاء الاستمساك يؤمنه من خروج شيء منه فهو كالقاعد بخلاف المضطجع، وعن أبي يوسف - رحمه الله - قال إذا تعمد النوم في السجود انتقض وضوءه، وإن غلبته عيناه لم ينتقض؛ لأن القياس في نوم الساجد أنه حدث كنوم المضطجع، ومن الناس من يعتاد النوم على وجهه. تركنا القياس للبلوى فيه للمجتهدين، وهذا إذا غلبته عيناه لا إذا تعمد، وجه ظاهر الرواية ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى به ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي، وجسده في طاعتي»، وإنما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه، ولأن الاستمساك باق فإنه لو زال لسقط على أحد شقيه، وذكر ابن شجاع عن محمد - رحمه الله تعالى - أن نوم القائم، والراكع، والساجد إنما لا يكون حدثا إذا كان في الصلاة فأما خارج الصلاة يكون حدثا، وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما لبقاء الاستمساك فإن كان القاعد مستندا إلى شيء فنام قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - إن كان بحال لو أزيل سنده عنه يسقط انتقض وضوءه لزوال الاستمساك، والمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا ينتقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شيء منه. فإن نام قاعدا فسقط، روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال إن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لم ينتقض وضوءه؛ لأنه لم يوجد شيء من النوم، وهو الحدث، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال ينتقض وضوءه لزوال الاستمساك بالنوم حين سقط، وعن محمد - رحمه الله تعالى - إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وضوءه، وإن زايل مقعده الأرض قبل أن ينتبه انتقض وضوءه. قال (ولا ينقض الكلام الفاحش الوضوء) لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - الوضوء مما خرج يعني الخارج النجس، ولأنه لا كلام أفحش من الردة، والمتوضئ إذا ارتد - نعوذ بالله -، ثم أسلم فهو على وضوئه، والذي روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت للمتسابين: إن بعض ما أنتم فيه شر من الحدث فجددوا الوضوء إنما أمرت به استحسانا ليكون الوضوء على الوضوء مكفرا لذنوبهما. قال (ولا وضوء في شيء من الأطعمة ما مسته النار، وما لم تمسه فيه سواء) وأصحاب الظواهر يوجبون الوضوء مما مسته النار، ومنهم من أوجب من لحم الإبل خاصة لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «توضئوا مما مسته النار»، وفي حديث آخر «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم». (ولنا) حديث أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ»، وقال جابر «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ قام ليخرج فرأى عرقا أي عظما في يد بعض صبيانه فأكل منه، ثم صلى، ولم يتوضأ»، وحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ضعيف قد رده ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقال: ألسنا نتوضأ بالحميم، ولو ثبت فالمراد منه غسل اليد بدليل حديث عكراش بن ذؤيب قال «أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني بيت أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - فأتينا بقصعة كثيرة الثريد، والودك فجعلت آكل من كل جانب فقال - صلى الله عليه وسلم - كل مما يليك فإن الطعام واحد، ثم أتينا بطبق من رطب فجعلت آكل مما يليني فقال: أجل يدك فإن الرطب ألوان، ثم أتي بماء فغسل يديه، وقال: هذا هو الوضوء مما مسته النار»، ولهذا فصل في روايته بين لحم الإبل، وغيره؛ لأن للحم الإبل من اللزوجة ما ليس لغيره، والمعنى أنه لو أكل الطعام نيئا لم يلزمه الوضوء فالنار لا تزيده إلا نظافة. قال (، ويخلل لحيته، وأصابعه في الوضوء) فإن لم يخلل لحيته أجزأه، وأما تخليل الأصابع سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «خللوا أصابعكم حتى لا يتخللها نار جهنم»، وأما اللحية فقد روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - أن مواضع الوضوء ما ظهر منها، وخلال الشعر ليس من مواضع الوضوء، وهذا إشارة إلى أنه يلزمه إمرار الماء على ظاهر لحيته، ووجهه أن البشرة التي استترت بالشعر كان يجب إمرار الماء عليها قبل نبات الشعر فإذا استترت بالشعر يتحول الحكم إلى ما هو الظاهر، وهو الشعر، وعن أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله تعالى - قالا: إن مسح من لحيته ثلثا، أو ربعا أجزأه، ووجهه أن الاستيعاب في الممسوح ليس بشرط كما في المسح بالرأس، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال إن ترك مسح اللحية أجزأه؛ لأنه لا يجتمع في عضو واحد غسل، ومسح، وغسل الوجه فرض فلا يجب المسح فيه، واللحية من جملة الوجه فأما تخليل اللحية فقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في شرح الآثار أنه بالخيار إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل فلم يعده من سنن الوضوء كما أشار إليه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأنه باطن لا يبدو للناظر، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - التخليل سنة لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يخلل إذا توضأ، وقال أنس - رضي الله تعالى عنه - «رأيت أصابع رسول - صلى الله عليه وسلم - في لحيته كأنها أسنان المشط، وقال نزل علي جبريل صلوات الله عليه فأمرني أن أخلل لحيتي إذا توضأت». 
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 81 الى صـــ 90 (9) قال (وإذا حت النجاسة عن الثوب لم يجزه إلا في المني اليابس خاصة) ؛ لأن الثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه فلا يخرجه إلا الماء فأما الحت يزيل ما على ظاهره دون ما يتداخل في أجزائه فأما المني فالكلام فيه في فصلين. أحدهما أنه نجس عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله - طاهر لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال المني كالمخاط فأمطه عنك، ولو بإذخرة، ولأنه أصل لخلقة الآدمي فكان طاهرا كالتراب لاستحالة أن يقال: إن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - خلقوا من شيء نجس، وهذا؛ لأن المستحيل من غذاء الحيوان إنما يكون نجسا إذا كان يستحيل إلى نتن، وفساد، والمني غير مستحيل إلى فساد، ونتن فهو كاللبن، والبيضة. (ولنا) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار بن ياسر «إنما يغسل الثوب من خمس من البول، والغائط، والخمر، والدم، والمني»، ولأنه خارج من البدن يجب الاغتسال بخروجه فكان نجسا كدم الحيض، وخروجه من مكان النجاسات فلا بد أن يتنجس بالمجاورة، وإن يكن نجسا في نفسه، وكونه أصل خلقة الآدمي لا ينفي صفة النجاسة عنه كالعلقة، والمضغة، وإن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - شبهه بالمخاط في المنظر لا في الحكم، وأمر بالإماطة ليتمكن من غسله فإن قبل الإماطة تنتشر النجاسة في الثوب إذا أصابه الماء، والفصل الثاني أنه ما دام رطبا لا يطهر إلا بالغسل فإن جف فحته، وفرك الثوب القياس أن لا يطهر؛ لأنه دم إلا أنه نضيج فهو كسائر أنواع الدم لا يطهر إلا بالغسل. استحسن علماؤنا - رحمهم الله تعالى - فقالوا يطهر بالفرك لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي الله تعالى عنها - في المني إذا رأيته رطبا فاغسليه، وإذا رأيته يابسا فافركيه». «، وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يصلي»، ولأن جرم المني لا يتداخل في أجزاء الثوب بل هو على ظاهره يزول بالفرك فهو نظير سيف المجاهد، وسكين القصاب إذا مسحه بالتراب يطهر به، وقد روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في المني إذا أصاب البدن لا يطهر به إلا بالغسل؛ لأن لين البدن يمنع زوال أثره بالحت، وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - قال إذا كان المني غليظا فجف يطهر بالفرك، وإن كان رقيقا لا يطهر إلا بالغسل، وقال إذا أصاب المني ثوبا ذا طاقين فالطاق الأعلى يطهر بالفرك، والأسفل لا يطهر إلا بالغسل؛ لأنه إنما يصيبه البلة دون الجرم، وهذه مسألة مشكلة فإن الفحل لا يمني حتى يمذي، والمذي لا يطهر بالفرك إلا أنه جعل المذي في هذه الحالة مغلوبا مستهلكا بالمني فكان الحكم للمني دون المذي. قال (وإن أصابت النجاسة الخف، أو النعل فما دام رطبا لا يطهر إلا بالغسل) ؛ لأن المسح بالأرض لا يزيله إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال إذا مسح بالأرض حتى لم تبق عين النجاسة، ولا رائحتها يحكم بطهارة الخف، واعتبر البلوى فيه للناس، وإن كان يابسا فهو على وجهين إما أن لا يكون للنجاسة جرم كالبول، والخمر فلا يطهر إلا بالغسل؛ لأن البلة تداخلت في أجزاء الخف، وليس على ظاهره جرم حتى يزول بالمسح بالأرض فأما إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة، والروث فمسحه بالأرض ففي القياس لا يطهر إلا بالغسل، وهو قول محمد وزفر - رحمهما الله تعالى -؛ لأن النجاسة تداخلت في أجزاء الخف ألا ترى أنها بعد الجفاف تبقى متصلة بالخف فلا يطهرها إلا الغسل كما إذا أصابت الثوب، أو البساط استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - فقالا يطهر بالمسح بالأرض لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في صلاته فخلع الناس نعالهم فلما فرغ من صلاته قال أتاني جبريل صلوات الله عليه، وأخبرني أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما قذرا فليمسحه بالأرض» «، وقالت أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - يا رسول الله إني ربما أمشي على مكان نجس، ثم على مكان طاهر فقال الأرض يطهر بعضها بعضا»، والمعنى فيه أن للجلد صلابة تمنع دخول أجزاء النجاسة في باطنه، ولهذه النجاسة جرم ينشف البلة المتداخلة إذا جف فإذا مسحه بالأرض فقد زال عين النجاسة فيحكم بطهارة الجلد كما كان عليه قبل الإصابة بخلاف الثوب، أو البساط فإنه رقيق تتداخل أجزاء النجاسة في باطنه فلا يخرجه إلا الماء فإن الماء للطافته يتداخل في أجزاء الثوب فيخرج النجاسة، ثم يخرج على أثرها بالعصر. قال (، ولا يجب عليه بتغميض الميت، وغسله، وحمله وضوء، ولا غسل إلا أن يصيب يده، أو جسده شيء فيغسله) لقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - الوضوء مما خرج، ولأن الميت المسلم طاهر، ومس الطاهر ليس بحدث، ولو كان نجسا فمس النجس ليس بحدث أيضا، والذي روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من غمض ميتا فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ» ضعيف قد رده ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقال أيلزمنا الوضوء بمس عيدان يابسة، ولو ثبت فالمراد من قوله «من غمض ميتا فليتوضأ» غسل اليد؛ لأن ذلك لا يخلو عن قذارة عادة، وقوله «من غسل ميتا فليغتسل» إذا أصابته الغسالات النجسة، وقوله «من حمل جنازة فليتوضأ» إذا كان محدثا ليتمكن من أداء الصلاة عليه. قال (، والحجامة توجب الوضوء، وغسل موضع المحجمة) ، وهو عندنا، وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يوجب موضع المحجمة، ولا يوجب الوضوء لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - اغسل موضع المحاجم، وحسبك. وعلماؤنا قالوا معناه: وحسبك من الاغتسال. فإن أصحاب علي - رضي الله تعالى عنه - كانوا يوجبون الاغتسال من ماء الحمام، وغسل الميت، والحجامة فابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال هذا ردا عليهم فأما الوضوء واجب بخروج النجس كما بينا فإن توضأ، ولم يغسل موضع المحجمة فإن كان أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة، وإن كان دون ذلك أجزأته، وعلى قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا تجزئه فإن القليل من النجاسة كالكثير عنده في المنع من جواز الصلاة. قال (وإن خرج من دبره دابة، أو ريح ينتقض وضوءه) ، والمراد بالدابة الدود، وهو لا يخلو عن قليل بلة تكون معه، وقد بينا أن فيما يخرج من الدبر القليل كالكثير في انتقاض الطهارة بخلاف ما إذا سقط الدود عن رأس الجرح فإنه لا يخلو عن بلة يسيرة، وذلك القدر من الخارج ليس بناقض للوضوء؛ لأنه غير سائل بقوة نفسه فأما الريح إذا خرج من الدبر كان ناقضا للوضوء لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه، ويقول: أحدثت أحدثت فلا ينصرفن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا». فإن خرج الريح من الذكر فقد روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه حدث؛ لأنه خرج من موضع النجاسة، وعامة مشايخنا يقولون هذا لا يكون حدثا، وإنما هو اختلاج فلا ينتقض به الوضوء، وكذلك إن خرج الريح من قبل المرأة قال الكرخي - رحمه الله تعالى: إنه لا يكون حدثا إلا أن تكون مفضاة يخرج منها ريح منتن فيستحب لها أن تتوضأ، ولا يلزمها ذلك؛ لأنا لا نتيقن بخروج الريح من موضع النجاسة. قال (وإن رعف قليلا لم يسل لم ينقض وضوءه) ، ومراده إذا كان فيما صلب من أنفه لم ينزل إلى ما لان منه فقد قال محمد - رحمه الله تعالى - في النوادر: إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف انتقض به الوضوء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر؛ لأن هناك النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف قد وصلت النجاسة إلى موضع يلحقه حكم التطهير فالاستنشاق في الجنابة فرض، وفي الوضوء سنة. قال (، ويتوضأ صاحب الجرح السائل لوقت كل صلاة، ويصلي بذلك ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في الوقت)، وأصل المسألة في المستحاضة فإن دم المستحاضة حدث عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - خلافا لمالك - رحمه الله تعالى - فإنه يقول: ما ليس بمعتاد من الخارج لا يكون حدثا. والدليل على أنه حدث قوله - صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»، ثم عندنا يلزمها الوضوء في كل وقت صلاة، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، ولها أن تصلي ما شاءت من النوافل بذلك، ولا تجمع بين الفرضين بوضوء واحد «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين استحيضت توضئي لكل صلاة»، ومطلقه يتناول المكتوبة، ولأن طهارتها طهارة ضرورية لاقتران الحدث بها، ويتجدد باعتبار كل مكتوبة ضرورة فيلزمها وضوء جديد فأما النوافل تبع للفرائض فثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع. (ولنا) حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة». ما روي «لكل صلاة» فالمراد منه الوقت فالصلاة تذكر بمعنى الوقت قال - صلى الله عليه وسلم - «إن للصلاة أولا، وآخرا» أي لوقت الصلاة، والرجل يقول لغيره: آتيك صلاة الظهر أي وقته، والمعنى فيه أن الأوقات مشروعة للتمكن من الأداء فيها فإن الناس في الأداء مختلفون فمن بين مطول، وموجز فشرع للأداء وقت يفصل عنه تيسيرا، وإذا قام الوقت مقام الصلاة لهذا فتجدد الضرورة يكون بتجدد الوقت، وما بقي الوقت يجعل الضرورة كالقائمة حكما تيسيرا عليها في إقامة الوقت مقام الفعل، وبعد ما فرغت من الأداء إن بقيت طهارتها فلها أن تصلي فرضا آخر، وإن لم تبق طهارتها ليس لها أن تصلي النوافل؛ لأن الطهارة من شرطها. ثم انتقاض طهارتها بخروج الوقت عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله تعالى - وبدخول الوقت عند زفر - رحمه الله تعالى -، وبهما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، ويتبين هذا الخلاف فيما إذا توضأت في وقت الفجر فطلعت الشمس تنتقض طهارتها إلا على قول زفر - رحمه الله -، ولو توضأت في، وقت الضحوة فزالت الشمس لا تنتقض طهارتها إلا على قول أبي يوسف وزفر - رحمهما الله تعالى -، وهما يقولان طهارتها قبل وقوع الحاجة غير معتبر فبدخول الوقت تتجدد الحاجة لوجوب الأداء عليها فيلزمها به الطهارة. (ولنا) أن انتقاض طهارتها بوقوع الاستغناء عنها، وذلك بخروج الوقت، ثم صاحب الجرح السائل عندنا في معنى المستحاضة؛ لأن الخارج من غير السبيل حدث عندنا فيتوضأ لوقت كل صلاة، ولو قلنا بما قاله زفر - رحمه الله - لأدى إلى الحرج؛ لأنه إذا كان بيته بعيدا عن الجامع فلو انتظر للوضوء زوال الشمس فاتته الصلاة فلا يجد بدا من أن يتوضأ قبل الزوال. قال (وإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط فذلك لا يمنعه من أداء الصلاة ما بقي الوقت) «؛ لأن فاطمة بنت قيس - رضي الله تعالى عنها - لما قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أثج الدم ثجا قال احتشي، والتجمي، وصلي»، وإن قطر الدم على الحصير قطرا فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله، وهذا إذا كان مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى إذا لم يغسله، وصلى، وهو أكثر من قدر الدرهم لم يجزه إلا إذا لم يكن الغسل مفيدا بأن كان يصيبه ثانيا، وثالثا، وكان محمد بن مقاتل الرازي - رحمه الله - يقول: عليه غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة بالقياس على الوضوء، وغيره من مشايخنا يقول: لا يلزمه ذلك؛ لأن حكم الوضوء عرفناه بالنص، ونجاسة الثوب ليست في معنى الحدث حتى أن القليل منه يكون عفوا فلا يلحق به فإن سال الدم من موضع آخر أعاد الوضوء، وإن كان الوقت باقيا؛ لأن هذا حدث جديد، وتقدر طهارته بالوقت كان للحدث الموجود باعتبار تحقق الضرورة فما يتجدد من الحدث فهو كغيره. قال (ومن خاض ماء المطر إلى المسجد، أو داس الطين لم ينقض ذلك وضوءه) ؛ لأن انتقاض الوضوء بالخارج النجس من البدن، وروي أن عليا - رضي الله تعالى عنه - خرج يوما، والسماء تسكب فأخذ نعليه بيده، وخاض الماء حتى أتى المسجد فمسح قدميه، ودخل، وصلى، وهكذا روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - فتبين أنه لا وضوء عليه، ولا غسل القدمين بل يمسح قدميه، ويصلي هذا إذا كان التراب طاهرا فإن الطين النازل من السماء، والتراب الطاهر طاهر فأما إذا كان أحدهما إما الماء، وإما التراب نجسا فالطين نجس لا بد من غسله، وهو الصحيح من المذهب، وإنما مسح قدميه خارج المسجد كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد، وروي أن أبا حنيفة - رحمه الله - رأى رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد فقال له لو مسحته بلحيتك كان خيرا لك إلا أن يكون موضعا معدا لذلك في المسجد فحينئذ لا بأس به؛ لأن ذلك الموضع لا يصلى فيه عادة. قال (ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن) ؛ لأن غسله لا يريبه، وتركه يريبه. وقال - صلى الله عليه وسلم - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن تركه جاز؛ لأنه على يقين من الطهارة في ثوبه، وفي شك من حقيقة النجاسة فإن كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله؛ لأن أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين قال - صلى الله عليه وسلم - «المؤمن ينظر بنور الله تعالى»، وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - يقول في بلدتنا لا بد من غسله؛ لأن الظاهر أنه إنما يراق البول، أو الماء النجس من السطوح. قال (وإن انتضح عليه من البول مثل رءوس الإبر لم يلزمه غسله) ؛ لأن فيه بلوى فإن من بال في يوم ريح لا بد أن يصيبه ذلك خصوصا في الصحاري، وقد بينا أن ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفوا. قال (ومن شك في بعض وضوئه، وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه) لأن غسله لا يريبه، ولأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع، وفي شك من غسله. ولم يرد بهذا اللفظ أنه لم يصبه قط مثل هذا إنما مراده أن الشك في مثله لم يصر عادة له حتى قال بعد ذلك فإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه؛ لأنه من الوساوس، والسبيل في الوساوس قطعها، وترك الالتفات إليها؛ لأنه لو اشتغل بها لم يتفرغ لأداء الصلاة فكلما قام إليها يبتلى بمثل هذا الشك. . قال (ومن شك في الحدث فهو على وضوئه، وإن كان محدثا فشك في الوضوء فهو على حدثه؛ لأن الشك لا يعارض اليقين، وما تيقن به لا يرتفع بالشك) ، وعن محمد - رحمه الله تعالى - قال المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها، أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها. وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء، ومعه الماء، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ، والبناء على الظاهر، واجب ما لم يعلم خلافه. قال (ومن توضأ، ثم رأى البلل سائلا عن ذكره أعاد الوضوء) ؛ لأن البول سال منه، وهو ناقض للوضوء، وإنما قال رآه سائلا؛ لأن مجرد البلة محتملة أن تكون من ماء الطهارة فإن علم أنه بول ظهر عليه فعليه الوضوء، وإن لم يكن سائلا، وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيرا، ولا يعلم أنه بول، أو ماء مضى على صلاته؛ لأنه من جملة الوساوس فلا يلتفت إليها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه، ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»، وفي الحديث «أن شيطانا يقال له الولهان لا شغل له إلا الوسوسة في الوضوء» فلا يلتفت إلى ذلك، وينبغي أن ينضح فرجه، وإزاره بالماء إذا توضأ قطعا لهذه الوسوسة حتى إذا أحس بشيء من ذلك أحاله على ذلك الماء، وقد روى أنس - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينضح إزاره بالماء إذا توضأ»، وفي بعض الروايات قال «نزل علي جبريل - عليه السلام -، وأمرني بذلك». . قال (وليس دم البق، والبراغيث بشيء لأنه ليس بدم سائل، ولا يستطاع الامتناع عنه) خصوصا في زمن الصيف في حق من ليس له إلا ثوب، واحد ينام فيه كما كان لأصحاب الصفة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك دم السمك ليس بشيء يعني ليس بنجس، وقد بينا أنه ليس بدم حقيقة، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الكبار الذي يسيل منه دم كثير أنه نجس، ولا اعتماد على تلك الرواية، وأما دم الحلم فإن كان أكثر من قدر الدرهم أعاد ما صلى، وهو عليه؛ لأنه دم سائل، وقد روي «أن الأذى كان في نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خلع نعليه في الصلاة» كان دم حلم. قال (وإذا أراد أن يتوضأ بماء فأخبره بعض أنه قذر لم يتوضأ به) ؛ لأن خبر الواحد في أمر الدين حجة إذا كان المخبر ثقة حتى كان روايته الحديث موجبا للعمل فكذلك إخباره بنجاسة الماء من أمر الدين فيجب العمل بخبره. قال (وإذا أدخل الصبي يده في كوز ماء، ولا يعلم على يده قذر فالمستحب أن لا يتوضأ به) ؛ لأنه لا يتوقى النجاسات عادة فالظاهر أن يده لا تخلو عن نجاسة فالاحتياط في التوضؤ بغيره، وإن توضأ به أجزأه؛ لأنه على يقين من الطهارة، وفي شك من النجاسة، وحاله كحال الدجاجة المخلاة، وقد بينا سؤرها. قال (ولا بأس بالتوضؤ من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم أنه قذر) ؛ لأنه عمل الناس، ويلحقهم الحرج في النزوع عن هذه العادة، والأصل فيه الطهارة فيتمسك به ما لم يعلم بالنجاسة، وفي الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع استسقى العباس - رضي الله تعالى عنه - فقال ألا نأتيك بالماء من بعض البيوت فإن الناس يدخلون أيديهم في ماء السقاية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - نحن منهم». قال (وإذا وقع بعر الغنم، أو الإبل في البئر لم يضره ما لم يكن كثيرا فاحشا) ، وفي القياس يتنجس البئر؛ لأنه بمنزلة الإناء يخلص بعضه إلى بعض فيتنجس بوقوع النجاسة فيه، ولكنا استحسنا، وقلنا بأنه لا ينجس للبلوى فيه فإن عامة الآبار في الفيافي، والمواشي تبعر حولها، ثم الريح تسفي به فتلقيه في البئر فلو حكمنا بنجاسته كان فيه انقطاع السبل، والرسل، ولكن هذه الرخصة في القليل دون الكثير، وإذا كان كثيرا فاحشا أخذنا فيه بالقياس فقلنا عليهم أن ينزحوا ماء البئر كله، والكثير ما استكثره الناظر إليه، وقيل أن يغطي ربع وجه الماء، وقيل أن لا تخلو دلو عن بعرة، وهو صحيح، وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في الإملاء قال هذا إذا كان يابسا فإن كان رطبا تفسد البئر بقليله، وكثيره، ثم قال؛ لأن الرطب ثقيل لا يسفي به الريح، ولأنه ليس للرطب من الصلابة، والاستمساك ما لليابس، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنهما سواء؛ لأن اليابس بالوقوع في البئر يصير رطبا، وما على الرطب من الرطوبة رطوبة الأمعاء، وهذا كله في غير المتفتت فإن كان متفتتا، فقليله وكثيره سواء؛ لأن الماء يدخل في أجزائه فيتنجس، ثم يخرج، وهو نجاسة مائعة، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه استحسن في القليل من المتفتت؛ لأن البلوى فيه قائمة. وأما السرقين فقليله، وكثيره سواء يفسد الماء رطبا كان، أو يابسا؛ لأنه ليس له من الصلابة كما للبعر، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال في تبنة، أو تبنتين من الأرواث تقع في البئر استحسن أنه لا يفسده، ولا أحفظه عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهو الأصح لقيام البلوى فيه حتى قال خلف بن أيوب لو حلب عنزا فبعرت في المحلب يرمي بالبعرة، ويحل شربه؛ لأن فيه بلوى فإن العنز لا يمكن أن تحلب من غير أن تبعر في المحلب. قال (ولا يتوضأ بشيء من الأشربة سوى الماء) إلا بنبيذ التمر عند عدم الماء أما نبيذ التمر ففي الأصل قال يتوضأ به عند عدم الماء، ولو تيمم مع ذلك أحب إلي، وفي الجامع الصغير قال يتوضأ به، ولا يتيمم، وقال محمد - رحمه الله - لا بد من الجمع بينه، وبين التيمم، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقال أبو يوسف يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى -. وروى نوح في الجامع عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه رجع إليه، واحتج أبو يوسف بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] ، وخبر نبيذ التمر كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة فانتسخ بها خبر نبيذ التمر؛ لأن نسخ السنة بالكتاب جائز، والقياس هكذا فإنه ليس بماء مطلق فلا يتوضأ به كسائر الأنبذة ترك أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - هذا القياس بحديث «ابن مسعود - رحمه الله تعالى - أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن فلما انصرف إليه عند الصباح قال أمعك ماء يا ابن مسعود قال لا إلا نبيذ تمر في إداوة فقال تمرة طيبة، وماء طهور، وأخذه، وتوضأ به»، وعن علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال نبيذ التمر طهور من لا يجد الماء، والقياس يترك بالسنة، وبقول الصحابي إذا كان فقيها فأما آية التيمم تتناول حال عدم الماء، وهذا ماء شرعا كما قال - صلى الله عليه وسلم - «، وماء طهور»، وإنما جمع بينهما محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأن الآية توجب التيمم، والخبر يوجب التوضؤ بالنبيذ فيجمع بينهما احتياطا، وإذا قلنا بالاحتياط في سؤر الحمار أنه يجمع بينه، وبين التيمم فها هنا أولى. وصفة نبيذ التمر الذي يجوز التوضؤ به أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء فإن كان ثخينا فهو كالرب لا يتوضأ به فإن كان مشتدا فهو حرام شربه فكيف يجوز التوضؤ به، وإن كان مطبوخا فالصحيح أنه لا يجوز التوضؤ به حلوا كان، أو مشتدا؛ لأن النار غيرته فهو كماء الباقلا فأما سائر الأنبذة فكان الأوزاعي - رحمه الله - يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر، وعندنا لا يجوز؛ لأن نبيذ التمر مخصوص من القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره، واختلف مشايخنا - رحمهم الله تعالى - في الاغتسال بنبيذ التمر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فمنهم من لم يجوزه؛ لأن الأثر في الوضوء خاصة، والأصح أنه يجوز؛ لأن المخصوص من القياس بالنص يلحق به ما في معناه من كل وجه. قال (، والإغماء ينقض الوضوء في الأحوال كلها) «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ في مرضه فلما أراد أن يقوم أغمي عليه فلما أفاق توضأ ثانيا»، ولأن الإغماء في غفلة المرء عن نفسه فوق النوم مضطجعا فإن هناك إذا نبه انتبه، وها هنا لا ينتبه، وكذلك يقطع الصلاة لو عرض في خلال الصلاة، ويمنع من البناء عليها؛ لأن البناء على الصلاة عند سبق الحدث مستحسن فيما تعم به البلوى، والإغماء ليس من هذا في شيء. وكذلك لو مات الإمام استقبل القوم الصلاة بإمام آخر؛ لأن عمله انقطع بموته قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»، وهذا ليس من جملتها، والبناء على المنقطع غير ممكن فلهذا استقبلوا. قال (وليس الغسل بواجب يوم الجمعة، ولكنه سنة) إلا على قول مالك - رحمه الله تعالى -، وحجته ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أو قال حق». (ولنا) حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من توضأ يوم الجمعة فبها، ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». ولما دخل عثمان - رضي الله تعالى عنه - المسجد يوم الجمعة وعمر - رضي الله عنه - يخطب فقال أية ساعة المجيء هذه، قال: ما زدت بعد أن سمعت النداء على أن توضأت فقال، والوضوء أيضا، وقد «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالاغتسال في هذا اليوم»، ثم لم يأمره بالانصراف فدل أنه ليس بواجب. وتأويل الحديث مروي عن عائشة وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قالا: كان الناس عمال أنفسهم، وكانوا يلبسون الصوف، ويعرقون فيه، والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة البعض فأمروا بالاغتسال لهذا، ثم انتسخ هذا حين لبسوا غير الصوف، وتركوا العمل بأيديهم، واختلف أبو يوسف والحسن بن زياد - رحمهما الله تعالى - أن الاغتسال يوم الجمعة لليوم أم للصلاة فقال الحسن - رحمه الله تعالى - لليوم، وإظهارا لفضيلته كما قال - صلى الله عليه وسلم - «سيد الأيام يوم الجمعة»، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - للصلاة؛ لأنها مؤداة بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها، وفائدة هذا الاختلاف فيما إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أحدث فتوضأ، وصلى الجمعة. عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يكون مقيما للسنة، وعند الحسن - رحمه الله - يكون والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعا. خمسة منها فريضة. الاغتسال من التقاء الختانين، ومن إنزال الماء، ومن الاحتلام، ومن الحيض، والنفاس، وأربعة منها سنة. الاغتسال يوم الجمعة، ويوم عرفة، وعند الإحرام، وفي العيدين. وواحد واجب، وهو غسل الميت، وآخر مستحب، وهو الكافر إذا أسلم فإنه يستحب له أن يغتسل به «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جاءه يريد الإسلام»، وهذا إذا لم يكن جنبا فإن أجنب، ولم يغتسل حتى أسلم فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع، والأصح أنه يلزمه؛ لأن بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء به، والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب البئر] قال (وإذا ماتت الفأرة في البئر ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراج الفأرة فعشرون واجب وثلاثون أحوط) وقد بينا هذا فيما مضى، وأصحاب الشافعي - رضي الله تعالى عنهم - يطعنون في هذا ويقولون: دلو يميز الماء النجس من الطاهر دلو كيس. وهذا طعن في السلف وقد بينا أن طهارة البئر بنزح بعض الدلاء قول السلف من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - ثم هم قالوا بالرأي ما هو أشد من هذا فقالوا في بئر فيها قلتان من الماء ماتت فيها فأرة فنزح منها دلو فإن حصلت الفأرة في الدلو فالماء الذي في الدلو نجس والذي بقي في البئر طاهر، وإن بقيت الفأرة في البئر فالماء الذي في الدلو طاهر والذي في البئر نجس فدلوهم هذا أكيس. قال (فإن نزح منها عشرون دلوا قبل إخراج الفأرة لم تطهر) ؛ لأن بقاء الفأرة فيها بعد النزح كابتداء الوقوع ولأن سبب نجاسة البئر حصول الفأرة الميتة فيها ولا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة. قال (فإن أخرجت الفأرة ثم نزح منها عشرون دلوا وهو يقطر فيها لم يضرها ذلك) لأن النزح على وجه لا يقطر شيء منه فيها متعذر وما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفوا لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] . قال (وإن صب الدلو الآخر في بئر أخرى فعليهم أن ينزحوا دلوا مثله كما لو صب في البئر الأولى) لأن حال البئر الثانية بعد ما حصل هذا الدلو فيها كحال البئر الأولى حين كان هذا الدلو فيها (وإن صب الدلو الأول منها في بئر طاهرة كان عليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا) لأن حال البئر الثانية بعد هذا الدلو فيها كحال البئر الأولى حين كان هذا الدلو فيها ولو صب دلو في بئر أخرى قبل إخراج الفأرة ينزح جميع ما في البئر الثانية كذا قاله أستاذنا - رضي الله تعالى عنه -، وكان الكرخي - رحمه الله تعالى - يقول: لا أعرف هذه المسائل إلا تقلدا فإن ماء الدلو نجس كماء الدلو الأول والفرق بينهما بطريق المعنى غير ممكن، وشبه هذا بالثوب إذا غسل ثلاثا فالماء الثالث في النجاسة كالماء الأول إذا أصاب ثوبا آخر نجسه، وكان الإمام الحاكم الشهيد - رحمه الله تعالى - يقول في مسألة الثوب على قياس مسألة البئر: إذا أصاب الماء الأول ثوبا لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا وإن أصابه الماء الثاني يطهر بالغسل مرتين وإن أصابه الماء الثالث يطهر بالغسل مرة والأصح الفرق بينهما فنقول: النجاسة في الثوب عينية وينجس الماء بحصول النجاسة فيه وفي هذا لا فرق بين الماء الأول والثالث، فأما تنجيس الماء فحكمي وطهارته بالنزح بغالب الرأي فكان ماء الدلو الأخير أخف من الماء الذي في الدلو الأول؛ لأن عند نزح الدلو الأول يتيقن بكون الماء النجس في البئر وهو ما جاوز الفأرة، وعند نزح الدلو الأخير لا يتيقن بذلك فلعل ما جاوز الفأرة الماء الذي نزح فيما سبق من الدلاء فهذا معنى قول محمد - رحمه الله تعالى - كلما نزح الماء كان أطهر للبئر فلهذا فرقنا بين الدلو الأول إذا صب في بئر أخرى وبين الدلو الأخير. 
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
 الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس) المجلد الاول صـــ 91 الى صـــ 100 (10) وإن صب الدلو الثاني فيها كان عليهم أن ينزحوا منها تسعة عشر دلوا؛ لأن حالها كحال البئر الأولى وإن صبوا الدلو العاشر فيها كان عليهم أن ينزحوا منها عشر دلاء هكذا ذكر في نسخ أبي سليمان - رحمه الله - وفي نسخ أبي حفص - رحمه الله - قال أحد عشر دلوا وهو الصواب فإن حال البئر الثانية بعد ما صب الدلو العاشر فيها كحال البئر الأولى حين كان هذا الدلو فيها، وتأويل ما ذكر في نسخ أبي سليمان أنه ينزح منها عشر دلاء سوى المصبوب فيها والمصبوب فيها واجب النزح بيقين وإن خرجت الفأرة فألقيت في البئر الثانية وصب فيها عشرون دلوا من البئر الأولى فعليهم إخراج الفأرة ونزح عشرين دلوا لما بينا أن حال البئر الثانية كحال البئر الأولى، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن عليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا سوى المصبوب فيها وجعل المصبوب فيها كالفأرة في البئر الأولى والأصح هو الأول؛ لأنا نتيقن أنه ليس في هذه البئر إلا نجاسة فأرة ونجاسة الفأرة يطهرها نزح عشرين دلوا. قال (وإذا خرجت الفأرة وجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلوا بدلوهم فاستقوا منها دلوا واحدا أجزأهم وقد طهرت البئر) لأن النجس ما جاوز الفأرة من الماء فلا فرق بين أن يؤخذ ذلك في دلو واحد أو في عشرين دلوا وكان الحسن بن زياد - رحمه الله تعالى - يقول لا يطهر بهذا النزح؛ لأن عند تكرار نزح الماء ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فيكون في حكم الجاري، وهذا لا يحصل بنزح دلو عظيم منها ونحن نقول لما قدر الشرع الدلاء بقدر خاص عرفنا أن المعتبر قدر المنزوح وأن معنى الجريان ساقط؛ لأن ذلك يحصل بدونه ويزداد بزيادته ولهذا قلنا لو نزحها عشرة أيام ونحوه يطهر لوجود القدر مع عدم الجريان ثم اللفظ المذكور في الكتاب يدل على أنه يعتبر في كل بئر دلو تلك البئر لقوله بدلوهم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن المعتبر دلو يسع فيه صاعا من الماء ليتمكن كل أحد من النزح به من رجل أو امرأة أو صبي. قال (ولو توضأ رجل من هذه البئر بعد ما نحى الدلو الأخير عن رأسها جاز وضوءه) ؛ لأنا حكمنا بطهارة البئر فإن صب ذلك الدلو فيها لم يفسد وضوء الرجل؛ لأن تنجيس البئر حصل الآن وإن كان الدلو بعد في البئر لم يفصل عن وجه الماء لا يجوز لأحد أن يتوضأ بذلك الماء وإن فصل الدلو عن وجه الماء وهو معلق في هواء البئر فتوضأ رجل منها لم يجزه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد - رحمه الله تعالى - أجزأه. وجه قوله أن الماء الطاهر تميز عن الماء النجس فكأنه نحي عن رأس البئر وكون الماء النجس معلقا في هواء البئر لا يكون أقوى من خمر أو بول في دلو معلق في هواء البئر فلا يحكم هناك بنجاسة البئر بهذا وإنما جعل التقاطر عفوا لأجل الضرورة كما بينا ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن الماء النجس متصل بماء البئر حكما بدليل أن التقاطر فيه يجعل عفوا ولولا الاتصال حكما لما جعل التقاطر عفوا كما في البول والخمر فصار بقاء الاتصال حكما كبقائه حقيقة ولو كان باقيا حقيقة بأن لم يفصل عن وجه الماء فلا يحكم بطهارة البئر، وهذا لأن البئر موضع الماء فأعلاه كأسفله كالمسجد لما كان موضع الصلاة جعل كله كمكان واحد في حكم الاقتداء قال (ولو غسل ثوب نجس في إجانة بماء نظيف ثم في أخرى ثم في أخرى فقد طهر الثوب) وهذا استحسان والقياس أن لا يطهر الثوب ولو غسل في عشر إجانات وبه قال بشر بن غياث. ووجهه أن الثوب النجس كلما حصل في الإجانة تنجس ذلك الماء فإنما غسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهر حتى يصب عليه الماء أو يغسل في الماء الجاري. وجه الاستحسان قوله - صلى الله عليه وسلم - «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا» فتبين بهذا الحديث أن الإناء النجس يطهر بالغسل من غير حاجة إلى تقوير أسفله ليجري الماء على النجاسة، والمعنى فيه أن الثياب النجسة يغسلها النساء والخدم عادة وقد يكون ثقيلا لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء عليه، والماء الجاري لا يوجد في كل مكان فلو لم يطهر بالغسل في الإجانات أدى إلى الحرج. ثم النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية، ثم المرئية لا بد من إزالة العين بالغسل، وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر هكذا «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك بقاء الأثر» ولأن المرأة إذا خضبت يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها ولا يضرها بقاء أثر الحناء، وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول بعد زوال عين النجاسة يغسل مرتين؛ لأنه التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة فأما النجاسة التي هي غير مرئية فإنها تغسل ثلاثا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» فلما أمر بالغسل ثلاثا في النجاسة الموهومة ففي النجاسة المحققة أولى وهذا مذهبنا وعلى قول الشافعي - رضي الله عنه - العبرة بغلبة الرأي فيما سوى ولوغ الكلب حتى إن غلب على ظنه أنه طهر بالمرة الواحدة يكفيه ذلك لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - ثم اغسليه فلا يشترط فيه العدد، ولكنا نقول غلبة الرأي في العام الغالب لا يحصل إلا بالغسل ثلاثا، وقد تختلف فيه قلوب الناس فأقمنا السبب الظاهر مقامه تيسيرا وهو الغسل ثلاثا. قال: وإن أصابت النجاسة عضوا من أعضائه فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - أخذ فيه بالقياس فقال لا يطهر بالغسل في الإجانات؛ لأن صب الماء عليه ممكن من غير حرج ولأن استعمال الماء في العضو في تغير صفة الماء أقوى منه في الثوب فإن العضو الطاهر إذا غسل بالماء الطاهر صار مستعملا بخلاف الثوب الطاهر فلا يمكن قياس العضو على الثوب ومحمد - رحمه الله تعالى - سوى بين الثوب والعضو في أنه يطهر بالغسل في الإجانات وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: لأن الضرورة تحققت في بعض الأعضاء فإن من دمي أنفه أوفمه لا يمكنه صب الماء عليه حتى يشرب الماء النجس أو يعلو على دماغه وفيه حرج بين فأخذنا بالاستحسان في العضو كما أخذنا به في الثوب. ثم ماء الإجانات كلها نجس، ولأن النجاسة تحولت إلى الماء (فإن قيل) جزء من الماء الثالث قد بقي في الثوب بعد العصر فكيف يحكم بطهارة الثوب (قلنا) ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفوا مع أن الماء يتداخل في أجزاء الثوب فيخرج النجاسة ثم يخرج على أثرها بالعصر فما بقي من البلة بعد العصر لم تجاوزه النجاسة، ألا ترى أنه لو كان مكان النجاسة صبغ كالزعفران وغيره يتحول إلى الماء ولا يبقى شيء من ذلك اللون في الثوب ببقاء البلة فكذلك النجاسة. قال (جنب اغتسل في ثلاثة آبار وليس على بدنه نجاسة عينية فقد أفسد ماء الآبار ولا يجزئه غسله) في قول أبي يوسف وقال محمد - رحمه الله تعالى - يخرج من البئر الثالث طاهرا وهذا لأن الحدث الحكمي معتبر بالنجاسة العينية فالآبار كالإجانات، وعند أبي يوسف - رحمه الله - النجاسة لا تزول عن البدن بالغسل في الإجانات فكذلك الحدث قال: ولو كان يزول بالغسل في الآبار لكان يخرج الجنب من البئر الأولى طاهرا كما إذا صب الماء على بدنه مرة بعد مرة، وعند محمد - رحمه الله تعالى - النجاسة العينية عن البدن تزول بالغسل في الإجانات فكذلك الجنابة قال: ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة بخلاف صب الماء على رأسه. قال (فأرة وقعت في بئر فماتت فيها ووقعت فأرة أخرى في بئر أخرى فماتت فاستقي من إحداهما عشرون دلوا وصب في الأخرى أجزأهم نزح عشرين دلوا من البئر الثانية) والأصل أن الشيء ينتظم ما هو مثله أو دونه لا ما هو فوقه فإذا كان ما في البئر الثانية مثل ما صب فيها انتظم أحدهما الآخر فتطهر بنزح عشرين دلوا من البئر الثانية ولأن هذا في معنى ما لو ماتت فأرتان في بئر، وحكم الفأرتين كحكم الفأرة الواحدة في أن البئر تطهر بنزح عشرين دلوا منها، وإن ماتت فأرة في بئر ثالثة فصب منها عشرون دلوا أيضا في هذه البئر فإنها تطهر بنزح أربعين دلوا؛ لأن المصبوب فيها أكثر فينتظم ما كان فيها فتطهر بنزح القدر المصبوب فيها وذلك أربعون دلوا ولأن هذه بمنزلة ثلاث فأرات ماتت في بئر وثلاث فأرات في ظاهر الرواية كالدجاجة إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - (قال) ما لم يكن خمس فأرات لا يكون بمنزلة الدجاجة، فإذا كان الثلاث كالدجاجة في ظاهر الرواية يطهرها نزح أربعين دلوا وإن صبوا من البئر الثالثة فيها دلوا أو دلوين فعليهم أن ينزحوا منها عشرين دلوا مع هذه الزيادة؛ لأن المصبوب فيها أكثر فينتظم ما كان فيها وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في هذه الفصول كلها أن بعد نزح القدر المصبوب ينزح منها عشرون دلوا. قال (وإن ماتت فأرة في جب فصب ماؤها في بئر فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينزح منها ما صب فيها وبعده عشرون دلوا وعند محمد - رحمه الله تعالى - ينظر إلى ماء الجب فإن كان عشرين دلوا أو أكثر ينزح ذلك القدر وإن كان دون عشرين دلوا ينزح منها عشرون دلوا؛ لأن الحاصل في البئر نجاسة الفأرة). قال (وإن ماتت فأرة في سمن فإن كان جامدا يرمى بها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا لم يؤكل منه شيء) لحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا ما بقي وإن كان ذائبا فأريقوه» ولأن في الجامد النجاسة إنما جاوزت موضعا واحدا فإذا قور ذلك كان الباقي طاهرا، وفي الذائب النجاسة جاوزت الكل فصار الكل نجسا. وحد الجمود والذوب إذا كان بحال لو قور ذلك الموضع لا يستوي من ساعته فهو جامد وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب، ثم الذائب لا بأس بالانتفاع به سوى الأكل من حيث الاستصباح ودبغ الجلد به وكذلك يجوز بيعه مع بيان عيبه عندنا فإذا باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز شيء من ذلك؛ لأنه بصفة النجاسة صار كالخمر فإن عينه نجس فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجامد أمر بإلقاء ما حول الفأرة وفي الذائب أمر بإراقة الكل فدل أنه لا يجوز الانتفاع به وعلماؤنا احتجوا بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال: يستصبح به ويدبغ به الجلود وفي حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فإن كان مائعا فانتفعوا به» ولأن نجاسته لا لعينه بل لمجاورة النجاسة إياه فكان بمنزلة الثوب النجس بخلاف الخمر فإن عينها نجس، وتأويل حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بيان حرمة الأكل فمعظم وجوه الانتفاع بالسمن هو الأكل وإذا دبغ به الجلد ثم غسل بالماء طهر به الجلد وما تشرب فيه عفو؛ لأن عين الدهن يزول بالغسل إنما بقي لينه وذلك غير معتبر. قال (وإن ماتت فأرة في جب فيه خل فأدخل رجل يده فيه ثم أدخلها قبل أن يغسلها في عشر خوابي خل أو ماء فقد أفسدهن كلهن) فإن كان في الخوابي ماء فهذا الجواب قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة بناء على غسل العضو المتنجس في الإجانات كما بينا إلا أن يكون مراده أدخلها في الخابية الأولى إلى الإبط حتى تتنجس كلها ثم أدخلها في الخابية الثانية إلى الرسغ وكذلك في كل خابية زاد قليلا فحينئذ الكل نجس كما قالا، فإن كان في الخوابي خل فالجواب قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة وهو بناء على أن إزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوى الماء لا يجوز عند محمد وزفر رحمهما الله تعالى وكذا الشافعي - رحمه الله تعالى - الثوب والبدن فيه سواء، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يجوز في الثوب والبدن جميعا وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وفي الرواية الأخرى فصل بين الثوب والبدن لا تزول النجاسة عنه إلا بالماء وفي الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر فأما ما لا ينعصر كالدهن والسمن لا تجوز إزالة النجاسة به. حجة محمد - رحمه الله تعالى - قوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] فقد خص الماء بكونه مطهرا واعتبر إزالة النجاسة بإزالة الحدث؛ لأن كل واحد منهما طهارة وهي شرط الصلاة فإذا كان أحدهما لا يحصل إلا بالماء فكذلك الآخر ولا عبرة بزوال العين، فكما تزول بالأشياء الطاهرة تزول بالأشياء النجسة كبول ما يؤكل لحمه ولم يعتبر ذلك، فهذا مثله وحجة أبي حنيفة - رحمه الله - أن الثوب قبل إصابة النجاسة كان طاهرا وبعد الإصابة الواجب إزالة عين النجاسة حتى لو قطعه بالمقراض بقي الثوب طاهرا وإزالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات وربما يكون تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء فإذا زالت به عين النجاسة يبقى كما كان بخلاف ما لا ينعصر فإنه يتشرب في الثوب فتزداد به النجاسة ولا تزول. وفي بول ما يؤكل لحمه فقد قال بعض مشايخنا - رحمهم الله: إن النجاسة الأولى تزول به لكن تبقى نجاسة البول حتى يكون التقدير فيه بالكثير الفاحش والأصح أن التطهير بالنجس لا يكون لما بين الوصفين من التضاد فأما الطهارة عن الحدث فطهارة حكمية فيها معنى العبادة فلا تجوز إلا بما تعبدنا به وإنما تعبدنا بالماء؛ لأنه أهون موجود لا يلحق الناس حرج في إفساده بالاستعمال بخلاف سائر المائعات فإنها أموال يلحق الناس حرج في فسادها بالاستعمال. وأبو يوسف - رحمه الله - لهذا المعنى فرق بين النجاسة على البدن وعلى الثوب فقال: ما كان على البدن فهو نظير الحدث الحكمي؛ لأن في تطهير البدن معنى العبادة بخلاف ما لو كان على الثوب قال فإن صب خابية منها في بئر ماء فعليهم أن ينزحوا الأكثر من عشرين دلوا ومن مقدار الخابية؛ لأن الحاصل فيها نجاسة فأرة لا غير وقد مر. قال (ولا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ما لم يعلم أن فيها قذرا) لأن الأصل في الثوب الطهارة وخبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه فثوبه كثوب المسلم وعامة من ينسج الثياب في ديارنا المجوس ولم ينقل عن أحد التحرز عن لبسها، وكفى بالإجماع حجة، إلا الإزار والسراويل فإنه يكره الصلاة فيهما قبل الغسل وإن صلى جاز، أما الجواز فلأنه على يقين من الطهارة وفي شك من النجاسة وأما الكراهة فلأنه يلي موضع الحدث وهم لا يحسنون الاستنجاء ويعرقون فيهما لا محالة، والظاهر أن إزارهم لا ينفك عن نجاسة فتكره الصلاة فيه وهو نظير كراهة سؤر الدجاجة المخلاة، وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشرب في أواني المجوس فقال إن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم اشربوا فيها» وإنما أمر به؛ لأن ذبائحهم كالميتة وأوانيهم قلما تخلو عن دسومة فيها قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وكذلك الجواب في ثياب بعض الفسقة من المسلمين فإن الظاهر أنهم لا يتوقون إصابة الخمر لثيابهم في حالة الشرب. وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنهم يستعملون فيه عند النسج البول ويزعمون أنه يزيد في بريقه ثم لا يغسلونه؛ لأن ذلك يفسده فإن صح هذا لا يشكل أنه لا تجوز الصلاة فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب المسح على الخفين] (اعلم) أن المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - قال «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر وكنت أصب الماء عليه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت ذيله ومسح على خفيه فقلت نسيت غسل القدمين فقال لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي». ومن ذلك حديث «جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله تعالى عنه - قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه فقيل له أكان ذلك بعد نزول المائدة فقال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وقال إبراهيم: - رحمه الله تعالى - وكان يعجبهم حديث جرير - رضي الله عنه - لأنه أسلم بعد نزول المائدة وإنما قال: هذا لما روي عن ابن عباس. - رضي الله تعالى عنهما - قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول المائدة والله ما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول المائدة ولأن أمسح على ظهر عنز في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين وقد صح رجوعه عنه على ما قال عطاء بن أبي رباح - رضي الله تعالى عنه - لم يمت ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - حتى اتبع أصحابه في المسح على الخفين. والذي روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين فقد صح رجوعها عنه على ما روى «شريح بن هانئ قال سألت عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن المسح على الخفين فقالت لا أدري سلوا عليا - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا عليا - رضي الله تعالى عنه - فقال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين». وفي رواية سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها فبلغ ذلك عائشة - رضي الله تعالى عنها - فقالت هو أعلم». ولكثرة الأخبار فيه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. وقال أبو يوسف - رحمه الله: خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وقال الكرخي - رحمه الله تعالى: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي وردت فيه في حيز التواتر. وهو مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها لحديث علي - رضي الله تعالى عنه - وحديث خزيمة بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» وعن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال خرجت إلى العراق فرأيت سعدا يمسح على الخفين فقلت ما هذا فقال إذا رجعت إلى أبيك فسله فسألت أبي فقال عمك أفقه منك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين وسمعته يقول المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» ولأن المسح رخصة لدفع المشقة وذلك مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة؛ لأنه يلبس خفيه حين يصبح ويخرج فيشق عليه النزع قبل أن يعود إلى بيته ليلا، والمسافر يلحقه الحرج بالنزع في كل مرحلة فقدر في حقه بثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر إذ لا نهاية لأكثره. وكان الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - يقول المسح مؤبد للمسافر لحديث «عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين يوما؟ فقال: نعم. فقلت: يومين؟ فقال: نعم حتى انتهيت إلى سبعة أيام فقال: إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك» وتأويله أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بيان أن المسح مؤبد غير منسوخ وأن ينزع في هذه المدة والأخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول: لا يمسح المقيم أصلا ويمسح المسافر ما بدا له لحديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله تعالى عنه - قال: وفدت على عمر - رضي الله تعالى عنه - من الشام فقال: متى عهدك بالخف؟ فقلت منذ أسبوع. قال: أصبت. وتأويله أن المراد بيان أول اللبس وخروجه مسافرا لا أنه لم ينزع بين ذلك. ثم ابتداء المدة من وقت الحدث؛ لأن سبب وجوب الطهارة الحدث واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما هو موجب لبس الخف إنما يظهر عند الحدث فلهذا كان ابتداء المدة منه، ولأنه لا يمكن ابتداء المدة من وقت اللبس فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر عليه يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف بالاتفاق ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث. قال (وإنما يجوز المسح من كل حدث موجب للوضوء دون الاغتسال) لحديث «صفوان بن عسال المرادي - رضي الله عنه - قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم» ولأن الجنابة ألزمته غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى ذلك والرجل معتبرة بالرأس فمتى كان الفرض في الرأس المسح كان في الرجل في حق لابس الخف كذلك وفي الجنابة الفرض في الرأس الغسل فكذلك في الرجل عليه نزع الخف وغسل القدمين. قال (وإنما يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة كاملة) لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حين مسح على خفيه إني أدخلتهما وهما طاهرتان» ولأن موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف وإنما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة. قال (فإن غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أحدث قبل إكمال الطهارة لم يجز له أن يمسح عليهما) ؛ لأن أول الحدث بعد اللبس ما طرأ على طهارة كاملة فهو وما لبس قبل غسل الرجل سواء، وإن أكمل وضوءه قبل الحدث جاز له أن يمسح عندنا ولم يجز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - بناء على أن الترتيب في الوضوء ليس بركن عندنا فأول الحدث بعد لبس الخف طرأ على طهارة كاملة قال (ولو توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم أحدث جاز له عندنا أن يمسح) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - إن لم ينزع الخف الأول فلا يجوز له أن يمسح وإن نزعه ثم لبسه جاز له المسح؛ لأن الشرط أن يكون لبسه بعد إكمال الطهارة وهذا اشتغال بما لا يفيد ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه فيه غسل وهو ليس من الحكمة فلا يجوز له اشتراطه. قال (ومسح الخف مرة واحدة) وقال عطاء - رضي الله تعالى عنه - ثلاثا كالغسل. (ولنا) حديث «المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنهما - قال كأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطوطا بالأصابع» وإنما لم تبق الخطوط إذا لم يمسحه إلا مرة واحدة ولأن في كثرة إصابة البلة إفساد الخف وفيه حرج فيكتفى فيه بالمرة الواحدة، ويبدأ من قبل الأصابع حتى ينتهي إلى أسفل الساق اعتبارا بالغسل فالبداءة فيه من الأصابع؛ لأن الله تعالى جعل الكعبين غاية. قال (وإن مسح خفيه بإصبع أو إصبعين لم يجزه حتى يمسح بثلاثة أصابع) وعلى قول زفر - رضي الله تعالى عنه - يجزئه والكلام فيه مثل الكلام في المسح بالرأس وقد مر. قال (والخرق اليسير في الخف لا يمنع من المسح عليه وفي القياس يمنع) وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى -؛ لأن القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله اعتبارا للبعض بالكل وإذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل؛ لأنه لا يتجزأ ووجه الاستحسان أن الخف قلما يخلو عن قليل خرق فإنه وإن كان جديدا فآثار الزرور والأشافي خرق فيه ولهذا يدخله التراب فجعلنا القليل عفوا لهذا فأما إذا كان الخرق كبيرا لا يجوز المسح عليه وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - إذا كان بحيث يمكن المشي فيه سفرا يجوز المسح عليه؛ لأن الأصل في هذه الرخصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعامتهم كانوا محتاجين لا يجدون إلا الخلق من الخفاف وقد جوز لهم المسح، ولكنا نقول الخرق اليسير إنما جعل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس. والفرق بين القليل والكثير ثلاث أصابع فإن كان يبدو منه ثلاث أصابع لم يجز له أن يمسح عليه؛ لأن الأكثر معتبر بالكمال وفي رواية الزيادات عن محمد - رحمه الله تعالى - ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل؛ لأن الممسوح عليه الرجل وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال ثلاث أصابع من أصابع اليد؛ لأن الممسوح به اليد وسواء كان الخرق في ظاهر الخف أو باطنه أو من ناحية العقب ولكن هذا إذا كان يبدو منه مقدار ثلاث أصابع، فإن كان صلبا لا يبدو منه شيء يجوز المسح عليه وإن كان يبدو في حالة المشي دون حال وضع القدم على الأرض لم يجزه المسح؛ لأن الخف يلبس للمشي. واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى فيما إذا كان يبدو ثلاثة أصابع من الأنامل والأصح أنه لا يجوز المسح عليه وتجمع الخروق في خف واحد ولا تجمع في خفين؛ لأن أحد الخفين منفصل عن الآخر. قال (وإن مسح باطن الخف دون ظاهره لم يجزه) فإن موضع المسح ظهر القدم لما روينا من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - المسح على ظاهر الخف فرض، وعلى باطنه سنة، فالأولى عنده أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخف ويده اليسرى على باطنه فيمسح بهما على كل رجل وعندنا المسح على ظاهر الخف فقط لحديث «علي - رضي الله تعالى عنه - قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما» ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فيصيب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج والمسح مشروع لدفع الحرج. [المسح على العمامة والقلنسوة] قال (ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة) ومن العلماء من جوزه لحديث «بلال - رضي الله تعالى عنه - قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته» وجاء في الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فأمرهم بأن يمسحوا على المشاوذ والتساخين» فالمشاوذ العمائم والتساخين الخفاف. (ولنا) حديث «جابر قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته» وكأن بلالا - رضي الله عنه - كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة حين لم يضعها عن رأسه وتأويل الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص به تلك السرية لعذرهم فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يخص بعض أصحابه بأشياء كما خص عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - بلبس الحرير وخزيمة - رضي الله تعالى عنه - بشهادته وحده. ثم المسح إنما يكون بدلا عن الغسل لا عن المسح، والرأس ممسوح، فكيف يكون المسح على العمامة بدلا عنه بخلاف الرجل ولأنه لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة والمسح على الرأس. قال (وكذلك المرأة لا تمسح على خمارها) لحديث «عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فإن مسحت على خمارها فنفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع أجزأها حتى قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا كان الخمار جديدا يجوز، وإن لم يكن جديدا لا يجوز؛ لأن ثقوب الجديد لم تنسد بالاستعمال فتنفذ البلة منها إلى الرأس. 
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |